تعد نظريات التلقي أو الاستقبال Reception من الاتجاهات المعاصرة والرائجة في عالم النقد الغربي. فعقدت مؤتمرات دولية وأنشئت مراكز بحثية وصدرت دوريات متخصصة في هذا المجال. وصدرت كتب وموسوعات نضرب لها مثلاً بـ
Lorna Hardwick & Christopher Stray, eds. (2008): A companion to Classical Receptions
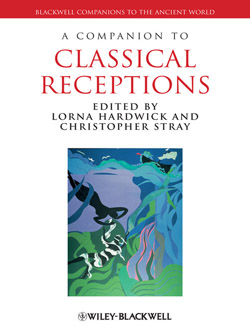 وكان لي الحظ بأن أسهمت في كتابة أحد الفصول في هذه الموسوعة عن الاستقبال العربي للكلاسيكيات. ويسعدني أيضاً أن هذه الموسوعة قد ترجمت إلى اللغة العربية وعلى وشك الصدور من المركز القومي للترجمة وهو نفسه الذي أصدر الكتاب الذي نقدم عرضاً له في هذه الصفحات.
وكان لي الحظ بأن أسهمت في كتابة أحد الفصول في هذه الموسوعة عن الاستقبال العربي للكلاسيكيات. ويسعدني أيضاً أن هذه الموسوعة قد ترجمت إلى اللغة العربية وعلى وشك الصدور من المركز القومي للترجمة وهو نفسه الذي أصدر الكتاب الذي نقدم عرضاً له في هذه الصفحات.
وأشرفت هاردويك على تأسيس دورية متخصصة بعنوان Classical Receptions Journal صدر منها حتى الآن أربعة أعداد والناشر طبعاً أكسفورد. ولم يقفوا عند هذا الحد بل أشرفت هذه الباحثة على إصدار مجلة أخرى بعنوان New Voices in Classical Receptions تهتم بنشر بحوث الشباب في هذا المجال وهاتان الدوريتان تصدران في طبعة ورقية ولهما طبعة إليكترونية.
ولذا أسعدني كثيراً الاطلاع على كتاب فاتحة الطايب الذي أعتبره فاتحة خير في الدرس العربي النقدي، الذي يساير المناهج العصرية ويتزود بتقنياتها ويفي بمتطلباتها. على أن دراسات الاستقبال ليست سهلة ولا بسيطة، بل هي عملية شاقة للغاية. هي بالقطع تدخل في الأدب المقارن من أوسع أبوابه وتستلزم إجادة أكثر من لغة.
والكتاب الذي بين أيدينا يتابع ترجمات الروايات المغربية إلى الفرنسية، وكيف استقبلتها الثقافة الفرنسية. ولكنها لكي تؤسس لهذه الدراسة الجادة حاولت الإجابة على السؤال البديهي حول استقبال البيئة الأصلية أي المغربية لهذه الروايات.
وفي الباب الأول تبدأ الباحثة في دراسة استقبال الأعمال المترجمة في بيئتها الأصلية أي في المغرب. وتبدأ برواية دفنا الماضي 1966 لعبد الكريم غلاب ممثلةً للرواية المغربية التقليدية. حيث إن إدوار الخراط في كتابه الحساسية الجديدة أدرج عبد الكريم غلاب ضمن من أدرجهم في قائمة “الحساسية القديمة” أي الروائيين التقليديين والتي استقبلت في المشرق العربي بحفاوة ظاهرة.
وتعتمد الباحثة في استقصاء ردود الأفعال على هذه الرواية من كتاب جماعي بعنوان دراسات تحليلية نقدية لرواية دفنا الماضي الصادر عن مطبعة الرسالة 1980. ويضم آراء كثيرة تتراوح بين عبد الله كنون الذي استفزته المركزية العربية المشرقية فيكتب عن هذه الرواية بعاطفة تتقد حماساً في مواجهة الغبن الذي تواجهه الرواية المغربية في المشرق.
ثم يبدأ النقد الأكاديمي ممثلاً في أحمد اليبوري الذي تقدم برسالة دبلوم الدراسات العليا الرباط 1967 بعنوان فن القصة في المغرب (1914 – 1966) ثم نشر الجزء الأول منها في كتاب بعنوان تطور القصة في المغرب (مرحلة التأسيس) عام 2005. ولقد أشاد هذا الناقد المدقق بالمحتوى الوطني للرواية، ولكنه تحفظ على الشكل التقني أي تقنيات السرد مقارنة بثلاثية نجيب محفوظ.
فتتصدى له الباحثة فاتحة الطايب وتعترض على فكرة هذه الموازنة من أساسها، حيث كان أحمد اليبوري قد انتقد رواية دفنا الماضي في ضوء النموذج المشرقي. بيد إنه لمن العسير على أي ناقد مغربي أن يتخلص من النموذج المشرقي.
يهاجم محمد برادة الأدب المغربي بعامة على أساس أنه أدب هجين، وذلك في مقال له بعنوان “الرواية المغربية” ضمن كتابدراسات تحليلية نقدية لـ دفنا الماضي المشار إليه سابقاً. ليعتبر ، في المقدمة التي كتبها لترجمة كتاب الرواية المغاربية لعبد الكبير الخطيبي 1971، أن في الطفولة لعبد المجيد بنجلون هي بحق بداية النضج في الكتابة السردية في المغرب. أما دفنا الماضي برأي برادة فهي أول إبداع مغربي ينتمي إلى ما أسماه مرحلة الحنين الروائي أي فترة المخاض.
أما قراءة إدريس الناقوري لـ دفنا الماضي فجاءت من خلفية إيديولوجية بحتة. وقدم هذا الناقد ما يمكن تسميته “محاكمة إيديولوجية” أكثر منها تقويماً نقدياً وفنياً. جاء ذلك في كتابه المصطلح المشترك. دراسات في الأدب المغربي المعاصر (دار النشر المغربية 1977). ورأى الناقوري أن دفنا الماضي هي رواية أملاها تطور البورجوازية الوطنية، فهي رواية واقعية من النوع الرديء، زيفت الواقع مكتفية بتكريس نضال بعض شرائح البورجوازية على حساب الكفاح الوطني الأشمل.
الناقوري إذن يمثل التلقي الإيديولوجي المحض، وإن كان قد فاه ببعض الأحكام النقدية مثل “قصور الرؤية الفنية، واهتزاز الشخوص وتفاهتها” وكنا نتمنى التعمق في هذه الآراء النقدية. ولكن الناقوري انشغل برؤاه الإيديولوجية التي افتقدها في دفنا الماضي. ومثل هذا النقد الإيديولوجي معيب لأنه يفرض على النص رؤى الناقد التي تعميه عن تسليط الضوء على الجوانب الموضوعية والفنية.
أما دراسة حميد الحميداني: الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي دراسة بنيوية تكوينية (مطبعة النجاح الجديدة، 1985)، فقد انتهت إلى أن غاية مؤلف دفنا الماضي التمحيص في التراث البورجوازي، فهي رواية تعد امتداداً للإنتاج الاستعماري الإثنوغرافي ذي النزعة الغرائبية Grotesque، فهي تعاني من الخواء الفني المهول ويتمحور اهتمامها في التحليل الاجتماعي.
تلك كانت الآراء المنتقدة لرواية دفنا الماضي أما الآراء المستحسنة لهذه الرواية والتي تسلط الضوء على فضائلها فهي أيضاً كثيرة.
يقول حسن المنيعي، في دراسته قراءة في الرواية، (سيدني للطباعة والنشر 1996)، إن دفنا الماضي استطاعت أن تكون نداً لأستاذها المشرقي، فشهرتها في العالم العربي وترجمتها إلى اللغة الفرنسية كانتا نتيجة لاستيفائها كل الأسس الفنية والجمالية. ويقول إن غلاب قد أسهم في خلق فضيلة الرواية المغربية كما أسهم نجيب محفوظ في خلق فضيلة الرواية المصرية، وكما أسهم الواقعيون الغربيون في خلق فضيلة الرواية اللاتينية. استند المنيعي في دراسته إلى نظرية التلقي المطعمة بإنجازات علم السرد، ولكنه بالغ في تقريظ هذه الرواية التي اعتبرها نموذجاً يحتذى.
وأصبح لدينا الآن ما يشبه الإجماع بين نقاد المغرب على أن غلاب هو أحد الرواد القلائل الذين أرسوا دعائم الكتابة الروائية العربية بالمغرب، وأن رواية دفنا الماضي هي أول رواية مغربية بالمعنى الأوروبي للكلمة Novel.
أما رواية الغربة لعبد الله العروي فقد صدرت عام 1971 وإن كان تأليفها يعود إلى الخمسينيات. وهي رواية غير تقليدية تجادل وتجاوز الواقع الروائي المغربي إلى آفاق السرد الجديد في العالم الغربي. فهو يستعيض عن النموذج المغربي/الغربي التقليدي بنموذج غربي حديث. ولقد نجح هذا الشكل الروائي الجديد في فرض نفسه على النقاد حتى إن ناقداً مثل إدريس الناقوري اضطر إلى أن يخصص حيزاً كبيراً للعناصر الجمالية في تحليله لرواية الغربة وهو الذي كان قد حصر اهتمامه في التحليل المادي والإيديولوجي لرواية دفنا الماضي. ولكن إغفال الناقوري للمفاهيم النقدية البنيوية فوت عليه إدراك أهمية التوازنات التي يقوم عليها بناء الغربة. على أنه يعتبرها عملاً فنياً فاتحاً يتمتع بأسبقية إبداعية. كما يحفل الناقوري بتفكيك الحبكة الروائية فيالغربة وفي النهاية وقع الناقوري مرة أخرى في فخ المحاكمة الإيديولوجية.
العروي نفسه بوصفه مفكراً يضع إصبعه على الداء العضال في المجتمع المغربي، وهو داء الإزدواجية، ازدواجية العقل والذوق والإحساس. فالمغربي اعتاد الاغتراف من ثقافتين متنافرتين أي الثقافة المغربية والفرنسية. وهذا ما تنعكس آثاره على الإبداع والتلقي، ولكنها ــ فيما نعتقد ــ ظاهرة عامة في المجتمعات العربية كافة وإن اختلفت الدرجات والخلفيات.
كشفت الغربة عن بعض عيوب التلقي النقدي في المغرب، ولاسيما المد الإيديولوجي في مغرب السبعينيات. فقصور البنيوية التكوينية التي يتمسك بها الحميداني ويهمل ما عداها في حكمه على الغربة، جعله ينسى أو يتناسى أن الغربة بوصفها رواية جديدة تستلزم جهازاً جديداً للتلقي، فاتهم الرواية بأنها عمل غامض يولد النفور، لأن تركيبها غاية في الصعوبة. في الفن الروائي الجديد لا فرق بين لغة الرواية ولغة الشعر، وهذه هي لغة الغربة التي لم يتفهمها النقاد التقليديون.
بأشواط بعيدة فاقت ردود الأفعال على الخبز الحافي لمحمد شكري أية رواية مغربية أخرى، من حيث الضراوة والعنف في استقبالها على أساس أنها سيرة ذاتية مفعمة بالجنس والتشخيص المؤلم للواقع المغربي المر. فظلت هذه الرواية تكافح عشر سنوات من أجل النشر والظهور بعد تأليفها (1972 ــ 1982) وصدرت الترجمة الإنجليزية سنة 1972 والفرنسية سنة 1980. وعندما صدرت عن دار النجاح بالمغرب سنة 1982 طالب الناس بحرق المؤلف وصودرت الرواية ولم تظهر ثانية إلا عام 2000 فأشعل ذلك كله تلهف الجماهير المغربية عليها فطبعت في أكثر من عشرين ألف نسخة، فصارت هذه الرواية هي الأشهر في تاريخ الرواية المغربية، وهي رواية طليعية بكل معاني الكلمة.
التقط عبد القادر الشاوي الترجمة الفرنسية للخبز الحافي التي ظهرت قبل النص العربي الأصلي، فكتب عنها مقالاً نشره ضمن كتابه سلطة الواقعية المنشور سنة 1981، وكان التركيز في دراسته على المصارحة والمكاشفة في تناول السيرة الذاتية، وهو أمر غير مسبوق في العالم العربي.
ومما يلفت النظر أن الحميداني يرى في الخبز الحافي دعوة للتحرر الجنسي في تأثر بالثورة الجنسية الغربية. فبعض المثقفين المغربيين تحفظوا على مثل هذا الأدب المكشوف وغير المحتشم، فالسفور الأدبي مازال مرفوضاً في العالم العربي بما يوازي انتشار الحجاب والنقاب عبر كافة الأقطار.
تتميز الخبز الحافي عن سائر الروايات المغربية في رأي محمد برادة بأنها تحقق متعة القراءة من خلال متعة الكتابة. فهي كتابة سيرة ذاتية بتلقائية متحررة مع حدة في التشخيص. كشفت الخبز الحافي عن أصالة في الكتابة وتفرد في الإنتاج داخل النسق العربي برمته.
قابل النقاد رواية بيضة الديك باتهام للمؤلف محمد زفزاف بأنه يكرر نفسه، لأن هذه الرواية هي الروايات السابقة له نفسها بأسماء جديدة فالموضوع واحد هو الدعارة والبطالة والشذوذ والكبت. استهدف زفزاف كتابة رواية أصيلة، والأصالة عنده تعني توظيف الأساليب السردية العالمية الحداثية. فهل نجحت بيضة الديك في تحقيق مسعاه؟ وفي حين يرى محمد عز الدين التازي أن تقسيم الرواية إلى أبواب مثل تقسيم الكتب العربية التراثية هو تقسيم شكلي لا مغزى عميق له. يرى عبد العالي بوطيب أن هذا التبويب وتناص عناوين الأبواب مع عناوين وموضوعات تراثية ينم عن نية لتأصيل الخطاب الروائي العربي. ووافق الناقد بشير القمري على هذا الرأي وأشاد بهذا التوليف بين الشكل التراثي وبنية الحكاية الشعبية. وفي هذه الرواية نجد المؤلف يوظف الآيات القرآنية مع الأمثال والحواديت الشعبية ويخلط الفصيح بالدارج ويتبنى تقنية تعدد الأصوات وتعدد أدوار الحكائيين.
ومن حسن حظ رواية لعبة النسيان لمحمد برادة خفوت سطوة الإيديولوجيا في النقد الأدبي المغربي حين صدورها عام 1987. وقد استقبلها النقاد بحفاوة بالغة وفي مقدمتهم أحمد اليبوري الذي ركز على الجانب السيرذاتي. سلط حسن المنيعي الضوء على عنصر التمرد على الكتابة الروائية نفسها داخل الرواية واستخدام التقنيات السردية على أنها لعبة. وتركز قراءة بشير القمري على اللاوعي في النص، وخاصية التعدد اللغوي وتعدد الأصوات وتعدد أشكال الوعي. “لعبة النسيان” هي في النهاية لعبة كتابة، حتى إن المؤلف يعرض مسودة الكتابة ويدعو القارئ للمشاركة في الصياغة النهائية للرواية.
ولا تكرر رواية الضوء الهارب لمحمد برادة تجربة لعبة النسيان ولكنها تشاركها في إثارة قضايا السرد نفسها تقريباً.
تقول فاتحة الطايب إن المغرب لم يعرف نظيراً لجرجي زيدان ولا مثيلاً لنجيب محفوظ من حيث تأسيس مدرسة للرواية التاريخية ولذا جاءت رواية وزير غرناطة لعبد الهادي بوطالب (1950) كأنها شبه رواية وليست رواية بالمعنى الكامل. ولم تظهر الرواية التاريخية إلا في سبعينيات القرن العشرين في محاولة لمحمد بن أحمد أشماعو أي المعركة الكبرى. وكان علينا الانتظار حتى صدور الرواية المغربية الأولى التي اكتملت فيها سمات الرواية التاريخية، إنها مجنون الحكم لبنسالم حميش (1990).
ويحمل غلاف الطبعة الثانية شهادتي يوسف الشاروني وإدوار الخراط علاوة على شهادة مترجمها إلى الإسبانية فيديريكو آربوس ومقدمها إلى القارئ الإسباني خوان غويتصولو.
وتؤاخذ فاتحة الطايب الاستقبال المشرقي المحتفي بالرواية على أنه نقد انطباعي يشيد بتشخيص الحاكم بأمر الله وهو شخصية شديدة الثراء عظيمة التجارب. وأين فضائل هذه الرواية وعثراتها؟ لا شيء. فالمتلقي المشرقي لايزال جاهلاً بتطورات الرواية المغربية ولا يعرف شيئاً عن الخريطة الإبداعية وهذا واضح تماماً فيما ذكره مصطفى عبد الغني في مؤتمر القاهرة للإبداع الروائي (فبراير 1998). فلازالت النظرة التقليدية من المركز للهوامش كما هي لم تتغير ولم تتبدل ورغم ما قاله إدوار الخراط من أن “الهوامش” أصبحت مراكز جديدة! فهذا إنصاف من مشرقي عتيد ولكنه لا يمثل اتجاهاً قوياً في عالم النقد المشرقي.
ومن حسن الحظ أن مجنون الحكم أصبحت مادة دسمة وشهية لأطروحات الدكتوراه في المغرب، مما يسد النقص الملحوظ في التلقي البسيط والساذج في الصحافة الأدبية ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
وغني عن التبيان أن الزيني بركات لجمال الغيطاني كانت المرجعية الموحدة للنقاد في تناولهم مجنون الحكم لبنسالم حميش. تقوم رواية مجنون الحكم على حوارية الأصوات المتعددة وحوارية الخطابات والأشكال والنصوص. وهي مقسمة بشكل تراثي إلى أبواب مثل رواية بيضة الديك سالفة الذكر. المهم أن تقنيات السرد المتقنة في هذه الرواية لا تتعارض مع راهنيتها في الخطاب الذي يلمس شغاف قلب القارئ فيندمج مع الحكاية ويرى نفسه فيها… ومن هنا انجذاب القراء.
ويلاحظ أن تطور الإبداع ونضجه يسهم هو نفسه في إنضاج التلقي، فإذا نضج التلقي وجدنا المبدع ينتقل إلى مرحلة أكثر تطورا وتعقيداً. التلقي برأينا هو وقود الإبداع، والإبداع هو نفسه ــ ضمن عوامل أخرى كثيرة ــ يسهم في عملية نضج التلقي. الإبداع والتلقي هما وجهان لعملة واحدة هي البيئة الثقافية ومستواها ونوعية الحياة فيها. الإبداع المتفوق ليس وليد عبقرية المؤلف فقط، بل هو نتاج حسن التلقي ورهافة حس المتلقي ومن هنا كانت الأعمال الإبداعية العربية المترجمة هي رسولنا والمتحدث باسمنا إلى الآخر. وهذه إحدى القضايا المهمة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
ومن النتائج الأولية التي تصل إليها فاتحة الطايب في هذه الدراسة المعمقة هي ضآلة اهتمام المترجم والناشر الفرنسيين بالإبداع المغربي في مقابل اهتمام شديد من قبل المبدعين المغاربة على الوصول للمتلقي الفرنسي. وجل المترجمين هم أصلاً مغاربة مع تعاون بعض الفرنسيين في بعض الحالات وينطبق ذلك حتى على أشهر المبدعين المغاربة ممن حققوا شهرة عالمية مثل محمد شكري، وهو أمر يشمل كذلك معظم الآداب العربية. وينبغي الإشارة هنا إلى جهود المترجمتين الجزائريتين أحلام مستغانمي وزينب لواج للتعريف بالأدب الجزائري المكتوب باللغة العربية في فرنسا والدول الفرانكوفونية.
وهذا معناه أن تأثير نوبل محفوظ لم يكن بهذا الحجم المتوقع وأن الروائيين المصريين هم الذين فازوا بنصيب الأسد من الرواج الذي نجم عن الجائزة. بل إن مشكلة المركز والهوامش أو الأطراف انتقلت أيضاً إلى المترجمين الفرنسيين، الذين اعتبروا ظهور فن السرد المغربي صدى لأستاذه المصري ولاسيما في الستينيات.
ثم بدأ الحال يتغير رويداً رويداً منذ السبعينيات، وبدأ بالعدد الخاص الذي أصدرته مجلة أوروبا Europe (1979) حيث اتسعت التشكيلة المغربية المختارة من القصص، وبعدها بدأ المترجمون ودور النشر الفرنسية توجه عناية خاصة إلى الأدب المغربي الروائي.
وبدأ مترجمون كبار من حجم ريشار جاكمون R.Jacquemond ليترجم رواية محمد برادة مثل صيف لن يتكرر(2001).
وتعيب فاتحة الطايب على بعض الكتاب العرب الهرولة وراء الترجمة طمعاً في العالمية وهذا ما يؤثر على إبداعهم، فهم أثناء التأليف يعملون ألف حساب للمترجم الفرنسي والمفروض أن الخطاب يتوجه بالأساس للجمهور العربي لا المترجم الغربي. وهنا تحضرني تجربة شخصية في ترجمة بداية ونهاية لنجيب محفوظ إلى اليونانية الحديثة والتي أعيد طبعها ونشرها أكثر من إحدى عشر مرة في أثينا منذ صدورها عام 1991. وهو أول عمل أدبي يترجم من العربية إلى اليونانية مباشرة وليس بوساطة أية لغة أوروبية حديثة. وعندما كنت أقدمها للجمهور هناك قلت إن نجيب محفوظ لا يحب أن يترك القاهرة بتاتاً في حياته وتأليفه، ولم يحدث نقيض ذلك إلا في ظروف استثنائية. هو شجرة باسقة جذورها ضاربة للأعماق في تربة النيل ولكن أغصانها وأوراقها تظلل العالم بأكمله. إنه المؤلف الذي ظل يحفر في حواري القاهرة وأزقتها حتى وجد نفسه في ستوكهولم. وأردت بذلك أن أوجز القول عن العلاقة بين المحلية الصادقة والعالمية.
وبالفعل حاورت بعض القراء اليونان فقالوا لي إنهم قرأوا الرواية فشعروا أنها تتحدث عن حواري أثينا! المهم إذن أن يصل المبدع في رؤيته إلى جوهر الإنسان ــ المواطن له فسيكتشف في حالة نجاحه أنه وصل برؤيته إلى جوهر الإنسان في كل مكان. أما المبدع الذي يضع نصب عينه من البداية المترجم الأجنبي والقارئ الأجنبي فلقد خسر جوهر الإنسان المواطن والأجنبي معاً في آن، ولن يصل إلى شيء.
وبوصفي مشرقياً أرى أن ترجمة الأعمال الأدبية الجزائرية والمغربية والتونسية (واللبنانية والسورية) إلى الفرنسية تطور طبيعي لمرحلة الاحتلال والتحرر. فهي بمثابة ردة فعل ثقافية يتحمس لها أهل المستعمرات السابقة بهدف اطلاع المستعمر السابق على ما فاته من معرفة الحضارة والشخصية الحقيقية لهذه الأوطان. فإذا كان للاحتلال شيء من الخير ــ وإن كان يقيني أنه لا خير فيه بالمرة ــ فهو اختلاط الثقافات واللغات.
الكثيرون من المغاربة في الحياة اليومية ووسائل الإعلام يخلطون ما بين العربية والفرنسية. الوجود الفرنسي في دول المغرب كبير، أما الوجود المغاربي في فرنسا فهو أيضاً يتصاعد والأمل أن يتزايد الوجود الثقافي المغاربي في فرنسا. ومن العبارات التي لازالت ترن في أذني منذ زيارتي الأولى للدار البيضاء هي قول موظف الاستقبال في الفندق لي في التليفون صباح كل يوم وبكل أدب وكرم “بنجور سيدي” Bonjour Sidi وبعد عودتي نشرت مقالاً في الأهرام بهذا العنوان. وبهذه المناسبة فإني أعتقد أن تأكيد الهوية القومية المغربية لا يقتضي بالضرورة اجتثاث كل ما هو فرنسي في الثقافة العامة، فهناك أشياء جميلة جداً يمكن الحفاظ عليها واستثمارها في مرحلة التحرر والاستقلال وفي مقدمتها اللغة الفرنسية. فمما يؤسفني أن البعض حارب اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية وقضى عليها في بعض الحالات. ولكن أصحاب هذا الاتجاه هم أنفسهم لم يتعمقوا كثيراً في اللغة العربية وتراثها القومي، الذي هو بالقطع شرط أساسي لتأكيد الهوية القومية. ومن الممكن والمفيد توظيف اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية لخدمة التراث القومي. اللغة الفرنسية وإجادتها تساعدان ــ على سيبل المثال ــ على المزيد من التعمق وفهم الاستشراق الفرنسي واستقباله للتراث العربي القومي. والدراسة التي بين أيدينا هي نفسها خير دليل، فلولا إتقان الفرنسية من قبل الباحثة فاتحة الطايب، لما أمكنها الإقدام على هذه الدراسة الجادة والشاقة.
غريب أن بعض ترجمات الروايات المغربية إلى الفرنسية لم تحمل توقيع المترجم على الغلاف. وربما يذكر فقط في الصفحات الداخلية، وهذه قضية خطيرة لا من حيث قوانين النشر والملكية الفكرية ــ وهو أمر حيوي ــ فحسب، بل لأن دور المترجم هو الدور المحوري في عملية تقديم أعمالنا للآخر. والتعرف على هذا المترجم وبيئته والنسق الثقافي الذي أفرزه وحجم معرفته باللغة العربية هو الخطوة الأولى نحو التعرف على قيمة الترجمة. وباختصار شديد شخصية المترجم وثقافته هي بوابة النجاح أو حفرة الفشل بالنسبة لترجمة أي نص أدبي.
بالنسبة للغة المستقبلة فإن المترجم هو القارئ الأول وصاحب التأويل الأول، فمسؤوليته بالنسبة لاستقبال النص الأصلي في لغة أخرى مسئولية أساسية وجوهرية. وهناك من يعتبرون المترجم الجيد والأمين هو المؤلف الثاني للنص، فالترجمة إبداع مترتب على إبداع سابق. فهي عملية معقدة ومركبة تضع على عاتق المترجم مسئولية غاية في التعقيد، لأنه مبدع مقيد بمعطيات النص الأصلي، فهو مبدع مقيد اليدين وليس كالمؤلف الأصلي الذي كان طليقاً بكامل الحرية إلا من قواعد الفن التي يمكنه أيضاً التمرد عليها إلى حد ما. وعلى أية حال لا نتفق مع المنادين بموت المؤلف الأصلي لصالح المترجم أو حتى المتلقي بصفة عامة.
وتتعرض فاتحة الطايب لملابسات ترجمة الروايات المغربية للفرنسية، وتكشف النقاب عن أن معظم الاختيارات تتم إما بصفة عشوائية وشخصية أو بعلاقات وتبادل مصالح بين المؤلف والمترجم والناشر. ولذلك فالنتيجة أن حركة الترجمة هذه لا تقدم الصورة المثلى للإبداع المغربي، بل وتؤشر للمبدع على الأسلوب المتبع والطرق الملتوية للحصول على ترجمة، ففي ذلك إفساد لرسالة الترجمة برمتها.
ثم تدرس فاتحة الطايب خلفيات المترجمين في نسقهم الثقافي الفرنسي وكذا خلفيات دور النشر التي تقوم على ترجمة الأدب المغربي في فرنسا وتقوم بجانب منها دور النشر المغربية. على أية حال هذه مشكلات قديمة ومازالت مستمرة، فلقد عانى منها أدباء كبار مثل توفيق الحكيم وطه حسين وغيرهما.
ولعل أهم نقطة في استقبال الترجمات هي مدى إقبال الناس أي القراء العاديين على النصوص العربية المترجمة. تقول فاتحة الطايب إن رواية الزيني بركات لجمال الغيطاني (1985) لم تحظ بإقبال القارئ الفرنسي رغم المقالات الصحفية التقريظية التي واكبت صدور الترجمة.
وفي السنوات الأولى من الألفية الثالثة وأثناء مناقشة مشكلات ترجمة الأدب العربي إلى الإيطالية وبحضور اثنتان من أكبر المترجمين الإيطاليين وأشهر من قدموا نجيب محفوظ إلى القارئ الإيطالي. قالت هاتان المترجمتان وهما سارنيللي وكاميرادافليتو إن ترجمات هذا الأديب العالمي صاحب نوبل لا تحظى بجماهيرية حقيقية في إيطاليا ولازالت حبيسة المراكز البحثية والجامعية ولم تعرف طريقها إلى الشارع الإيطالي… ومن ثم فإن السؤال المطروح على فاتحة الطايب صاحبة الدراسة الجادة التي نتحدث عنها هو: هل شقت الرواية المغربية المترجمة إلى الفرنسية طريقها إلى جماهير القراء؟ الإجابة بالقطع ليست سهلة ولا ميسورة لكن يمكن الاستدلال عليها بعدد النسخ المطبوعة ونفاذ الطبعات المنشورة أو تكدسها في المخازن… وما إلى ذلك.
وبرأي فاتحة الطايب إن اختيار العنوان الفرنسي للرواية المترجمة يلعب دوراً حيوياً في شيوع الترجمة وإقبال القارئ. وهذا هو دور المترجم أساساً ودور الناشر كذلك. فهما الوحيدان القادران على التعرف على الذوق العام في فرنسا واتجاهاته.
وبعد تناول خطاب العتبات الخارجية أي العنوان والغلاف والغلاف الخلفي وإخراج الكتاب بصفة عامة وكذا اسم دار النشر تدلف فاتحة الطايب لما تسميه خطاب العتبات الداخلية بادئة بالمقدمة والخاتمة فمن يكتبهما للقارئ الفرنسي؟ والإجابة المنطقية أنه هو من على صلة وثيقة بالقارئ الفرنسي ويعرف ذائقته وماذا يمكن أن يشده ويغريه بالقراءة. وبالطبع لابد وأن يكون كاتب المقدمة خبيراً في تقنيات السرد ومن باب أولى على دراية واسعة بالنسق الثقافي الأصلي للرواية المترجمة.
ومع الاعتراف بوجود جهود مخلصة من جانب المستقبل الأوروبي الأكاديمي لروايات المغرب، فإنهم إجمالاً لم يتخلصوا من الصورة التقليدية الموروثة والأحكام الجاهزة. ويجسد هذا الاتجاه غويتصولو في تقديمه للترجمة الإسبانية لرواية بنسالم حميشمجنون الحكم فهي مقدمة رائعة فيها الكثير من الإنصاف للإبداع المغربي، حيث نلحظ سعيه الحثيث لجذب القارئ وإشراكه في الإعجاب بالنص. لكنه أي غويتصولو لم يتخلص من الرؤية الغربية التقليدية للعربي الغارق في الملذات. فنجده يركز على حكاية العبد مسعود واللواط ويربط كل ذلك بعالم ألف ليلة وليلة وبالطبع لم يك هذا ما يهدف إليه المؤلف المغربي.
ثم تقدم الباحثة دراسة نصية تقابلية للروايات المغربية في أصلها العربي وترجمتها الفرنسية فتكشف عن الصعوبات البالغة التي تواجه المترجم ولاسيما في المعاني الاصطلاحية لدى أي شعب من الشعوب، وهو ما يصعب نقله بين لغة وأخرى، لأن كل لغة لها خصوصيتها ومعانيها الدفينة أو الإيحائية التي ربما لا نجد لها مقابلا في لغة أخرى. ومثل هذه المشكلات لا يحس بها إلا من كابد وخاض تجربة الترجمة. فهنا على سبيل المثال أتذكر نص السحب لأشهر شعراء الكوميديا الإغريق أريستوفانيس. فلا يخلو بيت فيها من فكاهة لاذعة السخرية. وعانيت الأمرين وأنا أنقل هذا النص إلى القارئ العربي محاولا أن أجد المقابل أو الأقرب لهذه الفكاهة التي تعود للقرن الخامس ق.م. في أثينا. كان الهدف أن يفهمها القارئ العربي ابن القرن العشرين والحادي والعشرين!. ففي هذا النص سخرية من اللغة الإغريقية نفسها في مسألة التذكير والتأنيث فكيف تنقل ذلك إلى اللغة العربية؟. وأذكر أنه في ترجمة بداية ونهاية لنجيب محفوظ واجهتني كلمة “المنزول” وهو شراب يباع في الدار وأخذت أسأل الناس من حولي عن معنى هذه الكلمة. وبعد شهور أخبرني أحدهم أنه أرخص شراب بالبار لأن البارمان أو النادل الذي يقدم المشاريب للزبائن كان يستخدم قطعة من الإسفنج ينظف بها المنضدة أو قطعة الرخام أمامه، التي تتساقط عليها قطرات من شتى المشروبات… ينظفها بقطعة الإسفنج ثم يعصرها في كأس وهذا هو “المنزول”. وإذا كنت قد وصلت للمعنى الدقيق بعد شهور، فكيف أنقل هذا المعنى إلى اليونانية الحديثة؟
ومن هنا تأتي أهمية تشاور المترجم الفرنسي ــ مثلاً ــ مع أبناء اللغة العربية في بعض النقاط وبالذات عند وجود مفردات من اللهجات المختلفة. ولم يفت فاتحة الطايب أن تلقي نظرة فاحصة على الصحافة الأدبية وكيف استقبلت المترجمات من الرواية المغربية، بل وكذا اهتمت بالوسائل السمعية والبصرية، وأتبعت كل ذلك بملحق الأغلفة الفرنسية للروايات المترجمة. أما قائمة المصادر والمراجع فتنم عن اطلاع فاتحة الطايب على أحدث الدراسات النقدية بالعربية والفرنسية وغيرهما إلى جانب اطلاعها العميق على الإبداع العربي والأجنبي بصفة عامة.
ومثل هذه الدراسة المتميزة ينبغي أن تقدم منها نسخة موجزة للقارئ الفرنسي، ربما في شكل مقالات وأبحاث صغيرة أو كتيبات. ولماذا لا تقام ندوة مغربية في باريس حول هذا الموضوع المهم. ربما تكون نواة لمؤتمر عربي أوسع يقام في أوروبا حول الاستقبال الأوروبي للأدب العربي الحديث.
 رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه
رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه


