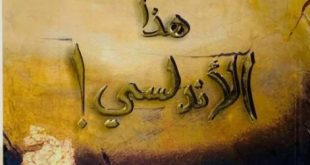تبدو مسألة العلاقة بين الرواية والسياسة، في المستوى الأول، بديهية، إذ لا يخلو أي نص روائي من مواضيع السياسة بامتياز : قضايا السلطة والصراع والمقاومة والخداع والسيطرة والخضوع، سواء عندما تعبر عنها شخصيات الرواية، أو تعكسها أحداث تاريخية موثقة أو محتملة تعيشها الشخصيات وتتأثر بها أو تصنعها. ومن هذه الزاوية تكون الرواية سياسة، سواء أعلن النص عن ذلك بشكل صريح أو ألمح إليه، بل إن درجة “تَسَيُّس” النص أو عدم تَسَيُّسه تترك للقارئ، في نهاية الأمر، الحرية ليربط الرواية المتخيَّلة بالسياسة وبأحداثها.
وفي المستوى الثاني، ليست المسألة بهذه البداهة. فالنقد الأدبي، الذي هو حقل محترِفي تأويل النصوص الإبداعية، شهد خلافات عميقة حول هذا الموضوع، بين من قرؤوا الرواية كتعبير عن واقع سوسيولوجي، وربطوها بأطروحات حقول العلوم الاجتماعية، وبين الذين رفضوا ما اعتبروه حشراً تعسفياً للسرد الروائي في “الواقع”، ودافعوا عن استقلاليته وحصر تأويله في لغته وبنياته.
إذا كانت هذه العلاقة قد تسببت في صراعات نظرية في حقل النقد الأدبي، فإنها في حقل العلوم السياسية، وهو الموضوع الأساسي في هذه الورقة، لم تثر خلافات معلنة على المستويين النظري والمنهجي. فبالنسبة للمدرسة الوضعية التي سعت لتقليد العلوم البحتة في مقاربة موضوع السياسة التي ترتكز على معطيات يشترط فيها المصداقية التجريبية الموّثقة، ظلت الرواية، باعتبارها نصاً متخيلاً، مادة خارجة عن الموضوع. وانحسر توظيف الروايات وشخصوها كاستعارات لأغراض ديداكتيكية أو جمالية، على غرار اعتبار أحد علماء السياسية مؤخراً الرئيس الفرنسي ماكرون يمثل شخصية راسْتينْياك(Rastignac)، البطل الذي اكتسح مدينة باريس بظرافته ودهائه في سلسلة روايات الكوميديا الإنسانية لبلزاك(Balzac) ، أيقونة الأدب الفرنسي.
لم تحظ الرواية، بصفة عامة، باهتمام يذكر من طرف علماء السياسة كمصدر ذي مصداقية تؤهلها لتُعتبر مصدر معرفة مشروعة في التحليل الأكاديمي للسياسة. فنحن لا نصادف في بيبليوغرافيات الكتابات الرائدة في هذا الحقل إحالات على الرواية، كما أن المراجع الأساسية في مناهج البحث في العلوم السياسية لا تذكرها كمصدر للمعرفة السياسية، بل إن هذا الإهمال يصل إلى حد ازدراء الخيال لدى البعض، لأنه لا يقدم أية فائدة معرفية، والإعلان الصريح من طرفهم عن رفض الفن، الذي تشكل الرواية نموذجاً له، كوسيلة للوصول إلى الحقيقة، التي تشكل المعرفة وجها لها.
مقابل هذا الموقف، هناك من يعتبر، على غرار تشُومْسكي، أن الخيال، بل الرواية بشكل خاص مصدراً علّم الحياة البشرية أكثر مما يُعلّمه علم النفس. ويتباهى مِيلان كُونْدِيرا بأن الرواية، وليست العلوم، هي القادرة على أن “تسبر الكائن المنسي”، ذاك الذي نسيته العلوم الحديثة، بما فيها العلوم السياسية طبعا، وأنها تكتشف ما لا يمكن لغيرها أن يكتشفه. ويقول أمبِرتو إيكو إننا نسعى من خلال الأعمال التخييلية إلى “العثور على صيغة قد تمكننا من إعطاء معنى لحياتنا”، وهي الغاية التي لا تحققها العلوم الاجتماعية. وما يدعم هذه الآراء، هو الإقبال الكبير على الروايات، سواء في شكلها المكتوب أو عندما تنقل إلى أفلام سنيمائية، من طرف جمهور واسع لا يحلم أي نص في العلوم الاجتماعية بأن يحظى به.
لكن الملاحظ هو أن هذه المواقف التي تتغنى بالقدرات المبهرة للرواية تظل في جلها تعابير تمجد الرواية من خارج حقل العلوم، بما فيها السياسة، وتبدو كما لو أنها تنشد الحصول على اعتراف بقيمة الرواية من طرف عشاقها، في عالم غدت فيه العلوم، ومفاهيمها، ومنطقها، وأدلتها، وقوانينها، سلطة تحتكر المعرفة المشروعة، وتهيمن على عالم السياسة والاقتصاد والتكونولوجيا والإعلام. ولذلك فإن الهوة بين المعرفة العلمية والخيال، بصفة عامة، وبين علم السياسة والرواية كنموذج، تبقى قائمة، وتنتظر البحث عن كيفية ترميمها، خاصة وأن الباراديغمات(paradigmes) السائدة في حقل علم السياسة، تواجه اليوم، ربما أكثر من السابق، أزمات على المستويين النظري والمنهجي في فهم الإشكالات التي وضعت على عاتق هذا العلم منذ تأسيسه: المساواة، والعدل، والسلم. إن تفاخر مفكرين لا تخفى مؤهلاتهم المعرفية بدور الرواية في فهم السياسة وقضايا جوهرية مرتبطة بها، يدعو إلى أن يؤخذ مأخذ الجد، وإلى البحث عن كيفية توظيف الرواية كمرجع للمعرفة وليس التوقف على عرضها في موقع شرفي لتزيين اللغة العلمية الصارمة والتي تلام أحياناً على أسلوبها الجاف الخالي من المتعة. هناك إمكانيات، إذن، تسمح لكي تتبوأ الرواية موقعاً في معرفة السياسة يضاهي العلوم الاجتماعية والإنسانية والبحتة وأدوات البحث التجريبي المتمثلة في المعاينات الميدانية والإحصائيات والاستجوابات والاستمارات. ذلك أن بعض هذه الإمكانيات قد اكتُشفت منذ مدة طويلة، ولكنها لم توظف بشكل يسمح بفتح أبواب العلوم السياسية التي ظلت موصده في وجه الرواية. وبعضها الآخر يبرز بشكل مثير منذ أن اقتحم السردُ عالمَ السياسة اقتحاماً كأداة لتعبئة الحركات الاجتماعية، وكتعبير عن الماضي السياسي الأليم، وأيضا موضوع المشاعر الذي أصبح يحتل موقعا متميزا في علم السياسة. سأعرض هذه القضايا في النقط الأربع التالية:
أولا، الإمكانية الأولى لتوظيف الرواية في علم السياسة مهدت لها المدرسة التأويلية. إذ وعلى عكس المدرسة الوضعانية التي طمحت إلى تقليد العلوم الطبيعية، وإلى السعي لاكتشاف قوانين لتفسير السلوك البشري، اعتبرت المدرسة التأويلية أن فهم السلوك البشري، بما فيه السلوك السياسي، يتطلب الاجتهاد في كيفية تأويل شبكات المعاني المرتبطة بهذا الفعل، عن طريق التقمص العاطفي (empathy) لفهم هذا الفعل، عوض الاقتصار على الوصف التجريبي الموضوعي القابل للقياس وللتجريب. كان الأنثروبولوجيون سباقين إلى تبني هذا الاتجاه، أكثر من علماء السياسة. لكن توظيفهم له لم يمتد إلى حقل الرواية، بل اقتصر على تأويل التعابير الثقافية الشعبية وأهملوا الرواية، التي ربما اعتبروا حداثتها غير منسجمة مع المعتقدات والأساطير والتصورات المتوارثة التي شكلت المقومات الثقافية التي سخَّروا جهودهم للنبش فيها. قد يكون سبب إهمال الرواية من طرف الأنثروبولوجيين، والأمر هنا لا يتوقف عند أولئك الذين درسوا ثقافات غير ثقافاتهم، بما فيهم المغاربة، في أنهم لم يعتبروا الروائيين شريحة اجتماعية تنتج مادة ذات قيمة أنثروبولوجية تذكر. والسبب الآخر في إهمال الرواية من طرف الأنثروبولوجيا، بل والعلوم الاجتماعية بصفة أعم، هو أن التقسيم الأكاديمي جعل الرواية حكراً على أقسام دراسات النقد الأدبي، وعلى المتخصصين في هذا المجال المؤهلين أكاديمياً دون غيرهم للبث في إشكالاتها.
ثانياً، مهدت المدرسة التأويلية في العلوم الاجتماعية لاعتبار السرد انطلاقاً من السير الذاتية موضوعاً للدراسة ومصدراً للمعرفة أيضاً، وهو ما ساهم في تزايد الاهتمام بهذا الموضوع الذي أصبح يعرف بالنقلة السردية (the narrative turn). وفي نفس الإطار، اكتشف الباحثون في الحركات الاجتماعية الأهمية المركزية للحكي القصصي(storytelling)كإطار مُعَبِّئٍ للفعل الاحتجاجي بشكل يتفوق على الخطابات التي تتبنى البيان والفصاحة والإقناع من منطلقات إيديولوجية وعقائدية. كما أن الاهتمام بموضوع عنف الدولة والكشف عن مخالفاته المؤلمة التي جاهدت رقابة الأنظمة السلطوية على إنكارها وإخفائها، فسحت المجال أمام ضحايا هذا العنف ليروُوا شهاداتهم، وليعتبر حكيهم مادة لا محيد عنها لتعميق فهم ظواهر سياسية بامتياز. وبموازاة مع التحول السردي عرفت العلوم الاجتماعية، بما فيها العلوم السياسية، نقلة أخرى أصبحت فيها المشاعر تحظى باعتراف الباحثين وتشكل مادة للدراسة ومدخلاً نظرياً لتفسير الظواهر السياسية. أطلق على هذه النقلة التي بدأت في الانتشار منذ ثمانينيات القرن العشرين بنقلة المشاعر (the emotional turn) تتميز باعترافها بأن المشاعر غير متنافية مع الوعي والعقلانية، بل تحتوي أيضاً على أبعاد إدراكية. لقد ساهمت نقلة المشاعر في تحرير السياسية من القفص الحديدي الذي حصرت فيه مدراسُ الخيار العقلاني الفاعلَ السياسي، وأن توثق للدور الحاسم في الفعل السياسي للخوف، والرحمة، والكراهية، والسخط، والكبرياء، والشك، والانتقام، باعتبارها تشمل أبعاداً للعملية المزدوجة للتفكير وللإحساس معاً(feeling-thinking) .إن النقلة السردية، ونقلة المشاعر، باعتبارهما تفتحان الآفاق على باراديغمات جديدة، تدعوان للبحث عن مادة جديدة لا تنحصر في المعطيات المتداولة، وهي بذلك تفتح الباب أمام الباحثين في علم السياسة لولوج مجال الرواية باعتبارها عالم السرد والحكي والمشاعر بامتياز.
ثالثاً، لم تؤد نقلتا السرد والمشاعر إلى إقبال ملحوظ على الرواية في حقل العلوم الاجتماعية، إذ لا تزال مسألة القيمة المضافة للرواية في المعرفة في الحاجة إلى تعميق، خاصة وأن المشككين في قيمتها يُصرّون على أن الرواية ليست سوى محض خيال. يقول المدافعون عن الرواية، بأن الفن ليس خيالاَ محضا، بل هو طريقة للنفاذ إلى جوانب من الواقع يظل عصياً على العالِم، بل والإنسان العادي أيضاً، الذي يصر على اعتماد منظور إدراكي صرف للعالَم. فالرواية تعطي معنى للواقع، وهي بذلك تشكل أداة لفهمه، وإن كانت عوالمها متخيلة، ولكنها مستوحاة بشكل أو آخر من معاناة الروائي كتجارب وأفكار وأحاسيس معيشة، وقوة إقناعها غير مستمدة من مراجع موثقة، بل مما تحققه لدى القارئ من احتمال المطابقة(vraisemblance) مع تصوراته عن واقع ما، ومحتواها زائف، لكنه مع ذلك ينفذ إلى جوانب متعددة من التجارب الإنسانية المشتركة، وهذا سبب كافٍ لكي تعتبر الرواية، باعتبارها خيالاً، مصدراً ملائماً للعلوم الاجتماعية.
رابعا، إذا كانت هذه المقاربة تعترف بالقيمة المعرفية للرواية، فإن هناك مقاربة استهدفت ما اعتبرته ادعاء الكتابة العلمية باعتبارها التعبير بامتياز عن المعرفة الموضوعية التي تتفوق بها على الإبداعات الفنية. لقد ساوت المقاربة الجديدة بين الكتابة الروائية وبين التاريخ، كنموذج للكتابة العلمية، باعتبار التاريخ ليس إلا سرداً كما هو الشأن بالنسبة للرواية، وأنه بالتالي لا يحق له أن يدعي احتكار حقيقة لا تصل إليها الرواية. بل إن هايْدن وايْت(Hayden White) اعتبر الكتابة التاريخية، ويمكن أن نضيف كتابة العلوم الاجتماعية، لا تسعى، على غرار الرواية، إلا إلى إضفاء تجانس على الأحداث لا يختلف عن التجانس الذي تقوم به حبكات الرواية المتمثلة في الحبكة الرومانسية، والتراجيدية، والهجائية، والكوميدية. وتصبح بالتالي القيمة المعرفية التي تميز كتابات العلوم الاجتماعية على النصوص الأدبية، ليست هي الحقيقة التي تتباهي بها، بل فيما تعرضه من تجانس على الأحداث اعتماداً على المقاربة واللغة والنظريات والمناهج التي يعترف بها حقلها الأكاديمي.
لا شك أن هذه المقاربة تثير حفيظة المدافعين عن العلوم الاجتماعية والإنسانية، لكونها تتفوق على الرواية كوسيلة أضمن للحقيقة وللمعرفة. لكن مثل هذه المواقف ظلت تضعف منذ مدة أمام انتقادات رواد ما بعد الحداثة، وبعد تراجع علماء كل التخصصات عن الثقة المطلقة في قدرة العلم ومناهجه التي سادت منذ القرن التاسع عشر على تقديم الإجابات الحاسمة لانتظارات الإنسان المعاصر.
نحن اليوم في فترة غير مسبوقة تسمح بتصالح العلوم الاجتماعية مع الرواية، وتدعو إلى بلورة المناهج المناسبة لهذا الغرض. ولا يحتاج هذا التصالح فقط إلى البحث عن احتواء معرفة من طرف أخرى، على غرار ما كان يعبر عنه رواد الرواية الواقعية في القرن التاسع عشر، مثل بالزاك الذي اعتبر نفسه عالم اجتماع، ولكن يحتاج إلى مقاربة تسمح بالانتقال عبر الحقول المعرفية بدون مواقف التفوق أو الدونية المسبقة، وبالقدر الذي يسمح به كل تخصص لمعالجة الإشكال الذي يواجهه. وبالنسبة لعلم السياسة، فإن مواكبة نقلتي المشاعر والحكي، تتطلب بإلحاح الانفتاح على النقد الأدبي والرواية، بل على باقي المجالات الفنية الأخرى.
هناك حاجة للمزيد من تطوير مناهج العلوم السياسية لمقاربة الإشكالات السياسية المطروحة على المشتغلين في هذا الحقل المعرفي، كالعنف، والتسلط، واللامساواة، والحرية، والعدل. ولكن لا بد في نفس الوقت من الاعتراف بأن حصر أدوات البحث في المناهج التي ظلت متداولة باسم الصرامة العلمية، تحول دون تعميق فهم هذه القضايا الإنسانية المشتركة والمحاورة بشأنها بين جميع الأكاديميين، بل بين جميع الناس.
بيبليوغرافيا
من بين الكتابات التي اعتمدت عليها في هذا النص، ما يلي:
Longo, M. (2015). Fiction and Social Reality: Literature and Narrrative as Sociological Resources. Surrey, UK: Ashgate.
Polleta, F. (2009). Storytelling in Social Movements. In H. Johnston ed., Culture, Social Movements, and Protest (pp. 33-54). London: Routledge.
Susen, Simon, (2015). The Postmodern Turn in the Social Sciences. New York: Palgrave mcmillan.
 رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه
رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه