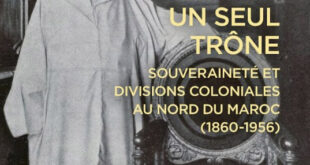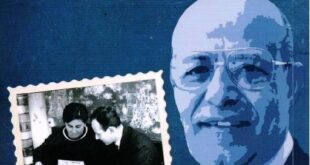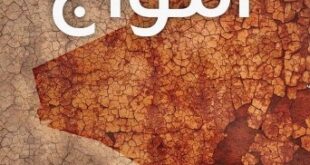علامات، العدد37، سنة 2012
 صدر حديثاً العدد الجديد من مجلة علامات المغربية التي يديرها المترجم والسيميائي سعيد بنكراد. ومن المواد التي حفل بها العدد37 ترجمة الألفاظ وترجمة المفاهيم “العلمانية نموذجا” لعبد الله العروي. وقد أشار الكاتب إلى أن الموضوع لا يتعلّق بالعلمانية بقدر ما يتعلّق بالمصطلح في حدّ ذاته، فقد ساد في المجتمع العربي تعارض بين كلمة “علماني” و”إسلامي” في حين أن كلمة إسلامي لا تقابل كلمة علماني. فما يعارض الإسلام، كما هو متداول، هو لفظ الجاهلية أو الزندقة أو الكفر. فيتساءل الكاتب عن فحوى هذا التعارض في مجتمعنا. وقد حاول تصحيح بعض المغالطات التي وقع فيها المترجمون وترسّخت في ذهن القُرّاء. لذلك حاول ضبط المصطلح والمفهوم لوضع كلمة “علمانية” في سياقها العلمي اللغوي والديني والتاريخي الحداثي. وعالج أحمد بوحسن مسألة ظهور نظرية التلقي في كل من أوروبا وأمريكا وما واكبها من دراسات ومجال انتقالها إلى النقد العربي المعاصر، ورصد وضعيتها ومكوّناتها بوضعها في سياقها التاريخي والمعرفي والثقافي والاجتماعي. وقد نهج في عرضه منهج المعالجة التكوينية الذي يقوم على أسس معرفية وإبستيمولوجية بالإضافة إلى التصورات المعتمدة في الدراسات المقارنة. وقدّم سعيد بنكراد “السردية والتجريد المفهومي”. فأشار إلى الترابط الوثيق بين الزمن والنشاط السردي. فمن خلال آليات السرد وتقنياته يحضر الزمن. كما أن السرد لا يتحقّق إلا ضمن إواليات الزمن. فالزمن مطلق في ذاته وحاضر في النشاط الإنساني، وهو ما يؤكّد واقعيته. فتعرّض إلى الزمن وإكراهات المفاهيم أو غيابها في الحكاية. فالمفهوم لا يستقيم وجوده إلا إذا تمكّن من تخليص التجربة من طابعها الزمني. ليخلص إلى أنّ السرد يساعد على إدراج التجربة الفردية المحدودة في الزمان في الذاكرة الإنسانية. وتناول محمد الداهي التطويع الانفعالي في الرسالة الإشهارية من خلال تحليل رسالة إشهارية. فاهتمّ بالبُعد التلفّظي للرسالة الإشهارية الذي يسعى إلى لفت انتباه المتلقّي وتحريضه على الانقياد والانصياع لغرائزه دون تفكير. بالإضافة إلى البعد غير اللغوي والبعد الحكائي وكذلك مسألة الصورة في الرسالة الإشهارية. وشارك ناصر يوسف بدراسة حول “العلامة التجارية والإنسانية” من خلال أخلاقيات إدراة التسويق في اليابان. فقدّم عرضاً تمهيدياً لأخلاقيات الأسطورة الدينية، وأخلاقيات الأسطورة التقنية متخذاً من التسويق أنموذجاً. فتناول استراتيجيات الإدارة التسويقية في اليابان وما اتّبعته من خُطط وطنية واقتصادية وإنمائية صاحبها تطوّرٌ في حركية التسويق دفعت بها إلى الصدارة. وقد ساعدها على ذلك بلورة فلسفة إنمائية تسويقية سعت إلى ترسيخ أخلاقيات العمل. بينما تناول رشيد مرسلي “التفاعل اللغوي الثقافي”، بعد أن أصبح التفاعل الثقافي في الفكر المعاصر مجالاً خصباً للبحث العلمي في العديد من الجامعات والمؤسسات الثقافية، مشيراً إلى ظهور المصطلح في كل من كندا وأمريكا وأوروبا. أما بخصوص التفاعل الثقافي اللغوي. فلم ينل بعدُ حظّاً وافراً من البحث العلمي. فالتفاعل الثقافي رهين بالتفاعل اللغوي، الذي هو وسيلة للمعرفة الثقافية في التواصل،لأن اللغة قوام الثقافة. والثقافة سبيل صمود اللغة واستمراريتها.
صدر حديثاً العدد الجديد من مجلة علامات المغربية التي يديرها المترجم والسيميائي سعيد بنكراد. ومن المواد التي حفل بها العدد37 ترجمة الألفاظ وترجمة المفاهيم “العلمانية نموذجا” لعبد الله العروي. وقد أشار الكاتب إلى أن الموضوع لا يتعلّق بالعلمانية بقدر ما يتعلّق بالمصطلح في حدّ ذاته، فقد ساد في المجتمع العربي تعارض بين كلمة “علماني” و”إسلامي” في حين أن كلمة إسلامي لا تقابل كلمة علماني. فما يعارض الإسلام، كما هو متداول، هو لفظ الجاهلية أو الزندقة أو الكفر. فيتساءل الكاتب عن فحوى هذا التعارض في مجتمعنا. وقد حاول تصحيح بعض المغالطات التي وقع فيها المترجمون وترسّخت في ذهن القُرّاء. لذلك حاول ضبط المصطلح والمفهوم لوضع كلمة “علمانية” في سياقها العلمي اللغوي والديني والتاريخي الحداثي. وعالج أحمد بوحسن مسألة ظهور نظرية التلقي في كل من أوروبا وأمريكا وما واكبها من دراسات ومجال انتقالها إلى النقد العربي المعاصر، ورصد وضعيتها ومكوّناتها بوضعها في سياقها التاريخي والمعرفي والثقافي والاجتماعي. وقد نهج في عرضه منهج المعالجة التكوينية الذي يقوم على أسس معرفية وإبستيمولوجية بالإضافة إلى التصورات المعتمدة في الدراسات المقارنة. وقدّم سعيد بنكراد “السردية والتجريد المفهومي”. فأشار إلى الترابط الوثيق بين الزمن والنشاط السردي. فمن خلال آليات السرد وتقنياته يحضر الزمن. كما أن السرد لا يتحقّق إلا ضمن إواليات الزمن. فالزمن مطلق في ذاته وحاضر في النشاط الإنساني، وهو ما يؤكّد واقعيته. فتعرّض إلى الزمن وإكراهات المفاهيم أو غيابها في الحكاية. فالمفهوم لا يستقيم وجوده إلا إذا تمكّن من تخليص التجربة من طابعها الزمني. ليخلص إلى أنّ السرد يساعد على إدراج التجربة الفردية المحدودة في الزمان في الذاكرة الإنسانية. وتناول محمد الداهي التطويع الانفعالي في الرسالة الإشهارية من خلال تحليل رسالة إشهارية. فاهتمّ بالبُعد التلفّظي للرسالة الإشهارية الذي يسعى إلى لفت انتباه المتلقّي وتحريضه على الانقياد والانصياع لغرائزه دون تفكير. بالإضافة إلى البعد غير اللغوي والبعد الحكائي وكذلك مسألة الصورة في الرسالة الإشهارية. وشارك ناصر يوسف بدراسة حول “العلامة التجارية والإنسانية” من خلال أخلاقيات إدراة التسويق في اليابان. فقدّم عرضاً تمهيدياً لأخلاقيات الأسطورة الدينية، وأخلاقيات الأسطورة التقنية متخذاً من التسويق أنموذجاً. فتناول استراتيجيات الإدارة التسويقية في اليابان وما اتّبعته من خُطط وطنية واقتصادية وإنمائية صاحبها تطوّرٌ في حركية التسويق دفعت بها إلى الصدارة. وقد ساعدها على ذلك بلورة فلسفة إنمائية تسويقية سعت إلى ترسيخ أخلاقيات العمل. بينما تناول رشيد مرسلي “التفاعل اللغوي الثقافي”، بعد أن أصبح التفاعل الثقافي في الفكر المعاصر مجالاً خصباً للبحث العلمي في العديد من الجامعات والمؤسسات الثقافية، مشيراً إلى ظهور المصطلح في كل من كندا وأمريكا وأوروبا. أما بخصوص التفاعل الثقافي اللغوي. فلم ينل بعدُ حظّاً وافراً من البحث العلمي. فالتفاعل الثقافي رهين بالتفاعل اللغوي، الذي هو وسيلة للمعرفة الثقافية في التواصل،لأن اللغة قوام الثقافة. والثقافة سبيل صمود اللغة واستمراريتها.
وكتب محمد عفط “مسالك المعنى” أو حذق الوعي النقدي، من خلال تقديم قراءة في كتاب “مسالك المعنى دراسة في بعض أنساق الثقافة العربية” لسعيد بنكراد، لما يمتاز به الكتاب من عمق معرفي ومنهجي على مستوى التّفعيل الإجرائي والنتائج المحصّل عليها. فالباحث لم يقدّم تحليلاً لمسالك المعنى بدراسة مجموعة من الظواهر. لكنّه ارتقى بها إلى مستوى الأنساق في مقاربة تركيبية نسقية متّخذاً من مجموعة من المعارف أُفقاً للنظر. فلم تحضر السيميائيات كتخصّص علمي بل كمشروع فكري لتحليل الظواهر الثقافية. وتناولت حورية الخمليشي “إشكاليات ترجمة الشعر”. فأشارت إلى أن الترجمة الشعرية لعبت دوراً في تحديث القصيدة والرؤية إليها وقراءتها. وقد تحوّلت في الفكر الحديث إلى موضوع نظري له من المسألة الشعرية الفنّية بقدر ما له من المسألة العلمية الفلسفية. ففي تاريخ الشعر العربي نجد لترجمة الشعر كبير الأثر في الانفتاح على الشعريات العالمية. كما عرف العصر الحديث إقبالاً متزايداً للشعراء على ترجمة الشعر. إلا أن ترجمة الشعر على الدوام متعلّقة بثقافة الشاعر. وتحدّثالعياشي ادراوي عن الفلسفة التحليلية ومأزق اللغة مشيراً إلى ما تتميّز به الفلسفة التحليلية عن غيرها من التّوجّهات الفلسفية. فاهتمّ بمفهوم الفلسفة التحليلية ومبادئها وخصائصها وأهدافها وتحديد المعالم الكبرى لهذه الفلسفة، مشيراً إلى ارتباطها الكبير باللغة كمطلب لتحقيق الدّقّة والفهم باللجوء إلى المعالجة الذّرّية في الإشكالات الفلسفية، والعناية كذلك بالجانب العلمي المنطقي الممنهَج، والنّزوع إلى البُعد التواصلي التّذاوتي. وكتب عمر التاور عن “منزلة العلوم الإنسانية” في كتاب الكلمات والأشياء لميشيل فوكو، مشيراً إلى ما سمّاه بالتلازم العضوي بين المعرفة والسلطة في مَتن العلوم الإنسانية. ومن خلال ذلك أجاب عن مجموعة من التساؤلات المعرفية التي استأثرت باهتمام فوكو وجعلته يرفض الاعتراف بالعلوم الإنسانية، ويرى في تأثير الرياضيات أو العلوم التجريبية أو الأحداث مجرّد ظواهر.
ويتضمّن العدد ملفّاً خاصّاً عن تمثلات المرأة في اللغة والفن:
وقد تناول محسن أعمار المرأة واللغة قراءة في التمثُّلات السيميائية والرمزية. يرى الكاتب أننا لا نستطيع إدراك العالم وتمثّله ثقافياً إلا بواسطة اللغة لإنشاء علاقة بين الوعي في أبعاده الذاتية وعالم اللغة عن طريق التأويل والتمثلات السيميائية والرمزية. فالفوارق اللغوية بين الذكر والأنثى معطى ثقافي لا دخل فيه للطبيعة. وتتجسّد في مستواها الرمزي في هذا النظام اللغوي، الذي لعب دوراً في تصنيف الجنسين في شتى أنواع الخطابات قديماُ وحديثاً. فاهتمّ بالتمثلات التي يشيدها المحتمع حول المرأة من خلال الأمثال الشعبية والتي يمكن حصرها في مجموعة من التيمات التي تشكّل ثنائية العقل والجسد، والخير والشر، والجمال والقبح. وكتب ممدوح فرج النابي عن “الخطاب النسوي” عند فاطمة المرنيسي. نماذج تحرُّر عبر التّخييل السردي. فأعمال فاطمة المرنيسي تمتاز بتداخل الأنواع والتخصصات بين الأدبي والتاريخي والأوتوبيوغرافي وغيرها محاولة في كل ذلك تحرير المرأة عبر التاريخ من سلطة مجتمع ذكوري. فكتابات المرنيسي تمتاز بالتمرد والصمود والمواجهة. فتدين العقلية العربية والغربية معاً رغم الفارق بينهما في التكوين الثقافي والفكري، وإن اتّسم الغرب بدعوته إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وقدّمت نزيهة الخليفي “المرأة الرمز في ديوان تصطاد الشياطين” لسمير درويش. فصورة المرأة تكتنف في الشعر العربي الحديث العديد من الرموز والإيحاءات والدلالات. ويقدّم ديوان “تصطاد الشياطين” صورة مختلفة للمرأة صورة تجعل منها فضاءً للتفكير والتساؤل وإثبات الذات. ودلالة العنوان في الديوان عتبة أولى لقراءة النص بعد أن سعى الشاعر، من خلال رمزية المرأة، إلى الكشف عن ذاته عبر التّناص والحوار واللغة الشعرية العاشقة. وكتب طبي عيسى عن “الجينيالوجيا عند أحلام مستغانمي”. إذ حاول الكاتب رصد طريقة ثلاثية أحلام مستغانمي في التّعامل مع نصوص مالك حدّاد، الذي لم يكن يُتقن إلا اللغة الفرنسية. ويتأسّس التواصل السّردي في هذه الأعمال على التّناص المباشر. وأحياناً يأتي توظيف هذا التّناص بدلالاته التي جاء بها في النص الأصلي قبل أن يمنحه السارد دلالة مغايرة في سياق جديد، واشتغال التناص باعتماد تلخيص نصوص وتوظيفها في بنية الحكي يُعطي التّشكيل السّردي خاصّية التّضمين. وقد جعلت أحلام مستغانمي رواية مالك حداد محوراً خصباً لنصوصها السردية.
وكتبت نورة الجرموني “النقد النسوي العربي” والسؤال السوسيولغوي. فلا يمكن فصل السؤال السوسيولغوي عن سؤال الاختلاف الجنسي وكل أشكال التمايز الاجتماعي في غياب وجود اجتماعي ولغوي مستقل بالنسبة للمرأة. ويتضمّن النص أسئلة معرفية عن وضعية إبداع المرأة في السياق الثقافي اللغوي، والصعوبات التي تواجهها، لصياغة خطاب يحمل رؤية عميقة لاكتشاف الذات والحياة والوجود والعالم، بالاستناد إلى مجموعة من الكتابات المهتمة بالموضوع. ففي غياب استحضار صوت المرأة يتعذّر الحديث عن خصوصية إبداعية فريدة ومتميّزة.
وقدّمت المجلة كعادتها عناوين لأحدث الإصدارات وهي كالتالي:
كتاب المجتمع والمقاومة في الجنوب الشرقي المغربي المواجهة المغربية للأمبريالية الفرنسية 1851-1912 لروس دان قراءة أحمد بوحسن مراجعة عبد الأحد السبتي. كتاب “رهانات التاريخ الاجتماعي” قراءة في كتاب بين الزطاط وقاطع الطريق لعبد الأحد السبتي إعداد أحمد بوحسن. كتاب سيرورات التأويل: من الهرموسية إلى السميائيات لسعيد بنكراد. كتاب لم أر الشلالات من أعلى لمحمد ميلود غرافي (رواية). كتاب ماروكان..Marocainلمحمد العتروس (قصص). كتاب مدارات المستحيل لحسن بحراوي. مجلة ديهيا التي تصدر من بركان. كتاب التراث والحداثة في المشروع الفكري لمحمد عابد الجابري.
 رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه
رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه