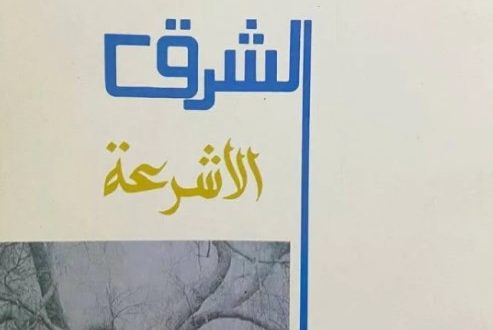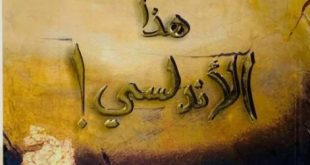نبيل سليمان، مدارات الشرق-1 الأشرعة، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، الطبعة الثانية، 1994
مقدمة:
 يشكل التاريخ مادة مفتوحة في وجه كل الحقول المعرفية، البحثية والإبداعية، ولعّل أكثر المنفتحين على حقل التاريخ هم الروائيون. فالرواية كما التاريخ، بمفهومه الحولياتي[1]، تستدمج وتتقبل كل أبعاد المعرفة، وتتفاعل معها مشكلةَ نصاً متعدد الأبعاد.
يشكل التاريخ مادة مفتوحة في وجه كل الحقول المعرفية، البحثية والإبداعية، ولعّل أكثر المنفتحين على حقل التاريخ هم الروائيون. فالرواية كما التاريخ، بمفهومه الحولياتي[1]، تستدمج وتتقبل كل أبعاد المعرفة، وتتفاعل معها مشكلةَ نصاً متعدد الأبعاد.
أنطلق في ورقتي، من موقع الباحث في التاريخ. بغية الحديث، أو محاولة الخوض في موضوع العلاقة بين الأدب(الرواية) والتاريخ. عنونت ورقتي ب: ” التخييل وسؤال التاريخ والهوية: قراءة في مدارات الشرق- الأشرعة“. وتتمثل أهدافها في رصد أهم التقاطعات والتفاعلات الموجودة بين السرد والتخييل الروائيين وبين “المرجع التاريخي” المؤطر بزمنيته ومجاله، بنصوصه ووثائقه، بأعلامه وفاعليه، بوقائعه وأحداثه. انطلاقا من قراءة في رواية مدرات الشرق- الأشرعة[2]. لن يكون الاهتمام بدراسة الرواية من جوانبها الأدبية السردية الصرفة، بل إنّ اهتمام المداخلة الأول هو رصد العلاقة بين الرواية أو العمل الروائي وبين التاريخ أي الوقوف عن بعض أشكال وصيغ الحضور التاريخي في النص الروائي، وطرق وكيفيات تعامل الروائي معها. ومن منطلق يحاول ما أمكن الارتكاز على “الخطاب”[3] من منظور التاريخ، باعتبار نص الرواية اشتغل على مادة تمتح من التاريخ وتتخذ هذا الأخير موضوعا لها، لكن باختلاف الصيغة والطريقة والكيفية، رغم التقاطعات المنهجية التي تم رصدها بين المجالين. كما وضحت الورقة ذلك أعلاه. وباعتبار الخطاب في الرواية ” يختص بنقل عالم متخيل له زمان ومكان معينان، وفيه تجري أحداث، تنهض بها شخصيات؛ هو خطاب يحمل حكاية ينقل واقعها راو“[4]. وإن هذا التعريف المعطى للخطاب يتساوق مع ما نعتبره ثوابت للفعل التاريخي، أي الزمان والمكان والحدث والفاعل، ومن هنا نعتبره مدخلا منهجيا نحاول من خلال قراءة هذا النص الروائي.
تسعى المداخلة إلى التفكير في القضايا المذكورة أعلاه انطلاقا من أعمال الروائي والناقد السوري نبيل سليمان لما تمتاز به تجربة هذا الأخير من انفتاح كبير على التاريخ، ومن هيمنة النقد والبناء، والرجوع إلى المراجع والمصادر التاريخية المتخصصة. وما يلفت الانتباه في هذه التجربة هو انبناؤها على أسئلة الراهن العربي، وعلى الحفر في تشكل الهوية العربية، وعلى إشكالية التحرر. وعلى تفاعل مستمر مع قضايا المجتمع العربي من منظور قومي موسع حسب مرجعية الناقد والروائي نبيل سليمان.
إن المنطلق الأساسي لهذه القراءة هو إطار التاريخ وخصوصياته المعرفية التي تتمظهر في النص الروائي ووفق خصوصيته السردية، من خلال الارتكاز على تساؤلات مركزية من قبيل: ما العلاقة الممكنة، منهجيا ومعرفيا، بين الإبداع والتخييل الروائي وبين التاريخ؟ وما أشكال وتجليات حضور التاريخ ضمن العمل الروائي في مسار نبيل سليمان؟ وما الصيغ السردية التي يشتغل بها الروائي في التاريخ وأحداثه؟ وهل تساهم الرواية في إضاءة العتمات التاريخية، أو ملء البياضات المتروكة في بعض مراحل وفترات التاريخ المعلوم كما يقول بذلك الروائيون في تعليقهم على التاريخ؟ وكيف يمكن بناء الهوية أو العثور عليها ارتكازاً على أحداث التاريخ ومن خلال النص الروائي؟
أولا: نبيل سليمان: السرد المتأسس على التاريخ
ولد نبيل سليمان بسوريا سنة 1945، تخرج من قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة دمشق. حقق تراكما مهما وكبيرا عل مستوى الإبداع الروائي، وعلى المستوى التراكم النقدي. صدرت أولى رواياته (ينداح الطوفان) سنة 1970. ومن أواخرها (مدائن الأرجوان) سنة 2013. مع وجوب الذكر أن نص الرواية موضوع هذه الورقة (مدارات الشرق-الأشرعة) تشكل جزءا في مشروع روائي متكامل، على مستوى الكم (أربعة أجزاء)، وأيضا على مستوى نوعية العمل التي صنف عند بعض النقاد والباحثين (ملحمة روائية عربية). أصدر نبيل سليمان، في الاتجاه نفسه، عدة كتب ومؤلفات نقدية من بينها: وعي الذات والعام (1985)، أسئلة الواقعية والالتزام (1985)، فتنة السرد والنقد (1994)، الثقافة بين الظلام والسلام (1996)، أسرار التخييل الروائي (2005).
حدد نبيل سليمان علاقته بالتاريخ منذ وقت مبكر من مسيرته الأدبية والنقدية.، إذ جعل منه أساسا ومرتكزا صلبا في “وعي الذات والعالم“. بل إنه يربط جدليا الإنسان بالتاريخ والتاريخ بالإنسان. ويرى، بناء على ذلك، التاريخ “سدا منيعا ضد كل الحتميات، وحائط صد في وجه كل المقاربات والتصورات التجزيئية والدوغمائية (Dogme)“. ويقترح في المقابل “التحليل الجدلي التاريخي” بناء على الشروط المنتجة، ومسار التكوين والنشوء في مستوياته وأبعاده المتعددة.
تظهر الفقرة السابقة المنطلقات النظرية والمنهجية التي تحكم وتنظم رؤية ومنظور نبيل سليمان على مستوى الإبداع الروائي وأيضا على مستوى النقد. وبشكل عام على المستوى الفكري والإيديولوجي. وبرز أنه لا يرى أن هناك فعلا ناجزا وجاهزا، بل يؤكد على البناء والنسبية، وعلى مراعاة السياقات والشروط المنتجة. ولربما يظهر نوع من التقاطع “المنهجي” بين رؤيته النقدية وبين مرتكزات العمل البحثي في التاريخ. وهو من بين ما تسعى الورقة إلى البحث فيه والتقاط بعض مظاهره وتجلياته تأسيسا على النص المدروس.
ثانياً: مدارات الشرق: الرواية-المشروع ودواعي الاختيار
تركز هذه المساهمة على الجزء الأول من رواية “مدارات الشرق”، والتي تقع في أربعة أجزاء[5]. وتشكل مشروعا روائيا ذا خصوصية، جعلته يندرج في تصنيف الروايات المئة الأفضل عربيا، وتجعل لمؤلفها الروائي السوري نبيل سليمان مكانة مهمة في الإنتاج الروائي العربي إلى حدود اليوم.
يمكن تبرير اختيار رواية مدارات الشرق-الأشرعة للمساهمة بهذه الورقة، بكونها تتطرق لمرحلة تاريخية تمتد بتأثيراتها إلى الزمن العربي الراهن، وهي بداية القرن 20 التي شهدت تحولات سياسية ومجالية كبرى في المشرق العربي بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية نهاية الحرب العظمى الأولى سنة 1918. وكانت لها انعكاسات ممتدة على باقي مناطق المجال العربي-الإسلامي. تتناول الرواية مراحل التحرر العربي في المشرق وصراعاته مع القوى الاستعمارية، وبداية تقسيم المنطقة في إطار ما عرف باتفاقية سايكس-بيكو (1916).
تراكمت لديّ عدة أسئلة من خلال الاشتغال على الرواية والتخييل، وتعزز ذلك من خلال المناقشة والحضور في ندوات حول الموضوع نفسه. وبرز هذا الأمر أيضا عبر اطلاعي على محاولات تجديدية في الكتابة التاريخية، تلح وتصر على ضرورة حضور البعد السردي فيها. وفق هذا السياق والمسار تشكلت أسئلة هذه الورقة، وعبرها تحاول التفكير في علاقة التاريخ والتخييل. وبناء عليه تكون الرواية المتناولة مدخلا للتفكير والمناقشة والتفاعل، وليس موضوعا له. كانت الاستعانة، في هذا الاتجاه، بدراسة نقدية وأدبية لها، أساسا مساعدا. وضمنها الدراسة المذكورة سابقا حول المعالجة الفنية للتاريخ.
لابدّ من التنويه بتوسع البحث والاهتمام التاريخي بالتراكم السردي والأدبي المتأسس على التاريخ والتخييل على ضوئه. ويفيد هذا الأمر المنظور البحثي للمؤرخ، ويضعه في قلب النقاشات المنهجية والعلمية والمعرفية الراهنة والمتجددة، كذلك يجعله في حوار مستمر ومتداخل ومتكامل مع باقي التخصصات والحقول المعرفية.
ثالثاً: المفاهيم الإجرائية للقراءة
من أجل ألا يتيه مسار القراءة، أصرح بمفاهيمها الأساسية التي تحدد وجهتها البحثية. أنطلق من مفهوم التاريخ، الذي يحيل على أحداث “متفق” على حدوثها، مختلف في قراءتها، وتحديد أسبابها ونتائجها، وكل كلمة ولفظة في كتابة هذا التاريخ تعطي فكرة عن مرجعية محددة وموقف معين. وهذا تحديد أساسي في هذه الورقة لأنه يجعل الفكر التاريخي منطلقا في تناول الرواية ودراستها، والإحاطة ببنيتها المفاهيمية والتاريخية التي كانت أساس التخييل، وتم عبرها قراءة الواقع-المرجع مفتتح القرن العشرين. وهنا يصير التصور التاريخي قادرا على تفسير أشكال ورود الأحداث والشخصيات والمفاهيم وكيفية بنائها وتركيبها في العمل الروائي المستند إلى التاريخ كمادة مصدرية للتخييل.
وهنا يأتي المفهوم الثاني: التخييل، يدل هذا الأخير على تناص حقيقي مبني على تمثل الأحداث التاريخية انطلاقا من مراجع ومصادر خاصة، ثم إعمال الإبداع والبناء الروائي، وتشكيل شخوص روائية قد تتماهى وتتطابق مع الشخصيات الحقيقية وقد لا يتحقق فيها ذلك. كما قد يبقى النص الروائي وفيا لها أو يتجاوزها إلى شخصيات متخيلة، وهنا يقع الانفصال المنهجي في عمل الروائي في علاقته بالتاريخ، كمرجع كمحدد والتخييل كفضاء خاص بالروائي، منفتح ومتعدد وربما لا محدود، ونلج مجال الإبداع والفنية الأدبية والسردية. ويصير، بهذا المعنى، التخييل” الوجه المقابل للواقع(التاريخي) والمضاد له”[6].
فيما يرتبط المفهوم الثالث وهو الهوية بسؤال الهدف والغاية، وأقصد أن الاستعانة بالتاريخ، وممارسة التخييل على ضوئه، كان بهدف تحقيق هدف أساسي وهو ما يمكن نعته بالإمساك بهوية يعضدها التاريخ بأحداثه ووقائعه، في مسار غابت أو توارت فيه، في زمن يظهر من الرواية، أنه كان زمن وصاية وسيطرة وفي الآن نفسه زمن انتقالي نحو التحرر والاستقلال والولادة الجديدة. وبالتالي فقد تولد عنه رفض لما هو قائم، ورغبة في استرجاع “المبادرة” المفقودة قبل ذلك التاريخ، وهنا ترتبط الهوية بالقومية التي تحاول الرواية، كما يأتي، الإحاطة بانبعاثها، وبوجهتها نحو التحرر وإعادة بناء ذاتها التاريخية. وترتبط الهوية أيضا بالامتداد والاستمرارية التاريخية في مظاهر وبنى متعددة اجتماعية وثقافية وتاريخية. أو هكذا تريد الرواية التنصيص والتأكيد عليه.
رابعا: أشكال وصيغ حضور التاريخ في النص الروائي
- الشرق ومداراته:
انطلاقا من عتبة العنوان يمكن اعتبار توظيف نبيل سليمان لفظ “مدارات” إحالة على الجدلية والتداخل والرغبة في الخروج من وضعية ما، ويمكن اعتبار الكلمة تحيل على الصعوبة والتحديات، لأن المدار يجعلنا في كل مرة نعيد المرور من الطريق نفسه، فكيف الخروج والتحرر والانعتاق؟، وربط هذه المدارات بالشرق، يوضح أكثر النقطة السابقة، إذ يمكن أن تُظهر لنا أن الشرق من خلال المرحلة المتطرق لها، يحاول الانعتاق والخروج من وضعية الهيمنة والسيطرة، ومن وضعية “الضياع والفراغ”. والأكيد أن توظيف الشرق ، يقابله ضمنيا الغرب، وهو ما تبينه طبيعة المرحلة التي شهدت صراعا كبير بين الشرق والغرب في إطار السياق الإمبريالي والهجمة الاستعمارية لدوله على الشرق بعد انهيار السلطة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى (1914- 1918). وكان الأتراك العثمانيون في مقدمة الصراع المذكور. إذ صور الروائي أن العرب كانوا في صراع مزدوج مع الأتراك الراحلين ومع الإمبرياليات الغربية القادمة والمصرة على الاستعمار وتقاسم البلاد العربية فيما بينها.
- العرب وتركيا:
حضر ذكر الأتراك في النص الروائي مرادفا لكل ما هو سلبي ومرفوض من طرف فئة عريضة من السوريين. وبرز ذلك في الرواية من خلال: (الجحيم، الشماتة…) ووفق ثنائيات تحيل عليه، أي الجانب السلبي، بشكل مباشر وغير مباشر؛ (المترحل، المخرب، المستبد.). تقول الرواية في هذا الاتجاه:” والزمن يحفر بصمة ويمضي، يعلن اليوم، أو أمس، رحيل من خلفوها خرابة.. مثل من سبق رحل الأتراك إذن تلاحقهم أصداء مبهمة” (ص. 7).
نجد نبيل سليمان، يوظف بشكل مهيمن في نصه الروائي، لفظ “الأتراك”، عوض العثمانيين، الكلمة الأكثر تاريخية. وقد يصير توظيف هذا اللفظ نابعا من وعي لدى الروائي بالتحولات الحاصلة في السلطنة العثمانية المحتضرة[7] (نهاية الحرب العظمى الأولى 1918-1919). والتي فقدت آنذاك زخمها وحضورها “العثماني” التاريخي، وصارت مرتبطة بالأتراك المؤسسين للسلطنة، وهو رد فعل، ربما، على سياسة “التتريك” وبروز النزعة التركية في آخر عهد الإمبراطورية العثمانية وتغيير تعاملها وسلوكها تجاه العرب. ولعّل هذا مما يوحي بالوعي التاريخي في الرواية وعند الروائي، طبعا عبر تأسيس خطابه على المتون التاريخية (المراجع والمصادر). وبالرغم من ورود ” السلطان” في أكثر من سياق داخل النص، فإن صفة “الأتراك” ظلت مهيمنة في النص الروائي وبني عليها سرد الأحداث (الصفحات: 7، 19، 21، 22، 29، 44، 58، 63، 72، 103). يقول الروائي في هذا الاتجاه: ” ذلك أمر وما نحن فيه أمر آخر، كانوا عثمانيين ولم يكونوا أتراكا يومذاك” (ص. 355).
ليس من البعيد أن يكون واقع العلاقات السورية-التركية آنذاك (مرحلة الثمانينيات)، أيضا، دافعا نحو بناء صورة أقرب إلى السلبية لتركيا والأتراك. وإن كانت في تاريخيتها مرتبطة بسلوكات جاءت في مجملها ضد العرب، خصوصا في المرحلة التي تطرق لها النص الروائي وما قبلها أي في المجمل خلال الربع الأول من القرن 20. فكانت العلاقة تبعا لذلك منبنية على الصدام والرفض، واعتبار الأتراك مسؤولين عن واقع سوريا آنذاك المتسم بالقهر والظلم. ولم ترسم الرواية هذا الواقع الخاص بالعلاقة مع الأتراك فقط، بل امتد خطابها إلى الفرنسيين والإنجليز.
- الغرب والعرب (سوريا الكبرى):
تمثل الغرب في النص الروائي بشكل كبير في فرنسا وبريطانيا الإمبريالتين، في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى (1918). وكان الروائي يعود بالزمن قليلا؛ عند ذكره للاتفاقيات الأوربية والتقسيم الاستعماري للمشرق العربي وضمنه سوريا الكبرى.
كانت فرنسا مثالا للدولة الإمبريالية التي تسعى إلى استعمار البلاد السورية، لتصير” سوريا تنحني لنير جديد“. هذه الإمبريالية التي تسعى إلى “تقسيم البلاد”، والعمل على إذكاء النزعة الانقسامية وتوسيع الاختلافات الإثنية والمذهبية لسوريا الكبرى. وفي هذا الاتجاه تقول الرواية:” بدأ الفرنسيون يقذفون شهبهم ويقصون أوصالها وأطرافها، يسعون كي ينتزعوها من خد الدنيا، وهي شامتها الباقية” (ص. 483)[8].
ركز الروائي على فكرة اختلاف تمثل العلاقة لدى السوريين مع الغرب (فرنسا وانجلترا)، إذ يؤكد على لسان أحد شخصيات الرواية أن لفرنسا دورا مهما في مجمل الأحداث، قبل الحرب وأثناءها، وفي خضم “الثورة الكبرى”. يقول:” فنصف المدارس والطلاب كانوا في الشام لفرنسا قبل الحرب، وجل الذين قاوموا السلطان إنما تربوا على يد المبشرين الفرنسيين، حتى من يعارض فرنسا الآن، وهي لازالت على السواحل” (ص. 103). ويظهر النص أن السوريين اختلفوا حول الحضور والدور الفرنسي، في المرحلة قبل نهاية العثمانية وخلال “الثورة الكبرى”، وبعدها أيضا. شأنها شأن بريطانيا، فيما دفعوا باتجاه مقاومة الأتراك العثمانيين، لكن سلوكهم تغير بعد انكشاف النزوع الإمبريالي لكل من الفرنسين والإنجليز. وسقوط وهم “الدولة العربية الموحدة” التي روجت لها بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى. ومن الضروري التأكيد على خصوصية الوضع الديني والإثني داخل سوريا الكبرى، الذي كان عاملا في اختلاف التصورات الشعبية. وهو ما سعى الروائي إلى رصده عبر حواريات طويلة بين شخوص الرواية. هذا الوضع نفسه هو الذي كان أساسا لبث الانقسام والتفرقة في سورية الكبرى خلال هذه المرحلة من طرف الاستعمار الفرنسي.
ينتقل نبيل سليمان في الاتجاه نفسه، لرسم مشهد تركيبي للشام التي صارت سورية بفعل الاستعمار الغربي: ” إنها غير الشام التي عرف في ذلك الدهر المنصرم، وهو لم يتعود أن يناديها سوريا” (ص. 103). ليرصد التحول الكبير الذي شهدته: ” هذه الشام كانت الشام وكانت سورية، واليوم يراد لها أن تكون سوريا وحسب. هذه السورية التي لم يترك منها الإنجليز والفرنسيون غير القليل. الساحل أخذه الفرنسيون، والإنجليز أخذوا الشرق، وفلسطين تلعب عليها عين اليهود. صارت الشام أصغر من يد سليم أفندي، صارت تضيق به كما يضيق بها” (ص. 104).
رسم نبيل سليمان صورا للمقاومة الشعبية للسيطرة الاستعمارية والتقسيم المفروض على البلاد، من خلال تصويره للفعل الاحتجاجي الشعبي. يقول بوصفه السارد: ” كانوا آلافا مؤلفة أمام أوتيل فكتوريا يهتفون… الطرابيش والكوفيات تتطاير سكرى، الاكتاف تلتهب والحناجر تنشق. إنه واحد من تلك الأيام القادمة التي تحدث عنها العم حاتم، عالما علم اليقين أن قومة الشعب وشيكة منتصرة. هكذا جرى في فرنسا من عشرات السنين، هكذا جرى بالأمس القريب في روسيا، وهكذا يجري في كل أرض يفسدها الظالمون” (ص. 78).
تظهر هذه الفقرة تركيز الروائي على “الجماهير” وعلى فعلها المقاوم الشعبي، وتتضح رؤيته وتأطيره للحدث من خلال مقارنته مع ما حدث في فرنسا منذ عشرات السنين، ولعله يقصد الثورة الفرنسية 1789، ويزداد الأمر وضوحا عندما يتحدث في الاتجاه نفسه عن الثورة الروسية التي قادها “البلاشفة” سنة 1917. باعتبارها قامت أساسا ضد الإمبريالية وكل ما يتصل بها داخليا. لقد كانت التجربة الروسية والاتحاد السوفياتي المنبثق عنها حاضرا كمقابل للإمبريالية. جاء على لسان أحد شخصيات الرواية: ” من يقف معنا أهلا وسهلا.. على الأقل لم نر من الروس ما يسوء، لا حين كانوا قياصرة ولا حين صاروا بلاشفة” (ص. 355).
- صورة المجتمع
برزت في النص الروائي صورتان متعارضتان للعناصر المكونة للمجتمع السوري بشكل عام، ويمكن رصد وتصنيف ذلك من خلال فئتين أساسيتين، كما وردتا في الرواية: الفلاحون: وهم رمز الصمود والممانعة، والتشبث بالأرض، ومقاومة التمدد والتوسع الغربي واليهودي. وفئة الأعيان والبورجوازية، وظهرت في الرواية كرمز للتخاذل والصمت والتواطئ، وحصلوا على الأراضي وتقاسموا الترواث، كما ظهرت في الفترة المعنية بورجوازية وطنية مقاومة.
اختلفت العلاقة مع المحتلين، في النص الروائي بين “البرجوزاية ” و”الفلاحين”. بين تقبل وتعايش، بل واستفادة الفئة الأولى، وبين رفض وامتناع، وضياع حقوق الفئة الثانية. وهو ما ظلت الرواية توضحه، في مختلف أقسامها. عبر صيغ حوارية، ومواقف تعطي صورة للمجتمع حسب منظور الروائي، بنخبته “المتواطئة” و”العميلة” و”الخائنة”[9]، وبين العامة وباقي الفئات الشعبية الرافضة والمحتجة على القهر والظلم والاستغلال المزدوج، الخارجي والداخلي. كما أعطى الروائي مساحة في النص للبرجوزاية الوطنية الاستقلالية التي تبنت موقفا وطنيا ومقاوما. ولا مناص من التشديد هنا، على مرجعية الروائي اليسارية والماركسية في صياغة هذه المعادلة الاجتماعية لسوريا إن صحّ الوصف، بما أن البلاد كانت خاضعة للأفكار القومية، بأبعاد ماركسية معادية للغرب وللإمبريالية والرأسمالية.
تدل على الفكرة السابقة مسألة حضور المظاهرات الشعبية والرفض والمقاومة التي حفل بها لنص، وصورها الروائي عبر حواراته. فقد “عكست رواية مدارات الشرق فنيا أشكال متنوعة من مقاومة الشعب السوري للاحتلال الفرنسي وعملائه الداخليين. وشدّ الروائي ذلك كله إلى جوهر الأحداث التاريخية وبنية الواقع الاجتماعي”[10].
لكن الملاحظ في نص هذه المساهمة وهو جزء “الأشرعة” هو غياب الاسم التاريخي سواء على مستوى الشخصيات الفاعلة أو الأحداث التاريخية الكبرى. واكتفى الروائي “بتصوير الأجزاء العامة والخاصة التي حركت الشخصيات أو تحركت فيها، وبتصوير أشكال المقاومة الشعبية والرسمية من خلال تطوير الحدث الروائي ورصد تأثير الأحداث التاريخية في مصير شخصيات أو شخوص الرواية”[11].
خامسا: تيمة الهوية بين التخييل والتاريخ
يؤكد درس التاريخ أن الهوية كتمثل للخصوصية والانتماء والثقافة المشتركة والجمعية، أو الشعور بها وتنامي خطابها، يشتد ويتقوى بالاحتكاك بالآخر، وتصير آلية دفاعية ومظهرا للمقاومة عندما يبدي ذلك الآخر نزوعا نحو الهيمنة والسيطرة. فتشعر الذات أنها مهددة في وجودها، وثقافتها وجذورها بكل أبعادهما، ويصير السياق في هذا الاتجاه محددا بروز الهوية. إذ إن ما يعيشه المجتمع الخاضع للاستعمار أو المهدد بالخضوع له كحال سوريا في زمن الرواية يعبئ كل ما في إمكانه لإبداء رد فعل، وبتعدد هذا الأخير تترسخ أبعاد الهوية، ويصير كل ما يعبر عن الذات أساسا لها. وفي المقابل يتقوى رفض ما دونها وما يغايرها وخصوصا القادم من المستعمر أو ما يحيل عليه..
انبنت الهوية والقومية في الرواية انطلاقا من رصد نوعية العلاقة مع الأتراك، المتغيرة آنذاك، إذ برز الموقف المناهض للأتراك أكثر من الموقف المؤيد لهم (ص. 7). وكان هذا الموقف منطلقا لإحياء الشعور الوطني، ومحاولة لرسم الخصوصية العربية-السورية وتحديد الهوية القومية[12]. ومن المعلوم أن هذه الأخير تتقوى في مراحل الأزمات والصراع ضد الأجنبي والمحتل. وتتولد انطلاقا من التمايز عنه ومقاومته كما ذكر أعلاه.
كان توظيف “رحيل الأتراك” في النص الروائي معبرا عن نهاية الوجود “العثماني” التاريخي بأرض سورية وبداية الإحساس والشعور بالرغبة الفعلية والعملية في التحرر، فقد كانت سوريا مركزا رئيسيا للنهضة خلال القرن التاسع عشر (ص. 49). فلم تكن فكرة البعد والرغبة في الانعتاق من سيطرة العثمانيين والأتراك وليدة زمن الرواية. وربما الفرق هو أن القرن 19 ارتبط، على المستوى التاريخي، بالنخبة والنهضويين والإصلاحيين، وفي الرواية تم التركيز على الفئات الشعبية في إذكاء الروح الوطنية ومواجهة الأجانب وفي مقدمتهم الأتراك. تصرح الرواية أن الموقف السابق هو ” دلالة على الروح الشعبية أو الرغبة التي تولدت عند السوريين في تلك الفترة، إذ إنها مأخوذة مباشرة من أفواه الناس، وقد كانت مستخدمة آنذاك في مناطق عديدة في سورية“[13].
رسم نبيل سليمان مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى كواقع تسوده المعاناة والظلم والاستبداد في “سورية الكبرى“، عانت فيه فئة الفلاحين من تسلط الولاة، ومن تآمر الإقطاعيين وأعوانهم. فسلبت الأراضي واستعبد الضعفاء من الفلاحين، وشردت عائلاتهم، بل وقتل منهم عدد كبير حسب الرواية. “إذ كان ثمة أسر مرمية أمام أبواب بيوتها، وأطفال يبكون وشفاه مزرقة ترتجف، جمال وبغال، وكومات صغيرة من الثياب والأشياء المعدودة، لقد فرض على أولئك أن يرحلوا إلى مكان ما” (ص.32).
لقد ظهرت سوريا، في النص الروائي، وخلال مرحلة ما بعد الحرب المذكورة مضطربة، يسودها الصراع بين الفرنسيين والإنجليز واليهود. فيما تحاول هي (سوريا)، ككيان سياسي ناشئ، الخروج من سيطرة الأتراك وتسلط ممثليهم. وترسم الرواية، في هذا الاتجاه، ما يمكن نعته بمخاضات تشكل الهوية الوطنية أو القومية السورية، من خلال ردود الفعل الشعبية على ذلك الواقع، والتي ركز عليها الروائي بشكل أكبر عبر آلية الحوار التي طغت بين شخوص الرواية. إذ أراد الروائي من خلالها التـأكيد والتشديد على أن الوعي الشعبي في سورية كان أساسا لتشكل الهوية الوطنية والقومية السورية، وإبداء لرد فعل تجاه الإمبريالية الغربية، والمتعاونين معها. ولعّل هذا الموقف يرتبط لدى الروائي بالانتصار “للجماهير” والطبقات الشعبية، بخلفية ومرجعية ماركسية.
يؤكد نبيل سليمان على فكرة قيام السوريين ونهوضهم لتحقيق الوجود وبناء القومية السورية في بعدها التاريخي المرتبط بالشام؛ “فالشام ينبغي لها أن تنهض، ليس لها إلا أن تنهض أو تموت، ولا يكفي منها تلك الشرارات التي تتطاير هنا وهناك” (ص.352).
يتمايز خطاب الرواية حول الهوية، إذ جعلها مرتبطة وملتصقة بالفئات الشعبية، عن المتون التاريخية المتناولة للقضية نفسها، إذ تركز هذه الأخيرة على أدوار النخبة والفعل الحزبي وعلى الشخصيات الوطنية. “فالكتلة الوطنية التي تشكلت في هذه المرحلة جمعت العائلات الكبرى في المدن السورية: دمشق، حلب، حمص، حماه. ومن أهم شخصياتها: شكري القوتلي، ناظم القدسي، فايز الخوري”[14]. ولعل هذه النقطة تبين ” مجهرية الخطاب الروائي” وتركيزه وحفره في تفاصيل وجزئيات من الواقع المتخيل عند الروائي، انسجاما مع أهدفه الروائية، التي تأتي موزاية للتاريخ المعهود، ومجسدة للرؤية السردية الروائية ببعدها الفني والتخييلي.
سادسا: الخلفية الروائية في النظر إلى أحداث التاريخ: المرجعية والخطاب
اشتغل نبيل سليمان على عدد كبير المصادر والمراجع تتناول في مجملها تاريخ سوريا الكبرى، كي يستطيع “الحفر في التاريخ روائيا” كما يصرح بذلك. وقد ظهر من خلال الفقرات الأخيرة أعلاه أن الرواية اصبغت بشكل كبير بالمرجعية الماركسية، والتي هي الخلفية الفكرية للكاتب والناقد نبيل سليمان في إطار ما وصفناه أعلاه بـ ” الجدل التاريخي”. وما يوضح هذا الأمر هو قائمة الوثائق المراجع والمصادر التي تم التخييل على ضوئها. إذ كانت متنوعة بين التاريخي، والسياسي، والأدبي، والاقتصادي. وطغا عليه التوجه الماركسي من خلال العناوين وأسماء الكتاب والمؤلفين[15].
يدقق نبيل سليمان ويحصر تأثير أحدها وهو كتاب ” تاريخ الفلاحين في سورية وعلاقته بالأحداث السياسية”[16]، والذي أحدث تأثيرا كبيرا في الروائي وفي صياغة فكرة الرواية[17]. وجعله يستمر في البحث والاطلاع عبر دراسات ومؤلفات أخرى، بل إنه اعتمد بشكل كثيف على الرواية الشفهية أو الذاكرة الفردية، ولعل هذا ما جعل آلية الحوار تطغى على بنية النص الروائي.
إن هذا المسار البنائي و “المنهجي” في التحضير للرواية والعمل الروائي في نص “مدارات الشرق-الأشرعة”، يعطي الدليل على التقاطع مع التاريخ[18]. ويدل على بعدها وخلفيتها التاريخية. أركز في هذا الاتجاه على كيفية وطريقة جمع المعلومات وبناء الأفكار والأحداث من مصادر خاصة ومتنوعة، ومن الشهادات الشفوية[19]. يقترب هنا منهج بناء العمل والاشتغال في النص الروائي من طريقة كتابة التاريخ المعاصرة.
يصير نص ” مدارات الشرق” وثيقة تاريخية تمنح صورة عن المجتمع والناس حسب صاحبه. انطلاقا من كيفية بناء تلك الصورة، التي سعت إلى التماهي مع التاريخ، وفق ما يسميه نبيل سليمان ” حفريات روائية في التاريخ“. الذي من خلاله يفرق بين نمطين من الرواية ذات البعد التاريخي أو التخييلي؛ نمط تقليدي تشير إليه روايات جرجي زيدان، وصفة التقليدية تأتيه حسب ما يؤكد نبيل سليمان من غلبة سرد التاريخ في مقابل التصور الذاتي للروائي. فيما النمط الثاني هو المبني على ” الحفر الروائي” والتعمق والإحاطة بالتاريخ دون البقاء في “سجنه” أو “أسره”، عبر الخروج بالتاريخ إلى مساحات أخرى “تنتصر للمهمشين والهامشيين“، وتسجل حضورهم في مسار التاريخ. بناء على فكرة وتصور يظلان حاضرين باستمرار عند الروائيين، وهما قضية “ملأ بياضات التاريخ“، ومسألة “الخروج من شرنقة التاريخ الرسمي“. تتأسس الفكرة السابقة على تمثل معين وخاص بالأدباء والروائيين والنقاد للتاريخ، إذ ينطلق الروائيون من مسلمة “مطابقة الماضي” في يتعلق بالبحث التاريخي، ويجعلون منه أساسا للاختلاف مع “الرواية” التي تميل إلى التخيل والتخييل. وبالتالي إلى الحرية والفنية والتحرر من أسر الوثيقة والتاريخ الرسمي.
خلاصة
تعد رواية مدارات الشرق بناء على ما تم الوقوف عنده في هذه الورقة، محاولة في رصد مرحلة تأسيس سوريا ككيان سياسي مستقل، إذ تطرقت لسؤال النشأة والأسس، بمخاضاتهما السياسية والاجتماعية والتاريخية: الداخلية بين مكونات البلاد التي تجسدت في الفئات الشعبية المختلفة وفي الأعيان والملاك الكبار وغيرهم، والخارجية من خلال الصراع مع الاستعمار الغربي المتمثل بالخصوص في الاستعمارين الإنجليزي والفرنسي، والتهديد اليهودي-الصهيوني لجزء من سورية الكبرى آنذاك وهو فلسطين.
أدىّ التخييل في النص الروائي إلى “اختزال فني-سردي ” للحدث التاريخي، وإلى تحويره، وإعادة تشكيله “فنيا”، عبر التخييل. وبواسطته هذا الأخير تخلص الروائي ونصه من “صرامة ” الأحداث التاريخية المعهودة، وثقل واقعيتها وقيودها بتعبير الروائيين والأدباء. وهنا وقع الانفصال بين النص الروائي والتاريخ البحثي، بل ومعارضته كما ذكرنا ذلك في بداية هذه الورقة، في تعريفها للتخييل. إذ يؤدي هذا الأخير إلى بروز التناقض بين الرواية كنص أدبي وبين التاريخ ككتابة بحثية.
عمل نبيل سليمان، بشكل كثيف على تذويب الحدث التاريخي في بنية سردية محكمة، وفي قصص وحوارات موسعة جدا، يكاد يختفي فيها، أو لا يكاد يظهر فيها بالأحرى، التاريخ المعهود المباشر. كان اعتماد ” التورية” والابتعاد الفني أي على مستوى الصياغة الألوبية، وبكل الطرق السردية الممكنة، عن التعابير والمصطلحات والألفاظ التاريخية والشخصيات المعلومة والمعروفة، وذلك من خلال جعل شخوص الرواية تتحدث عن التاريخ كمعيش كحاضر وراهن، تتفاعل معه مباشرة، من حيث هي تعيشه ويؤثر فيها، عبر آلية أساسية ومهيمنة وهي الحوار. وهنا تجسيد الروائي للتاريخ كما أرادهK عبر تصوير “درامي” للأحداث، منح لها الحياة، ليتحقق فيها ما أكد عليه جورج لوكاش من “الراهنية” أو “الحاضرية” عبر الأسئلة الملحة في واقع الروائي، ثم جعل القارئ يعيش ذلك التاريخ، بالإضافة إلى إضفاء الحياة الشاعرية على ما هو تاريخي واجتماعي في النص الروائي.
ولابّد من التشديد على أن حدود هذا النص والعمل الروائي إبداعية فنية عموما، وهي تكمل التاريخ في هذه المستويات، كما نجد لذلك وقعا من خلال السينما والمسرح. أما مسألة ملأ البياضات فأظنها تأتي في هذا الاتجاه وضمن هاته الحدود أي الحدود الفنية والإبداعية. كما أن المؤرخ لا يحسن به، في الجانب المقابل، محاكمة الإبداع الأدبي بالتاريخ المحض، التاريخ البحثي و “العلمي” ذي القواعد العلمية. فإنّ الروائي لا يجدر به اعتبار التاريخ قاصرا أو عاجزا عن الإحاطة بالعناصر كافة المشكلة لمشهد تاريخي ما، أو اعتباره، أي التاريخ، خاضعا للرسمي. لأنه حقل بحثي وعلمي له أسسه المنهجية الخاضعة لقواعد محددة.
إن البحث التاريخي مرتبط بالأسس المنهجية التي تميزه كحقل علمي وبحثي، ومقيد بالمتوفر من الوثائق والشواهد، مع توسيع الدائرة والمنظور عبر الانفتاح والاستشكال والبعد المفاهيمي. فقد سعى الباحثون في التاريخ إلى التجديد وفق هذا السياق على مستوى الكتابة والأسلوب وأيضا في مستوى التيمات والمواضيع كما بيّنا ذلك في المدخل أعلاه. بل إنّ دعوات كثيرة برزت مؤخرا لتخصيب التاريخ بالبعد السردي والأدبي[20].
لم تسع الورقة إلى مقارنة ما ورد بالرواية مع المصادر أو المراجع التي تطرقت إلى المرحلة. ولم تكن أهدافها تكمن في البحث على المطابقة أو الصدقية، بل كان هدفها هو معرفة أشكال الحضور التاريخي في الرواية، ورصد تمظهراته الأدبية من خلال خطاب الرواية. وكيف عبر النص الروائي عن أبعاد المرحلة. وكيفية تشكيل وبناء الأحداث التاريخية، ورسم الشخصيات والفاعلين وطبيعتهم. من دون أن نسقط على النص الروائي “التأطير” التاريخي البحثي. وحاولت الورقة أيضا توضيح مرجعيات بعض المفاهيم والمطلحات وخليفات توظيفها ودلالتها الروائية.
ولابد، في ختام هذا النقاش الخاص بالتناهج والتقاطع المعرفي، من التأكيد على أن البحث التاريخي المعاصر لا ينشد الحقيقة ولا يبتغي الموضوعية المطلقة والحقيقة التامة، بل إنهما غير قابلتين للتحقق، بما أن صور التاريخ متعددة ومتغيرة ومتجددة باستمرار، بتغير الإشكاليات والأسئلة، وبروز وثائق ومعطيات جديدة، و”مختلفة باختلاف وجهة نظر كل مؤرخ“[21]. ويمكن أن نضيف أن التاريخ مال منذ مدة طويلة، مع المدرسة الفرنسية السابقة الذكر، ومع تيار “التاريخ الجديد” وتحولاته المنهجية والمعرفية، إلى البحث في الوجود الهامشي، وفي رصد حضور المبعدين والمقصيين؛ فظهر تاريخ الجنون والموت والثوار، وتاريخ السجون، والأطعمة واللباس، وبرز التأريخ للرمزيات والماديات بعيدا عن البلاطات والقادة والزعماء والتاريخ الفوقي والرسمي[22]. وبالتالي، أقول من موقع الباحث في التاريخ، أن الرواية لا تملأ لوحدها بياضات التاريخ، بل يمكن اعتبارها مساهمة في ذلك، عبر الحرية المطلقة التي يتمتع بها الروائي والتي هي ميزة كبرى له، والتي تبق في حدود الإنتاج الأدبي أو التي يلزم أن تبقى في حدود ذلك. وإن أهم ما يستفيد منه المؤرخ في هذا الجانب أي في التناص الحاصل، بين تخصصه والأدب، هو انفتاح تفكيره وجرأته على طرح أسئلة جديدة، بفعل احتكاكه وانفتاحه على المنجز الروائي ولامحدودية تصوراته، في طرح الأسئلة، وفي الحكم على الفاعلين التاريخيين وأدوارهم في مسار المجتمع. كما يمكن أن يفتح نقاش منهجي حول الإمكانيات التي يتيحها السرد في تخصيب وتطوير العمل التاريخي أسلوبيا وفي توسيع دائرته وانتشاره على مستوى القراءة والتلقي، مع الحفاظ على طابعه العلمي، وخصوصيته البحثية.
الهوامش:
[1] ظهرت مدرسة الحوليات في بداية النصف الأول من القرن العشرين بفرنسا، وتأسس منبرها الرئيسي ” مجلة الحوليات ” les Annales) ) سنة 1929 على يد كل من لوسيان فيفر Lucien Febvre “ ” ومارك بلوك Marc Bloch “ “، اللذان سيعملان على إحداث ثورة منهجية ثانية بعد تلك التي أحدثتها المدرسة المنهجية ، وتجلى ذلك في تهميش التاريخ الحدثي (Histoire événementiel) ونبد التاريخ – السردي /الإخباري، القائم على دراسة الوقائع السياسية البسيطة في الأزمنة القصيرة، والانتقال إلى دراسـة تاريـخ البـنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيتم توضيح برنامج هذا الاتجاه في كتاب لوسيان فيفر1878-1956 ” دفاعا عن التاريخ ” (Combats pour l’histoire) والكتاب الغير المكتمل لمارك بلوك 1886-1944 ” مهنة المؤرخ ” (Métier d’historien) ، وسيتحقق البرنامج في أبهى صوره في كتاب فرنان برودل (1902-1972 Fernand Braudel : ” البحر المتوسط والعالم المتوسطي على عهد فيليب الثاني ” (La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II)
[2] نبيل سليمان، مدارات الشرق- الأشرعة، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، الطبعة الثانية، 1994.
[3] تم اقتباس هذا المنظور المنهجي من داخل حقل الأدب نفسه، إذ من المعلوم أن منهج تحليل الخطاب” امتد إلى حقل التاريخ. يقول سعيد يطين موضحا هذا الاتجاه المنهجي: ” موضوع “تحليل الخطاب الروائي” كما يدل عليه عنوانه ليس الرواية، ولكن الخطاب. وليس الخطاب غير الطريقة التي تقدم بها المادة الحكائية في الرواية. قد تكون المادة الحكائية واحدة، لكن ما يتغير هو الخطاب في محاولته كتابتها ونظمها”. أنظر: سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي: الزمن- السرد- التبئير، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1989، ص. 7.
[4] محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين، تونس، الطبعة الأولى، 2010، ص. 175.
[5] مدرات الشرق (الأشرعة)، 1990، مدارات الشرق (بنات نعش) 1990، مدارات الشرق (التيجان) 1993، مدارات الشرق (الشقائق) 1993.
[6] محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، مرجع سابق، ص. 74.
[7] يصف الروائي بعد ذلك على لسان أحد شخوص الرواية ب “السلطنة المرحومة“. الرواية، ص.103. آهي المرحلة النهائية “للرجل المريض”؟
[8] وهذه الفكرة متثبتة تاريخيا، لكن ورودها بهذه الصيغة الأدبية يعطيها تأثيرا كبيرا. نقارن هذه الفكرة مع صيغة مماثلة لها عند سمير أمين، يقول: “لقد جرى تقسيم البلاد بصورة جد مصطنعة عام 1919 بين فرنسا وانجلترا“. سمير أمين، الأمة العربية، القومية وصراع الطبقات، ترجمة كميل قيصر داغر، دار ابن رشد للطباعة والنشر، 1978، ص. 76.
[9] نجد نفس العبارات والأوصاف تقريبا عند المرجعية الماركسية التي تتتاول بالبحث والدراسة هذه المرحلة من تاريخ سوريا. يقول سمير أمين في هذا السياق” تظهر حالة سوريا كيف أن الاندماج في النظام الأسمالي العالمي منذ عام 1920 وحتى عام 1955، أعطى البرجوازية المحلية إمكانية النمو إلى حد ما، كيف أن هذا الدمج شّكل برجوازية وطنية عميلة وتابعة. باكتفائها على هذا المنوال، نفهم بصورة أفضل كيف ولماذا أمكن لسوريا، وهي مركز حي للعروبة عام 1919، أن تغفو خمسة وثلاثين عام في إقليميتها”. سمير أمين، الأمة العربية القومية وصراع الطبقات، مرجع سابق، ص. 67.
[10] محمد عادل عرب، المعالجة الفنية للتاريخ، مرجع سابق، ص، 54.
[11] نفسه.
[12] يعتبر سمير أمين في هذا الاتجاه أن ” السيطرة العثمانية في الهلال الخصيب قد حافظت على وحدة المنطقة حتى عام 1919، وأنها لم تكن أي تلك السيطرة حماية فعالة ضد النفاذ (pénétration) الإمبريالي” ويعزو سمير أميين ذلك إلى دخولها في مرحلة التخلف والتفكك، ثم الانهيار. وما يهم هنا هو أن الوحدة التي استقرت لمدة طويلة تحت سلطة العثمانية صارت متجاوزة كما يصورها الروائي. والتي جسدتها “الثورة العربية الكبرى“. إحياء للقومية العربية. أنظر: سمير أمين، الأمة العربية، القومية وصراع الطبقات، مرجع سابق، ص. 64.
[13] محمد عادل عرب، المعالجة الفنية للتاريخ، دراسة في مدارات الشرق، دار الحوار، اللاذقية، 1994، ص. 18.
[14] سمير أمين، الأمة العربية القومية وصراع الطبقات، مرجع سابق، ص. 76.
[15] بلغت البيبليوغرافيا التي تم التخييل على ضوئها في رواية مدارات الشرق (211). إذ توصل الباحث المذكور إلى هذه الفكرة عبر مقابلة مع الروائي نبيل سليمان. أنظر محمد عادل عرب، المعالجة الفنية للتاريخ، مرجع سابق، صص. 119-125.
[16] عبد الله حنا، تاريخ الفلاحين في سورية وعلاقته بالأحداث السياسية، الجزء الأول: المسألة الزراعية والتحركات الفلاحية في بلاد الشام في العصر العثماني، ليفانت للدراسات الثقافية، الإسكندرية، 2022.
[17] نبيل سليمان، من يشهد على من: الرواية، أم الكاتب، أم القارئ؟، مجموعة من المؤلفين، ملتقى الروائيين العرب الأول (شهادات ودراسات)، دار الحوار، دمشق، الطبعة الأولى، 1993، ص. 173.
[18] يستحضر هنا نقاش كثيرا ما ذكر على لسان الأدباء والروائيين، حول جدوى الكتابات التاريخية ومدى إحاطتها بمختلف الفاعلين، ودرجة البياضات التي يتركها، والتي يقول الروائيين أن نصوصهم تملئها. ينم هذا الطرح عن قصور واضح في فهم آليات اشتعال الباحث في التاريخ، ومختلف التجديدات المنهجية والموضوعاتية التي شهدها حقل التاريخ في القرن العشرين.
[19] أدّىّ الاعتماد القوي على الذاكرة الشفوية الشعبية إلى بروز غنى على مستوى الحوار داخل النص الروائي. وهو ما يلمس من درجة التعمق في طرح الأفكار والتوسع فيها عند شخوص الرواية.
[20] Patrick Boucheron, Ce que peut l’histoire, Edtion du seuil, serie Histoire, Paris, 2020, p. 50.
[21] Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, op, cit p.231.
[22] فرنان برودل: التاريخ والعلوم الاجتماعية، ترجمة مصطفى كمال، ضمن ملف فرنان بروديل والتاريخ الجديد، مجلة بيت الحكمة، الدار البيضاء، ع 5، السنة الثانية، أبريل 1987، ص.23.
البيبليوغرافيا
- إدريس الخضراوي، سرديات الأمة تخييل التاريخ وثقافة الذاكرة في الرواية المغربية المعاصرة، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2017.
- سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي (الزمن-السرد-التبئير)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1989.
- عبد االله العروي، مفهوم التاريخ، الجزء الأول، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 1997.
- علي أدهم، تاريخ التاريخ، مصر، القاهرة، دار المعارف،1977.
- محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين المستقلين، تونس، الطبعة الأولى، 2010،
- محمد حبيدة، الكتابة التاريخية: التاريخ والعلوم الاجتماعية، التاريخ والذاكرة، تاريخ العقليات، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2015
- محمد عادل عرب، المعالجة الفنية للتاريخ، دراسة في مدارات الشرق، دار الحوار، اللاذقية، الطبعة الأولى، 1994.
- محمد مندور، الأدب ومذاهبه، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 1979.
- سمير أمين، الأمة العربية، القومية وصراع الطبقات، ترجمة كميل قيصر داغر، دار ابن رشد للطباعة والنشر، 1978
- ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار الأمان، الطبعة الثانية، الرباط، 1987.
- نبيل سليمان، مدارات الشرق- الأشرعة، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، الطبعة الثانية، 1994.
- نبيل سليمان، وعي الذات ووعي العالم، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، الطبعة الأولى، 1985.
- المقالات:
- فرنان برودل: التاريخ والعلوم الاجتماعية، ترجمة مصطفى كمال، ضمن ملف فرنان بروديل والتاريخ الجديد، مجلة بيت الحكمة، الدار البيضاء، ع 5، السنة الثانية، أبريل 1987.
- لطفي بوشنتوف، الأدب الديني مصدرا لتاريخ المغرب الحديث، مجلة البحث التاريخي، عدد خاص مزدوج 7و8، خمسون سنة من البحث التاريخي في المغرب، الرباط، 2009- 2010.
- نبيل سليمان، من يشهد على من: الرواية، أم الكاتب، أم القارئ؟، مجموعة من المؤلفين، ملتقى الروائيين العرب الأول (شهادات ودراسات)، دار الحوار، دمشق، الطبعة الأولى، 1993.
- يوسف الزيات، “سؤال التاريخ والتخييل في رواية العلامة لبنسالم حميش”، دفاتر الدكتوراه، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، الدار البيضاء، العدد10، 2021.
- Henri-irénée Marrou, De la Connaissance historique, quatrième édition revue et augmentée, éditions du seuil, paris, 1964.
- Roland Barthes, Wolfgang Kayser, Wayne C. Booth, Philippe Hamon, poétique du récit, Edition du seuil, série points Anthropologie science humaines, paris, 1977.
- Patrick Boucheron, Ce que peut l’histoire, Edtion du seuil, serie Histoire, Paris, 2020.
 رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه
رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه