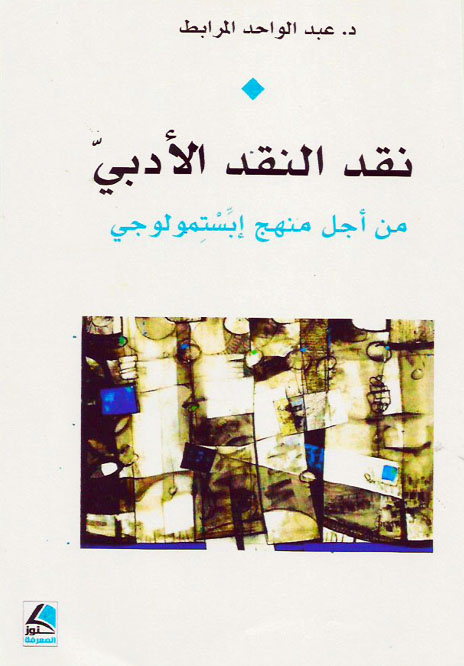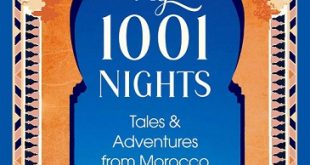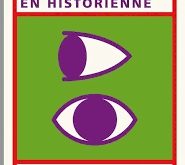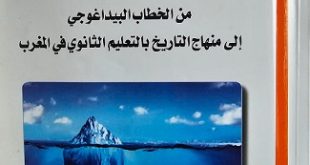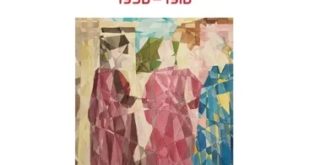د. عبد الواحد المرابط، نقد النقد الأدبي: من أجل منهج إبستمولوجي، نشر دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، 2025.
للتنظير لنقد النقد حضور متميز في ساحة النقد الأدبي المغربي الحديث تجسده مؤلفات رائدة ألفها جامعيون مغاربة في موضوعه، ويتوالى نشرها تباعًا منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم. وهي مؤلفات تنظر لنقد النقد محددة مفهومه وإجراءاته. وبعضها يقف عند حدود التنظير، ويجمع بعضها الآخر بين التنظير والتطبيق؛ ومن هذه المؤلفات نذكر مؤلفات حميد الحمداني، سحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي في الرواية والشعر، الطبعة الأولى (1990)، والثانية مزيدة ومنقحة 2014)، وبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي (1991)، والنقد النفسي المعاصر تطبيقاته في مجال السرد (1991)، والنقد التاريخي في الأدب رؤية جديدة (1999)، ونقد النقد والنظريات الأدبية والنقدية. المعرفة والسلطة (2022)، وكتاب محمد الدغمومي نقد النقد وتنظير النقد العربي (1999). وكتاب عبد الحكيم الشندودي، نقد النقد حدود المعرفة النقدية (2016). وكتابي عبد الرحمن التمارة، نقد النقد بين التصور المنهجي والإنجاز النصي (2017)، ونقد النقد الأدبي بين الدينامية والإنتاجية والفاعلية (2023). وقد عزز الجامعيون المغاربة هذه التآليف بترجمة دراسة مرجعية أساسية في نقد النقد كتبتها جوهانا ناطالي، وقد أنجز الترجمة محمد مساعدي وقدم لها ونشرها بعنوان: “التحليل الشعري وآليات دراسته، حول التحليلات النقدية لقطط بودلير“، سنة 2020. ودعم الجامعيون هذا الاتجاه من جهة أخرى بمجموع مقالات محكمة تتمحور حول نقد النقد وتعمق الوعي النقدي به نشرها “فريق البحث في الدراسات السردية والثقافية للكلية المتعددة التخصصات بالراشدية”، سنة 2020، بعنوان: النقد الأدبي الحديث: النظرية وإنتاج المعرفة، وبتنسيق الدكتورين محمد بوعزة وعبد الرحمن التمارة. وآخر ما نشر الأكاديميون المغاربة من مؤلفات في مباحث نقد النقد كتاب عبد الواحد المرابط: نقد النقد الأدبي: من أجل منهج إبستمولوجي، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، (2025).
وعبد الواحد المرابط أستاذ جامعي باحث في النقد الأدبي الحديث ومناهجه، ومن منشوراته كتاب، السيمياء العامة وسيمياء الأدب: من اجل تصور شامل (2000). وكتاب، المنهج التاريخي في النقد الأدبي الحديث (2022). وقد أولى أهمية كبرى للببليوغرافيا الأدبية المغربية وأصدر سنة 2010 كتاب، الدراسات الأدبية المغربية الحديثة: مداخل ببليوغرافية من بداية المطبعة إلى سنة 2008. وبعده طبع كتاب، الترجمات المغربية للدراسات الأدبية: مدخل ببليوغرافي 1971 – 2011). وكتب العديد من المقالات النقدية في منشورات عدة جامعات مغربية.
أما كتابه، نقد النقد الأدبي: من أجل منهج إبستمولوجي، فتتوزع صفحاته المئتين والثلاثين مقدمة في ست صفحات كتبها الدكتور محمد مساعدي، وثلاثة فصول في مائة وتسعين صفحة بمعدل حوالي ستين صفحة لكل فصل. وأولها فصل نظري وثانيها وثالثها فصلان تطبيقيان، وتليها خاتمة وخلاصة مركزة لمباحث الكتاب ونتائجها في ثلاث عشرة صفحة، وينتهي الكتاب بلائحة للمراجع تستغرق عشر صفحات.
وفي مقدمة الكتاب عرض مركز لمضمونه والأسس الإبستيمولوجية التي تقوم عليها صنافة نقد النقد التي يقترحها، وما تميزت به من تطوير لصنافات نقد النقد الرائجة في النقد العربي، وتنويه بما حققه تجريب تطبيقها في الكتاب من تأكيد لفعاليتها النقدية. وفي فصل الكتاب الأول تحليل للأسس المعرفية والأدبية لنقد النقد وتحديد لمقومات ومكونات ومستويات الصنافة التي يقترحها لممارسة نقد النقد. وفي الفصل الثاني تطبيقها على كتاب، الخطيئة والتكفير، لعبد الله الغذامي. والفصل الثالث تطبيق ثان لها على كتاب، الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، لكمال أبو ديب. ويفصح بيان لتوزيع صفحات الكتاب، ما تتميز به بنيته من تماثل كمي بين الفصول، كما تفصح لائحة مراجع الكتاب بتعدادها ووفرتها وتنوعها عن الخلفية النظرية الصلبة التي يقوم الكتاب، كما يظهر كشف مضامين فصوله، ماله من تكامل وظيفي بين النظري والتطبيقي. وفي هذا وذاك حضور قوي لخبرة جيدة في تأليف الكتب وراء إخراج هذا الكتاب.
وتنتهي مراجعتنا لذلك القسم النظري إلى تسجيل ملاحظتين: أولاهما أن مباحثه تحلل نقد النقد من منظور علميته، أو قل إنها تكشف مواصفات وشروط البحث العلمي في ممارسته، وتحاول تكريسها في أصوله النظرية وإجراءاته العملية. والملاحظة الثانية أن تجميع فقرات هذا القسم، وإعادة توزيعها على محاور رئيسية يبرز ثلاثة محاور وهي: محور مفهوم النقد الأدبي أولًا، ومفهوم نقد النقد ثانيًا، ومحور صنافة النقد وإجراءاتها ثالثًا.
أولاً: في مستهل محور مفهوم النقد الأدبي، وضح عبد الواحد المرابط أهمية وضرورة تحديد مفهوم النقد الأدبي للتمييز بينه وبين نقد النقد. وبعد استعراضه الكثير من تعريفات النقد الأدبي التي يقترحها العديد من النقاد والدارسين خلص إلى قوله “سيبقى الطابع الإشكالي ملازمًا لمفهوم النقد بسبب ما يخضع له من تطور وتحول من جهة، وبسبب ما يتوزعه من منظورات واتجاهات ومذاهب من جهة أخرى”. (ص 19) وفي محاولته لتحديد ذلك المفهوم عمل بالمتداول في تعريفات النقد من مقابلة النقد بالأدب وتبنى التعريف القائل: “إنه خطاب حول خطاب، إنه لغة ثانية أو لغة واصفة تشتغل بلغة أولى هي اللغة – الموضوع”. واستخلص من تعريفات الأدب المتباينة أنها “تشير إلى مهام ثلاث يضطلع بها النقد بدرجات متفاوتة فتشكل أبعاده الرئيسية، وهي البعد الذاتي، والبعد التاريخي، والبعد العلمي.” (ص. 21). وهذه المهام التي تشكل في رأي عبد الواحد المرابط الخصائص المميزة والفارقة للنقد الأدبي، يمكن أن نقدمها بعبارات أخرى وبلغة مصطلحية، وعلى التوالي: بالموضوعية في النقد الأدبي أولًا، وخارجيات النصوص في النقد الأدبي ثانيًا، والمنهج في النقد الأدبي ثالثًا.
1 – وفي تحديد البعد الذاتي في النقد الأدبي قال عبد الواحد المرابط: “إن كل عمل نقدي يتضمن قدرًا من التقمص الذاتي الذي يخالط الأدب المدروس أو يداخله أو يتلبس به، ويتمثل ذلك في ما يبديه الناقد من انطباعات أو أحكام جمالية صادرة عن ذوقه الخاص… ويتعلق الأمر بعناصر ذاتية تتسرب إلى خطاب الناقد، وتتسرب معها ثقافته واختياراته وآراؤه وتقديراته ومواقفه، فيبدو لقارئه كما لو أنه يتحدث عن نفسه من خلال الأدب الذي يدرسه، حيث يسجل ما انطبع في ذاته وما وقر في وجدانه.” (ص21)
ولتعميق تحليل تلك الذاتية قدم عبد الواحد المرابط عرضًا لآراء نقاد تأثريين وانطباعيين وموضوعاتيين عرب وغربيين قدماء ومحدثين وناقشها. ولاحظ أن تتبع مسار النقد الأدبي التاريخي يظهر أن النزعات الذاتية فيه تقابلها وتعارضها وتتصدى لها أخرى موضوعية. وأن تيارات ومناهج النقد الأدبي الحديث تعلي شأن الموضوعية وتضعف الذاتية في ممارساتها النقدية.
وانتهى العرض بتقديم خلاصة مفادها “أن الأمر يتعلق ببعد أساسي كان يحضر في الممارسة النقدية منذ القديم، ولا يزال يفرض حضوره بشكل أو بآخر في أعمال العديد من النقاد، بل إن طائفة من الباحثين كانوا ولا يزالون يستبعدون وجود النقد الأدبي في غياب ذوق الناقد وتقديراته الذاتية. ومما لا شك فيه أن انطباعات الناقد في حد ذاتها، سواء كانت طفيفة أم وافرة، لا تفيد في تحقيق علمية النقد، بل إنها تؤثر سلبًا في بنائه الحجاجي وكفاءته المنهجية وإنتاجيته المعرفية، ما لم تصغ في بناء حجاجي متماسك يضفي عليها قوة إقناعية، لكنها في مقابل ذلك تدعم علاقة الأدب بالقارئ، وتستبقي ذلك الحبل السري الدال على العلاقة التوليدية بين النقد والأدب.” (ص. 34-35)
وتعليقًا على هذه التحليلات، يمكن القول إن الارتقاء بمناقشة الذاتية في النقد الأدبي إلى المستوى الإبستمولوجي ينبغي أن يستحضر إشكالية الذاتية والموضوعية في العلوم الإنسانية، وباعتبار أن تطور النقد الأدبي يتجه نحو علمنته، وهي علمنة قابلة لدراسة إبستمولوجية على غرار “علم التاريخ”، والذي طالما وصف بأنه فن وليس بعلم، وينبغي أن يستحضر كذلك أن الإبستمولوجيين يعتقدون اليوم أنه “لم يعد علماء المناهج يشترطون تحقيق الفصل التام بين الذات والموضوع لاستحالة الفصل بين شيئين بينهما علاقة متبادلة تربطهما وتدمجهما في وحدة معرفية، لا تمايز فيها بين ذات وموضوع، ولم تعد الموضوعية تعني انعكاسًا لواقعة أصلية، بل تعني شروطًا يلتزم بها الباحث تقضي في ما يقوله بوانكاري بأن يكون ما يقرره على نحو موضوعي مشتركًا بينه وبين الآخرين، ومن الممكن نقله إلى أي فرد، وأن يكون قابلًا لأن يقاس وأن يصاغ في علاقات ونظريات ومعادلات رياضية، إن أمكن. ولم تعد غيابًا تامًا لعوامل التحيز أو تخليًا عن كل حكم، ما دامت تنطوي على اتخاذ موقف وإصدار حكم يلتزم بالموضوع المحكوم عليه، ويعبر عن علاقة بين الباحث الذي يصدر الحكم ومحتوى حكمه، أي ما يقرره عن موضوع الحكم.”[1] وبناء على معطيات علوم المناهج وأصول النقد الأدبي والدراسات السيكولوجية للذوق الفني، فالذاتية في الممارسات النقدية هي تمظهرات لقيم جمالية وأخلاقية، أو معتقدات إيديولوجية، ويحد النقد من هيمنتها بتأسيس ممارسته على فروض علمية يمكن تعميم نتائجها واعتماد إجراءات تقوم على الوصف والتفسير والتحليل والتركيب العلمي.[2] ولم يعد الذوق بفضل الدراسات السيكولوجية (قضية لا تناقش)، بل أصبح ظاهرة خاضعة للتفسير العلمي، والتمييز فيها بين ما هو فردي خاص وجماعي عام ومجتمعي أو إنساني، وحامل لتأثيرات الزمان والمكان والجنس، وفاعل في عمليات تلقي الأدب والرسم والموسيقى وغيرها من الفنون.[3]
2 – البعد التاريخي، وهو في رأي عبد الواحد المرابط الإطار الزمني أو المرجع السياقي الخاص أو العام لفعل تاريخي، والذي “يسمح بفهمه أو تفسيره أو إضاءته”، وهو “بعد أساسي يتخلل الممارسة النقدية …ويتمثل في ربط الموضوع الأدبي المدروس، سواء أ كان نصًا أم ظاهرة أم قضية بسياق قائم أو مفترض يكون عبارة عن مرحلة تاريخية أو اتجاه أدبي أو مدرسة فنية أو قضايا اجتماعية أو نفسية أو سياق ذهني أو نفسي أو منظومة فكرية محددة فلسفيًا وزمنيًا، حيث يكون الناقد بذلك قد وظف الأدب توظيفًا تاريخيًا وفق التزامات فكرية أو رؤى إيديولوجية واضحة أو مضمرة، واعية أو غير واعية.” (ص 35 – 36 بتصرف)
ويلاحظ عبد الواحد المرابط أن “هذا البعد التاريخي – مثله مثل البعد الذاتي – قد يتضاءل فيختزل في مجرد إشارات زمنية يقتضيها عادة تقديم الأدب المدروس إلى القارئ حيث يتم التعريف بمؤلفه وتاريخ ظهوره، وقد يهيمن حين يمعن الناقد في تفسير ذلك الأدب اعتمادًا على شروط تاريخية أو اجتماعية أو نفسية أو فلسفية، حيث يربطه – في جميع هذه الحالات – بسياق مرجعي يلعب فيه الزمن الدور الأول، وفي كلتا الحالتين يضطلع النقد بمهمة إدراج الأدب في الزمن، وربطه بسياق تاريخي خاص أو عام ، إنه بشكل أو بآخر يضطلع بتقديم القيم الأدبية للمجتمع والتاريخ. ويظهر هذا البعد التاريخي بشكل واضح ومباشر عند أصحاب المناهج الاجتماعية والنفسية، فضلًا عن أصحاب المنهج التاريخي، حيث يتضافر التحليل الأدبي مع تحليل شروط وجود الأدب المدروس وملابساته الزمنية.” (ص. 38 – 39)
وتعقيبا على هذا التحليل، نرى أن وجود علاقات بين العمل الأدبي وخارجياته من مسلمات النقد الأدبي الحديث ومرتكزاته، والسؤال الأهم هنا، ومن منظور نقد النقد، هو: كيف يوظف النقد الأدبي هذه العلاقة في تحليل الأعمال الأدبية؟ وفي جواب أولي عن هذا السؤال، يمكن القول – وبغض النظر عن تعدد المناهج النقدية الحديثة واختلافاتها – إن الممارسات النقدية تحدد آليات هذه العلاقة بطريقة من ثلاث طرق تتجلى في مضمون الأدب وشكله، وهي الانعكاس المرآتي لخارجيات الأدب فيه أولًا، والتفاعل بين الأدب وخارجياته ثانيًا، وتأطير الأدب بخارجياته حيث تمهد خارجيات الأدب لتحليل الأدب، ولا يمتد التحليل إلى دراسة الانعكاس أو التفاعل بينهما ثالثًا. وهذه العلاقات وطرائق تقديمها في الممارسة النقدية تطرح على نقد النقد مراجعة مصداقية الاستدلال عند التعامل مع النص الأدبي كوثيقة تاريخية. وكذا دقة وملاءمة المفاهيم السوسيولوجية والسيكولوجية المرجعية في دراسات طريقتي الانعكاس والتفاعل.
3 – أما البعد العلمي للنقد الأدبي، وحسب عبد الواحد المرابط، “فيتجلى في مختلف العمليات المنهجية الرامية إلى تحويل المعطيات الأدبية النصية إلى مقولات نظرية، أو إلى استعمال تلك المقولات في إضاءة تلك المعطيات النصية. فالناقد قد ينطلق من النص إلى العلم أو من العلم إلى النص، وقد يتحرك في الاتجاهين معًا. وفي الحالتين يبنى جسرًا بين الأدب بصفته إبداعًا من جهة، وبين العلم بصفته تصورات ومقولات وقوانين وقواعد وتصنيفات ومبادئ نظرية من جهة أخرى. فالناقد يربط النص الأدبي بالعلم سواء بالانتقال صعودًا من خصوصيات ذلك النص إلى عموميات الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه، أم بالانتقال نزولًا من مقولات الجنس إلى مظاهر النص المدروس في سياق الشرح والتفسير والتأويل. ويتعلق الأمر بممارسة نقدية ذات منحى تنظيري قد يسوق مجموع عمل الناقد نحو بناء المقولات العامة، وقد ينحصر في بعض جوانبه فيتفاعل مع بعديه الآخرين الذاتي والتاريخي. في الحالة الأولى نكون أمام ناقد مسلح بأدوات التجريد والتقعيد يروم إنشاء نظرية أدبية تستوعب النص المدروس، وتتعداه إلى نصوص أخرى ذات مقومات أدبية مشابهة، وفي الحالة الثانية نكون أمام ناقد ذاتي أو تاريخي لا يستطيع أن يستغني عن الحد الأدنى من الأدوات المنهجية التي تضفي على عمله طابعًا علميا مهمًا كان بسيطًا أو جزئيًا، وذلك لأسباب تواصلية تقتضيها ضرورات الوضوح ومتطلبات الإقناع”. وبناء على هذا الواقع يكون “للبعد العلمي في الأعمال النقدية درجات متفاوتة، فقد تتقلص إلى حدود دنيا تتجسد في مظاهر علمية بسيطة كتقسيم الناقد لعمله إلى مقدمة وأقسام وفصول مثلًا، وقد يكون مهيمنًا فيبلغ درجات قصوى حد التماهي بين النقد والتنظير العلمي.” (ص. 41 – 42)
وتتعزز علمية الممارسة النقدية باعتماد مناهج نقدية لها مفاهيمها ومصطلحاتها وإجراءاتها “وتتسع المناهج والمفاهيم لتشمل عناصر أخرى تغني البعد العلمي للنقد، منها التعريفات، والتحديدات، والتقسيمات، والتفريعات وتقديم الأمثلة، والأمثلة المضادة، وتقطيع الموضوع إلى أجزاء، واستخدام لغة واضحة شفافة، وتوثيق النصوص والمعلومات والآراء، وغير ذلك من أدوات الخطاب العلمي.” (ص. 56)
ولاحظ عبد الواحد المرابط “أن العمل النقدي حتى وإن لم يكن عملًا نقديًا علميًا كاملًا، فهو يتضمن آليات الخطاب العلمي ويستخدمها ليقدم نتائج واضحة، انطلاقًا من مقدمات أو فرضيات، وعبر خطوات منهجية ومفاهيم مجردة. لذلك يمكن دائما إخضاع النقد لفحص (Vérification) إبستمولوجي يقيس درجة علميته، ويتبين مدى إفادته لعلم الأدب أو استفادته منه.” (ص. 57) وبهذا نتجاوز معيار الصلاحية (Validité) أو احتمال الصدق “الذي يطرح مشاكل على صعيد العلوم الطبيعية والحقة نفسها، فبالأحرى في العلوم الإنسانية والنقد الأدبي تحديدا.” (ص. 53)
وإغناء لهذا التحليل بمزيد من التوضيح للبعد العلمي في النقد الأدبي يمكن أن نقول إن الممارسات النقدية في النقد الأدبي العربي الحديث تفرز نموذجين رئيسيين هما: نموذج النقد المنهجي الذي يعتمد منهجًا نقديًا جاهزًا وسابقًا على الممارسة النقدية، وله جهازه النظري وتطبيقاته العملية، كالمنهج التاريخي، والمنهج النفسي، والمنهج البنيوي. وفي مستوى نقد النقد يثير هذا النموذج النقدي عند تطبيقه لمنهج من تلك المناهج إشكالية جوهرية تتجلى في التعديلات التي يحدثها الناقد العربي في مصطلحات ومفاهيم وإجراءات المنهج الأصل، والتي تفرض التساؤل: هل نحن أمام تحريف ناتج عن سوء الفهم أو تجاوز اختاره الناقد بوعي في إطار المنهج التكاملي الحاضر بقوة في الأعمال النقدية العربية الحديثة.
والنموذج الثاني، نقد منهجي يعتمد أدوات البحث العلمي وإجراءاته كالإحصاء، والعينات، والفرضيات، والمقارنات، والرسوم البيانية، والذي له أصوله وقواعده المتداولة في كتب مناهج البحث العلمي والتي تؤطر مناهج البحث في العلوم الإنسانية، ويمكن أن تسند علمنة النقد الأدبي.”[4] ونمثل لتطبيق هذا المنهج، وعلى سبيل التوضيح بكتاب “خصائص الأسلوب في الشوقيات، لمحمد الهادي الطرابلسي”، وكتاب الشعرية العربية، لجمال الدين بن الشيخ”، وكتابي سعد مصلوح: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، وفي النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية.”[5] وهذا النموذج وعلى مستوى نقد النقد بقدر ما يدعم علمنة النقد لقيامه على أرضية علمية صلبة[6] بقدر ما يثير التساؤل حول مدى توفيقه في خدمة أدبية النص.
ثانيًا: وفي محور مفهوم نقد النقد حدد عبد الواحد المرابط موضوع نقد النقد وحلل وظائفه قائلًا “إذا كان نقد النقد الأدبي خطابًا حول الأدب، فإن نقد النقد خطاب حول النقد ذاته، أي خطاب ميتا نقدي موضوعه النقد وليس الأدب، ولذلك فهو لغة من الدرجة الثالثة. فالنقد هو الجسر الذي تعبره علاقات النص الأدبي بكل من الأدب والتاريخ والعلم، أما نقد النقد فهو الذي يفحص طبيعة هذه العلاقة ويراجعها ويقويها، فهو بدوره مبحث نقدي، غير أن موضوعه الحقيقي ليس هو الأدب وإنما النقد الأدبي. وحتى لا يقع تداخل بين هذه المستويات يحتاج نقد النقد أيضًا إلى وضع مسافة بينه وبين موضوعه (النقد)، سواء على صعيد الأهداف أم المنهج أم المفاهيم، كما يحتاج إلى تصور معرفي ومنهجي يضمن له حدًا معقولًا من الملاءمة العلمية والوضوح المنهجي، وينأى به عن مطبات الخلط والغموض السائدين في معظم ما يكتب حواليه.” (ص. 58 -59) ولا اعتراض “على أن يكون ناقد النقد شاملًا يدرس العمل النقدي في جميع مستوياته الأدبية والفكرية والمنهجية، رغم أن في ذلك خلطًا لمنظورات متباينة”، وشريطة الحرص على ضرورة التمييز بين حدود تدخل النقد ونقد النقد. وينهض نقد النقد بثلاث وظائف “يضطلع بها مجتمعة أو متفرقة، وهي وظيفة حوارية، ووظيفة تاريخية، ووظيفة إيبستمولوجية.” (ص. 62)
1 – الوظيفة الحوارية، وفيها يجمع ناقد النقد بين “الممارسة النقدية والممارسة الميتا نقدية، وتجعل ناقد النقد مهتمًا بالعلاقة بين النص الأدبي وبين الناقد فيتحرك بينهما بصفته قارئًا جديدًا، أي، ناقدًا ثانيًا للناقد الأول في ضوء النص الأدبي المدروس.” ومن تجليات هذه الوظيفة الحوارية لنقد النقد تلك “التعقيبات” و”التعليقات” التي يصدرها مبدعون تجاه أعمال نقدية درست إبداعاتهم الأدبية. ولاحظ عبد الواحد المرابط أن نقد النقد في مستوى هذه الوظيفة هي “أقل أشكال نقد النقد علمية وأكثرها قربًا من النقد الأدبي، وذلك لأنه يكاد يتحول إلى نقد مباشر للأدب، مع أن موضوعه الأساسي هو النقد الأدبي.” وأن المتحمسين لاستقلالية نقد النقد يدعون ناقده “إلى عدم اقترابه من النصوص الأدبية المدروسة إلا لغايات تقنية يتطلبها اختبار صحة كلام الناقد بصددها، بل ويدعون أيضًا إلى ابتعاد ناقد النقد عن استعمال مناهج النقد الأدبي لأنها مرصودة لدراسة الأدب، وغير مستوفية لشروط دراسة النقد، والتي هي شروط إبستيمولوجية لمعرفة المعرفة.” (ص. 63 -64) ولاحظ كذلك أن شيوع هذه الطريقة يرد إلى اعتقاد بعض نقاد النقد أن “من مهام الدراسة الميتا نقدية محاورة العمل الأدبي انطلاقًا من النص الأدبي المدروس فيه.” (ص. 66) وقرر أخيرًا أنها وظيفة من وظائف نقد النقد “قليلة الفائدة من الناحية الإبستمولوجية.” (ص. 66)
2 – الوظيفة التأريخية، و”تتجلى عندما يضع ناقد النقد العمل النقدي المدروس في إطار فكري أو إيديولوجي محدد ضمن حقبة تاريخية معينة، حيث تتم مناقشة التوجه الفكري للناقد أو رؤيته للعالم، وبالتالي يتم وضعه ضمن المسار الثقافي والتاريخي الذي ينخرط فيه، فناقد النقد هنا وبهذه الوظيفة التأريخية يقف بين العمل النقدي من جهة، وبين تاريخ النقد من جهة أخرى.” (ص, 66)
3 – الوظيفة الإبستمولوجة، و”تكمن في التركيز على الجانب العلمي والنظري للعمل النقدي حيث يتم فحص المناهج والمفاهيم المستعملة من قبل الناقد للوقوف على الطريقة التي ينتقل بها هذا الأخير من القراءة البسيطة إلى القراءة العالمة للنص أو للموضوع المدروس، فهذه الاستجابة تجعل ناقد النقد يضع نصب عينيه البناء العلمي للعمل النقدي، فيرصد فيه المرجعيات النظرية، والمنهجية، والمفاهيم، وعمليات البرهنة والخطوات، وغير ذلك من أدوات الخطاب العلمي، ولذلك فهو يقف بين العمل النقدي من جهة، وبين الإبستمولوجي من جهة أخرى.” (ص. 67)
وينهي عبد الواحد المرابط التعريف بهذه الوظائف بملاحظتين: أولاهما أن هذه الوظائف تحضر جميعها في العمل النقدي بطريقة أو بأخرى، وتكون إحداها مهيمنة عليه. والثانية أن الوظائف المهيمنة في الأعمال النقدية مبدأ لتصنيفها في مجموعات مختلفة.
وتعليقًا على هذا التحديد لمفهوم نقد النقد في موازاة النقد الأدبي بحصر موضوعه ومجاله ووظائفه أو بالأحرى مهامه، يمكن القول إنه تحديد سيكون تحديدًا متكاملًا إذا تعزز بكشف وتوضيح أهداف نقد النقد، والتي نجملها هنا وباختصار في تطوير النقد الأدبي العربي الحديث، وتأصيل المناهج الوافدة عليه، وفتح آفاق التنظير فيه، وذلك بمراجعات مستمرة لتراكم منجزاته التاريخية.
ثالثًا: واستهل عبد الواحد المرابط محور صنافة نقد النقد، أو ما يسميه بمستويات التحليل، بقوله: إن وظيفة نقد النقد الإبستمولوجية تجعله “يركز على البناء العلمي في العمل النقدي وسبل دراسته، لذلك نستوحي استراتيجية إبستمولوجية مرنة ودينامية وفعالة نراها مناسبة للنقد الأدبي بما أنه لا يمثل العلم أو يدعيه بقدر ما يتجه نحوه ويسعى إليه. تسمى هذه الاستراتيجية “الكشافة” (Heuristique)، وهي استراتيجية اقترحها فيلسوف العلم إيمري لاكاتوس (Imre Lakatos)تمكننا من النظر إلى العمل النقدي بصفته “برنامج بحث علمي” فيه ما فيه من مقومات العلم، وفيه ما ينزاح به عن تحقيق العلمية. إنها كشافة تفحص المنطلقات والمراحل والنتائج دون أن تقصي أو تعدل، وإنما تبحث فقط عما يقوي تلك المنطلقات أو عما ينقضها، ولذلك فهي ذات حدين: كشافة إيجابية، تثمن مظاهر القوة في البناء العلمي، وكشافة سلبية، ترصد جوانب النقص والخلل في هذا البناء.” (ص. 70)
وانطلاقًا من اعتبار البعد العلمي أساس نقد النقد ومقاييسه الإبستيمولوجية، ناقش مقياس اختبار الصلاحية (la Validation) “الذي يبدو في العلوم الإنسانية إشكاليًا في الغالب، لكونه يتطلب المواجهة بين المعطى التجريبي والنظرية. فإجراءات اختبار الصلاحية قد تتضمن صحة الاستدلال وعمليات البرهنة، لكنها لا تضمن صحة النتائج.” ودعا إلى تجاوزه وتبني اختبار الصحة (la Vérification) “حيث لا نواجه العمل النقدي بالنص المدروس ولا بنصوص أدبية أخرى، ولا بما قاله نقاد آخرون حول هذا النص، ولا حتى بقراءتنا الخاصة له، وإنما نعقد مواجهة كاشفة بين أهداف الناقد ومنطلقاته ومستنداته النظرية وعملياته النقدية ونتائجه، وذلك من خلال خطوات متدرجة ومنتظمة … وبذلك يكون مقياس اختبار الصحة بالمعنى الذي حددناه هو المقياس العام الناظم للدراسة الميتا نقدية في وظيفتها الإبستيمولوجية، والذي تتحقق به ومن خلاله الكشافة الإيجابية والكشافة السلبية.” (ص. 72-73)
وعزز عبد الواحد المرابط “اختبار الصحة” بمقاييس مساعدة ضابطة لمدى علمية العمل النقدي، “منها مقياس “النسقية” و “الانسجام” و”الاتساق” و”الوضوح”، وحيث نتساءل عما في العمل النقدي من تسلسل وتدرج وتنظيم وتناسق بين مكوناته ومستوياته، كما نتساءل عن مدى دقة اللغة الواصفة للناقد ووضوح تصوراته وتصريحاته في كل مستوى من مستويات العمل النقدي.” (ص. 73)
وتعقيبا على إحلال اختبار الصحة محل اختبار الصلاحية وتعليقه لإجراء مواجهة العمل النقدي بنصه الأدبي أو بآراء نقاد آخرين فيه، ينبغي أن نوضح موقع وأهمية التجربة في العلوم الدقيقة والمطلوبة في العلوم الإنسانية. فالبحث العلمي في العلوم الدقيقة يتدرج من الملاحظة إلى اقتراح الفرضية، ثم من الفرضية إلى التجربة، والتجربة هي التي تمتحن صلاحية الفرضية وتنتهي بإقرارها قانونًا علميًا أو فرضية متجاوزة. أما في العلوم الإنسانية كعلمي الاجتماع والنفس، فالتجربة المخبرية متعذرة لأسباب متعددة، ولكن هذا الواقع لا يمنع من إجراء تجارب علمية بمواصفات خاصة تلائم طبيعة العلوم الإنسانية، وكما أقرت ذلك مباحث الإبستمولوجيا. وهكذا أصبحت الملاحظة الميدانية المعززة باستبيانات استكشافية في علم النفس معادلة للتجربة المخبرية في البيولوجيا مثلًا. وأصبحت الوقائع التاريخية مجال اختبار الفرضيات التاريخية، حتى قيل إن التاريخ مختبر علم الاجتماع. وقياسًا على هذا يمكن القول إن معادل تجربة العلوم الدقيقة في مجال نقد الأعمال النقدية الأدبية هو المقارنة؛ مقارنة نتائج العمل النقدي بنظائره السابقة عليه أو اللاحقة له. وهذه المقارنة هي التي تكشف ما في العمل النقدي من اجترار أو ما قدمه من الإضافات العلمية في مستويات المنهج وتحديد مكونات أدبية النص، وهذه المقارنات هي التي تسعف في تحقيق ما وضحناه سلفًا من أهداف نقد النقد، وبدون هذا وذاك يصبح نقد النقد ترفًا عقليًا.
ولإجراء نقد النقد اقترح عبد الواحد المرابط تحليل مستويات معينة ومتنوعة ومختلفة ومتفاعلة في الأعمال النقدية، وحدد خطوات التحليل، والتي يرى أنها “ترسم مواقع تدخل ناقد النقد وخطواته على نحو من التدرج والتكامل” (ص. 74) كما يلي: 1 – أهداف الناقد 2 – الموضوع والمتن. 3 – المستندات النظرية والمنهجية. 4 – منطلقات الناقد. 5 – العمليات النقدية. 6 – النتائج. وعرف بمضمون كل مستوى من هذه المستويات، ووصف طرق اشتغال النقد فيه، وقدم بعض الملاحظات حول جوانب الضعف والقوة في تطبيقاته النقدية.
1 – وفي مستوى أهداف الناقد ردد عبد الواحد المرابط الآراء القائلة بأن الأهداف في العمل النقدي لا تخرج عن أن تكون “التعرف” أو “الفهم” أو “المعرفة” وضبط خصوصيات نص أدبي أو أعمال كاملة لكاتب أو جنس أدبي أو أدب قطر أو لغة ما، وهي أهداف قد يصرح بها أو يسكت عنها وقد تتجمع في هدف واحد أو تتعدد وتتباعد ولا يجمع بينها رابط، “وأحيانا يتحول اختيار الناقد للمنهج إلى هدف في حد ذاته مما يعطي لعمله طابعًا تجريبيًا يستدعي المناقشة والفحص.” ويبدأ ناقد النقد “دراسة العمل النقدي بالتساؤل عن هذا المكون الأساس، وذلك من حيث نوعه ومدى معقوليته(Plausibilité) ، [أي جدارته ظاهريًا بالتصديق] معتبرين أنه عمدة برنامج البحث العلمي المفترض في عمل الناقد. لذلك نعتمد المقاييس الإبستمولوجية لفحص أهداف الناقد ولتبين نوعيتها وطبيعتها ومدى اتساقها مع مستويات العمل النقدي الأخرى.” (ص. 75)
2 – وفي مستوى الموضوع والمتن عرف عبد الواحد المرابط الموضوع بأنه “هو الظاهرة أو الوقعة الأدبية التي يعمل الناقد على دراستها وفهمها”، أما المتن فهو المادة التي يدرس الموضوع من خلالها، وقد يكون متنًا واسعًا وشاملًا أو عينة مختارة … “وقد يتقلص موضوع الدراسة عند الناقد فيتطابق مع المتن، أو ينحصر في عناصر محددة داخل المتن … ولذلك نتساءل عن موضوع الناقد من حيث وضوحه …وسبب اختياره وعلاقته بالأهداف وبالمستويات الأخرى، كما نتساءل عن المتن وموقعه ضمن هذه الاعتبارات. ومن المفترض أن يختار الناقد متن الدراسة وفق مبدأ واضح، وباتساق مع الموضوع، والأهداف والمستويات الأخرى للعمل النقدي … وقد يلجأ الناقد إلى المقارنة وإلى التوسع في دراسة العينات والنماذج، غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون دون ضوابط واضحة لدى الناقد والدارس على حد السواء. ويسمح لنا تحليل هذا المستوى بالوقوف عند إحدى أهم الإشكاليات التي تثير علاقة النقد بالنظريات والمناهج وموقع النص ضمن تلك العلاقة.” (ص. 75 – 76)
3 – في مستوى المستندات النظرية، ويقصد بها عبد الواحد المرابط “المناهج والنظريات القائمة التي يعتمدها الناقد كخلفية معرفية أو منهجية، وتمثل هذه المستندات ما يسميه كارادان ”سياق التأويل” Contexte de l’interprétation لأنها تتشكل من مقولات خاصة بشخص أو مدرسة أو باتجاه ما، وتقدم نوعًا من الفهم المسبق Pré-compris للنص”. وهو يلاحظ أنها في النقد العربي الحديث غالبًا ما تكون جماع عدة معطيات نظرية ومفاهيم من النقد الغربي والتراث النقدي العربي. ويقول علينا في دراسة هذه المستندات أن “نفحص كيف تمثلها الناقد وكيف اعتمدها ووظفها، كما نفحص علاقتها بأهداف الناقد وموضوعه ومتنه، ثم نتبين كيفية استثمار هذه المستندات في مستوى التطبيق، أي داخل العمليات النقدية.” (ص. 76 -77)
4 – في مستوى منطلقات الناقد وصف عبد الواحد المرابط منطلقات الناقد بأنها “منطلقات أولية يستقيها من مستويات “الأهداف – الموضوع والمتن – المستندات النظرية”، وتتخذ هذه المنطلقات شكل فرضيات موجهة نحو الموضوع والمتن المدروسين لتعبر بهما أومن خلالهما نحو نتائج الدراسة النقدية، ولذلك فهي كما لاحظ كرانجر تقوم بدور وظيفي خلال مجموع العمل العلمي، لأنها تتطلب دائمًا تأكيدًا أو تعديلًا أو نفيًا”. وترد أهمية هذه المنطلقات إلى تموقعها المتوسط “بين قطبي العمل النقدي: القطب النظري الذي يشمل ما اختاره الناقد من أهداف وموضوعات ومتون وما اعتمده من مرجعيات ومقولات نظرية، والقطب العملي الذي يشمل الممارسة النقدية المباشرة للمتن، ولذلك فهذه المنطلقات هي ما يشكل صلب العمل النقدي ويرسم خصوصيته، أو على حد تعبير لاكاتوس “النواة الصلبة” في “برنامج البحث العلمي”، وبالتالي فينبغي أن تجتمع إليها كل المستويات السابقة بشكل يبرز خصوصية عمل الناقد، كما يجب من ناحية أخرى أن تؤطر كل العمليات النقدية اللاحقة وتتجه بها نحو النتائج المرتقبة أو المطلوبة.” (ص. 77 – 78)
ولاحظ عبد الوحد المرابط “من خلال استقراء لأعمال نقدية عربية كثيرة أن هذه المنطلقات تعبر عن نفسها في شكل مصادرات نظرية أو منهجية: فالمصادرات النظرية هي عبارة عن قوانين أو قواعد أو مقولات يتم التصريح بها بصفتها فرضيات تنتظم الموضوع والمتن المدروسين، أو بصفتها تأويلًا دلاليًا عامًا يشرح المتن أو يفسر في ضوئه، أما المصادرات المنهجية فهي خطط وسيناريوهات ذات خلفية علمية يسعى الناقد من خلالها إلى تطوير المقاربة النقدية من الناحية التقنية والإجرائية مع ربطها باتجاه منهجي جزئي أو كلي. ووجود هذه المصادرات ينحو بالعمل النقدي منحًى استنباطيًا حيث يتم توجيه الممارسة النقدية نحو الاستدلال على صحتها أو نحو تعديلها بشكل من الأشكال، غير أن طغيان المصادرات النظرية يدفع العمل النقدي في اتجاه التنظير، وطغيان المصادرات المنهجية يدفعه في اتجاه التجريب المنهجي.” (ص. 78)
وحدد عبد الواحد المرابط مهمة ناقد النقد في الوقوف “عند منطلقات الناقد لفحصها من حيث بناؤها الداخلي من جهة، ومن حيث علاقاتها بالأهداف، والموضوع، والمستندات من جهة ثانية، ثم من حيث مداها العلمي والعملي من جهة ثالثة، فمن شأن هذا الفحص الإبستمولوجي أن يضعنا في قلب المشروع النقدي للعمل المدروس.” (ص. 78)
5 – وفي مستويات العمليات النقدية يقول عبد الواحد المرابط: إن “العمليات النقدية هي محك العمل النقدي ككل، فهي المحفل الذي تحضر فيه جميع مستويات هذا العمل والجسر الذي يربط بين منطلقات الناقد ونتائجه، ولذلك فهي بالنسبة لنا الموضع المناسب لممارسة الكشافة بحديها الايجابي والسلبي. وتشبه العمليات النقدية ما يسميه كارادان عمليات البرهنة Opération de raisonnement التي تتم بها ومن خلالها الانتقال من المعطيات الأولية إلى الاقتراحات النهائية، أو هي الوسيلة التي تؤسس فهم النص وتنقل التحليل التأويلي إلى دائرة العلم،” وتتسلسل العمليات النقدية بتدرج أو حسب مكونات المتن. ويمكن لناقد النقد التمييز بين عملية وأخرى طبقًا لتفصيل العمل النقدي إلى أقسام ومحاور وفصول، ومع اعتبار “كل عملية نقدية مكونًا بنائيًا داخل العمل النقدي،” يقدم نتائج جزئية في إطار هدف البحث ومنطلقاته، “ولذلك من المفيد أن يتعامل ناقد النقد مع كل عملية بشكل مستقل في البداية ليستوفيها حقها من الفحص قبل أن يبحث علاقاتها بالعمليات النقدية الأخرى من جهة، وبباقي مستويات العمل النقدي المدروس من جهة أخرى.” (ص. 78 – 79)
6 – وفي مستوى نتائج العمل النقدي يعتبر عبد الواحد المرابط “أن معالجة هذا المستوى هي مناسبة لإعادة طرح جميع أسئلة المستويات السابقة في ضوء المقاييس الإبستمولوجية، لذلك يتساءل عما انتهى إليه عمل الناقد، وعن الخيوط المعرفية والمنهجية التي تربط بين جميع مستويات العمل النقدي لتوجيهها نحو نتائج تفترض أن تكون واضحة – وتساءل كذلك – هل نتائج العمليات النقدية في مجموعها هي ما يشكل النتائج العامة؟ ما علاقة هذه النتائج العامة بأهداف الناقد ومنطلقاته؟ وماذا قدمت هذه النتائج بخصوص الموضوع والمتن المدروس؟ هل يمكن – إجرائيًا – أن ننطلق من النتائج العامة ثم نرجع القهقرى إلى المراحل السابقة التي أفضت إلى تلك النتائج، أي إلى العمليات النقدية والمنطلقات والمستندات النظرية، والموضوع والمتن والأهداف؟ لا شك أن هذا عمل شاق، لكنه بالمقابل يعطينا فكرة دقيقة عن البناء العلمي للعمل النقدي المدروس.” (ص. 80) وأنهى عبد الواحد المرابط تقديم هذه المستويات بتسجيل التوضيحات الأربعة التالية:
1- إن تلك المستويات الستة “ترسم مواقع التدخل الإبستمولوجي الراصد للعمل النقدي في بعده العلمي. وهذا يعني أن هناك مستويات أخرى تسمح برصد مكونات أخرى تجسد الأبعاد الذاتية والتاريخية في الممارسة النقدية، وهي ما لا نركز عليه في هذه الدراسة الميتا نقدية.” (ص. 80)
2- إن التحليل الإبستمولوجي يضبط غياب مستوى من تلك المستويات أو حضوره الضمني في الأعمال النقدية و”يربط هذه الظاهرة بما يمكن أن تشكله من نقص أو خلل في البناء العلمي للعمل النقدي.” (ص. 80)
3- عند تداخل تلك المستويات على “التحليل الإبستمولوجي أن يتبينها وأن يميزها من بعضها، ولو بشكل إجرائي حتى يحيط بالعمل من جميع جوانبه العلمية.” (ص, 80 -81)
4- تجميع ملاحظات ومستنتجات وخلاصات تحليل المستويات الستة في الأعمال النقدية يكون في “مقاربة تركيبة تستجمع الملاحظات والنتائج الجزئية وتتجه نحو تقويم العمل النقدي ككل”، وتقوم المقاربة “الميتا نقدية على ثلاث مراحل هي: أولًا تقديم العمل المدروس من خلال معطياته الببليوغرافية، وثانيًا تحليل مستويات العمل النقدي. وثالثًا تركيب العمل النقدي وتقويمه في ضوء نتائج التحليل.” (ص. 81)
- وتأكيدًا لفعالية ممارسة نقد النقد وفق هذه المستويات واشتغال آلياتها، قدم عبد الواحد المرابط في القسم التطبيقي من كتابه تحليلين وافيين: أحدهما لكتاب عبد الله الغذامي الخطيئة والتكفير، والآخر لكتاب كمال أبوديب الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي. وتسمح لنا مراجعة نقدية لتلك المستويات وإجراءاتها وتطبيقاتها النموذجية بإبداء الملاحظات وتقديم المقترحات التالية:
1 – تحجيم إجراء ممارسة نقد النقد لتحليل شخصية حاضرة بطريقة أو بأخرى في العمل النقدي، وهي شخصية الناقد كاتب العمل النقدي وبكل ما له من مؤهلات ثقافية، ومعتقدات فكرية، ومشروع علمي شخصي، وهو إجراء يبتر مكونًا أساسيًا من مكونات العمل النقدي وفاعلا ًفيه، ويترتب عليه تقليص إمكانيات التحليل الشامل والعميق للعمل النقدي. ويظهر هذا التحجيم عمليًا وواضحًا في القسم التطبيقي من الكتاب.
2 – الاقتصار في التعريف بالعمل النقدي / الكتاب على تقديم ببليوغرافي يحدد سنوات طبعاته ويعرض عناوين محاوره وفصوله، وبدون توضيح لمضامينها توضيحًا يكشف للقارئ الخطوط الكبرى لطريقة الناقد في معالجة موضوعة، ويمكنه من تمثل هندسة الكتاب أو معماره، وتبين مدى الملاءمة بين طبيعة الموضوع وخطوات تحليله. وتمكنه لاحقًا من تتبع سلس لتطور الاستدلال على صحة الفرضية فيه.
3 – عدم التمييز في الحديث عن المتن المدروس بين متنين، متن خارج العمل النقدي / الكتاب ومتن داخله، والتنصيص على ضرورة تقديم المتن الأول، وهو المادة الخام للموضوع / النقد بطريقة علمية تعتمد الاستقراء والوصف والتصنيف، وتعزيز مصداقية المتن الثاني، والذي يوظف في العمل النقدي على سبيل التمثيل والاستشهاد، بأدوات علمية كالإحصاء والعينة.
4 – عدم اعتبار دراسة المنهج النقدي الأدبي أساس عمليات نقد النقد والعمل على تجريد النظريات والمفاهيم النقدية، وجرد المصطلحات النقدية وضبط الإجراءات النقدية ومدى علميتها من خلال تطبيقات العمل النقدي، وبالتالي تقديم صورة كاملة وواضحة لمنهجه، وعلى اعتبار أن أعمال النقد الأدبي العربي الحديث تتوزع بين أعمال تعتمد مناهج نقدية جاهزة وافدة على النقد العربي من ثقافات أخرى، وتحاول أن تلتزم بمبادئها وتعمل بقواعدها، ويدرس نقد النقد مدى نجاحها في ذلك، وأعمال نقدية أخرى شائعة في النقد الأدبي العربي الحديث، توفق أو تلفق بين مبادئ ومفاهيم نقدية تستعيرها من مناهج نقدية قديمة وحديثة، وتعدل بعضها أو تكيفه مع الأعمال الأدبية العربية مشكلة ما يعرف في النقد العربي الحديث بالمنهج التكاملي، وهو منهج يطرح نفسه اليوم وبإلحاح على نقد النقد العربي ليقول كلمته فيه …
5 – عدم الاهتمام بتسجيل الإضافات العلمية التي تقدمها الأعمال النقدية في تحليل المتون الأدبية وتطبيق المناهج النقدية، وذلك بالمقارنة مع نظائرها. وهي إضافات يمكن لنقد النقد، وبمراجعاته للتراكم المنجز في الأعمال النقدية أن يضبطها ويسهم بالتالي في تطوير المعرفة النقدية والتي لا تتطور بالتكرار والاجترار بل بالتجريب والاقتراح والتجاوز.
6 – تسمح قراءات عديدة في التنظير لنقد النقد بملاحظة تعدد وتنوع الصنافات المقترحة لمستويات إجراء نقد النقد وعملياته. وعبد الواحد المرابط نفسه اعتبر طريقة إجراء نقد النقد التي يقترحها طريقة مرنة منفتحة على التكميل والإضافة. وقد رد البعض ظاهرة تعدد تلك الصنافات إلى كون نقد النقد ما زال في مرحلة التشييد. وأعتقد أنها ظاهرة يمكن أن تفسر بإبداعية نقد النقد. فالنقد الأدبي إبداع على إبداع الأدب، والناقد يبدع في تحليل النصوص وعرض ملاحظاته عليها، وناقد النقد يبدع في ضبط إجراءات ومرجعيات تحليل الناقد وملاحظاته، ولكي يحافظ نقد النقد للناقد على إبداعيته، وحتى لا يطبع نقد النقد بطابع النقد المدرسي المقنن يجب أن تتلافى جهود التنظير له الإفراط في تقسيم مستويات التحليل وتعديد عملياته، بل الاقتصار على التنصيص على ثوابت عمليات نقد النقد الرئيسية وهي: 1 – الناقد بمؤهلاته الثقافية، ومعتقداته الفكرية، ومشروعه العلمي مما له علاقة بعمله النقدي. 2 – العمل النقدي من حيث – المعمار – الموضوع وفرضيته – المتن بقسميه الخارجي والداخلي – المنهج بمفاهيمه، ومصطلحاته، وإجراءاته. 3 – تفاعلات الناقد ومكونات العمل النقدي 4 – نتائج تحليل العمل النقدي وخصائص منهجه، ورصد إضافاته المعرفية. وممارسة نقد النقد وفق هذه الثوابت التي تتكيف وبمرونة مع طبيعة العمل النقدي تضمن لنقد النقد فعاليته ولناقده إبداعيته، وهي التي تمكنه من استيعاب التباين الكائن بين أصناف متنوعة من الأعمال النقدية والتي درست، وعلى وجه التخصص القضايا الأدبية، أو حللت الأعمال أو النصوص الأدبية، أو جمعت بين دراسة شخصيات الأدباء وتحليل إنتاجهم الأدبي.
وهذه الملاحظات لا تصرفنا عن التنويه بوضوح وأصالة تحليل عبد الواحد الرابط لأسس نقد النقد المعرفية، وحرصه على توضيح ممارسة إجراءاته بطريقة تطبيقية. وقبل هذا وبعده يبقى كتاب نقد النقد الأدبي من أجل منهج إبستمولوجي بادرة متميزة في النقد الأدبي المغربي الحديث لاقتحامه مجال التنظير النقدي، والذي يمكن أن يدعم مجال التطبيقات النقدية، وحيث تواجه الأعمال النقدية الأدبية العربية مواجهة شاملة ومزمنة إشكالية تأصيل المناهج الوافدة عليها من ثقافات أخرى. وبهذا وذاك يطور نقد النقد النقد الأدبي، ويسهم في بلورة وصياغة مناهج أدبية نقدية حديثة.
هوامش
[1] – الدكتور محمد أحمد مصطفى السرياقوسي، التعريف بمناهج العلوم. سلسلة التعريف بالمنطق ومناهج العلوم، عدد 3، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1986. ص. 70.
[2] – للتوسع في عرض هذه الأفكار يمكن الرجوع إلى كتاب الموضوعية في العلوم الإنسانية عرض نقدي لمناهج البحث. للدكتور صلاح قنصوة. دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1980.
[3] – لمزيد من التوضيح يراجع كتاب أصول النقد الأدبي: أحمد الشايب. مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 1964. فصل في الذوق الأدبي، ص. 119– 143، وكتاب دراسات نفسية في التذوق الفني، للدكتور شاكر عبد الحميد، والدكتور معتز سيد عبد الله، والدكتور سيد جمعة يوسف، قسم علم النفس، جامعة القاهرة، مكتبة غريب، 1989، وكتاب سيكولوجية التذوق الفني، للدكتور مصري عبد الحميد حنورة، منشورات علم النفس التكاملي، بإشراف يوسف مراد،دار المعارف بمصر.
[4] – انظر مثلًا كتاب أصول البحث العلمي ومناهجه، للدكتور أحمد بدر. المكتبة الأكاديمية، الدوحة، الطبعة التاسعة، 1994. وكتاب مناهج البحث العلمي، للدكتور عبد الرحمن بدوي، نشر وكالة المطبوعات، الكويت، 1977.
[5] – نحيل هنا على طبعات تلك الكتب التالية: – خصائص الأسلوب في الشوقيات، طبعة المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1996. – الشعرية العربية، ترجمة مبارك حنون، ومحمد الوالي ومحمد أوراغ، طبعة دار توبقال للنسر، الدار البيضاء، 1996. – الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، الطبعة الثالثة، طبعة عالم الكتب، القاهرة، 1992. – في النص الأدبي دراسة أسلوبية إحصائية، الطبعة الثالثة، طبعة عالم الكتب، القاهرة، 2002.
[6] – للتوضيح نحيل على كتاب الأسلوب والإحصاء، للمختار كريم، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس، 2006.
 رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه
رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه