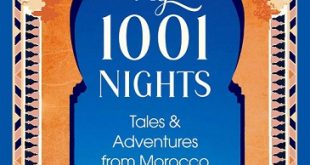محمد صهود، المقاربة بالكفايات من الخطاب البيداغوجي إلى منهاج التاريخ بالتعليم الثانوي في المغرب، مطابع الرباط نت، الرباط، 2023.
 يعم الساحة التربوية المغربية، في السنوات القليلة الأخيرة، الحديث عن تطوير المناهج الدراسية الحالية. ويبدو أنه على مستوى المقاربات البيداغوجية المعتمدة، ستحتفظ المقاربة بالكفايات بمكانة مركزية في توجيه المناهج الجديدة التي سترى النور قريبا. وبعد أزيد من عشرين سنة على تبني هذه المقاربة البيداغوجية منذ إصلاح 2002، ما تزال تصدر كتب عن هذه المقاربة، سوف نركز فيما يلي على كتاب محمد صهود الموسوم بـ “المقاربة بالكفايات من الخطاب البيداغوجي إلى منهاج التاريخ بالتعليم الثانوي في المغرب” الذي صدر بالرباط أواخر سنة 2023. وذلك للإسهام في خدمة ديداكتيك التاريخ في المغرب، إذ يأتي الكتاب في سياق مشروع يهدف للنهوض بتدريس التاريخ في المدرسة المغربية، لجعل هذه المادة ممتعة وذات فائدة اجتماعية[1].
يعم الساحة التربوية المغربية، في السنوات القليلة الأخيرة، الحديث عن تطوير المناهج الدراسية الحالية. ويبدو أنه على مستوى المقاربات البيداغوجية المعتمدة، ستحتفظ المقاربة بالكفايات بمكانة مركزية في توجيه المناهج الجديدة التي سترى النور قريبا. وبعد أزيد من عشرين سنة على تبني هذه المقاربة البيداغوجية منذ إصلاح 2002، ما تزال تصدر كتب عن هذه المقاربة، سوف نركز فيما يلي على كتاب محمد صهود الموسوم بـ “المقاربة بالكفايات من الخطاب البيداغوجي إلى منهاج التاريخ بالتعليم الثانوي في المغرب” الذي صدر بالرباط أواخر سنة 2023. وذلك للإسهام في خدمة ديداكتيك التاريخ في المغرب، إذ يأتي الكتاب في سياق مشروع يهدف للنهوض بتدريس التاريخ في المدرسة المغربية، لجعل هذه المادة ممتعة وذات فائدة اجتماعية[1].
يؤكد محمد صهود أن دراسة الواقع التربوي، وبالخصوص تنزيل المقاربات البيداغوجية، لا يتم إلا بالمزاوجة بين التأصيل النظري ودراسة خصائص الواقع التربوي لأن “التأصيل النظري غير مُجدٍ إذا عجز عن اختراق الواقع التربوي، والاهتمام بالتطبيق دون تأصيل نظري غير ذي فعالية” (ص. 17). ولهذا فقد وقف عند مستوى التأصيل النظري للمقاربة بالكفايات، واكتفى بتحليل الوثائق التربوية الرسمية لفهم كيف حضرت المقاربة بالكفايات في عملية تطوير المناهج الدراسية، خاصة في تدريس وتقويم مادة التاريخ، وترك دراسة الممارسات الصفية جانبا، لأنها لا تدخل في أهداف تأليف كتابه، ولأن هذه المهمة تتطلب مجهودا جماعيا أكبر على اعتبار أن “هذا التأصيل المزدوج (النظري والواقعي) يحتاج إلى نفس أطول وتظافر الجهود” (ص. 17). لكن رغم ذلك، لم يكن هم المؤلف نظريا صرفا، ولم يجعل كتابه محاولة في التأصيل النظري للمقاربة بالكفايات فقط، بل اجتهد وسعه لإبراز مساهمة هذه المقاربة في تطوير درس مادة التاريخ ذات الخصائص الإبستيمولوجية والمنهجية المتميزة بتحليل “عناصر أو معالم نظرية للمقاربة بالكفايات من أجل تأصيلها في مادة دراسية ذات خصوصية معرفية ومنهجية هي التاريخ، هدفها الإسهام في النقاش أكثر مما تروم تقديم أرضية نهائية وجاهزة” (ص. 22).
ولتأطير النقاش وإغنائه، سنعالج ثلاث قضايا شكلت جوهر الكتاب، وتخدم بشكل مباشر تطوير تدريس مادة التاريخ في المدرسة المغربية؛ تتعلق أولى هذه القضايا بأصول المقاربة بالكفايات وترحالها بين العلوم الإنسانية من الاقتصاد إلى علوم التربية والديداكتيك، وترتبط القضية الثانية بالقيمة المضافة التي حققتها هذه المقاربة البيداغوجية حين طُبِّقت على تدريس التاريخ، بينما نقف في القضية الثالثة عند مسألة تقويم درس التاريخ وفق المقاربة بالكفايات.
I– الكفايات: من المقاولة إلى المناهج الدراسية
عمل المؤلف على تحليل السياق العام الذي أنتجت فيه المقاربة بالكفايات في المجتمعات الغربية المعاصرة بدءا من منتصف القرن العشرين، مسترشدا في ذلك بدرس إدغار موران الداعي إلى وضع المعارف في سياقها الشارح ليكون لها معنى. وقد أكد محمد صهود أن وضع المقاربة بالكفايات في سياقها الذي ظهرت وتبلورت فيه يمكّن “من فهمها واستيعاب أسسها وخلفياتها، وهو ما يضمن النقل السليم لها من ثقافة إلى ثقافة أو من مجتمع إلى آخر، أو من حقل معرفي إلى آخر” (ص. 27). هكذا، فقد ظهرت المقاربة بالكفايات، وقبلها بيداغوجيا الأهداف[2] في سياق عام ومركب، اقتصادي-اجتماعي، وعلمي تربوي. ما يلفت النظر في تتبع هذا السياق هو أن كل مرحلة من مراحل تطور الإنتاج توافقها مرحلة على مستوى التنظيم البيداغوجي. بحيث توافق الطايلورية (نسبة إلى فريدريك طايلور صاحب نظرية العمل المتسلسل) بيداغوجيا الأهداف، ويتزامن تعقد طبيعة الإنتاج الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية مع تبلور المقاربة بالكفايات.
انتشرت في الوقت نفسه النظرية السلوكية في علم النفس التي ساهمت إلى جانب الطايلورية في بروز المحاولات الأولى لعقلنة الفعل التربوي، فظهرت بيداغوجيا الأهداف التي ارتكزت أساسا على تجاوز العموميات في الممارسة التربوية، وتبني فكرة الأهداف الدقيقة من أجل الحصول على تقويم موضوعي. لكن تحولات النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، ومعها تطور أنظمة الإنتاج، جعل الطلب شديدا ليس على يد عاملة تتقن مهارات محددة ودقيقة، بل على يد عاملة تتوفر على مهارات عليا ومعقدة لحل المشاكل التي تطرأ باستمرار على الإنتاج الاقتصادي.
انعكس هذا التوجه الجديد على الفكر التربوي والسياسات التربوية فاضطرت المنظومات التعليمية الغربية “إلى تغيير براديغماتها ومفاهيمها وأهدافها من أجل ربط المدرسة بسوق الشغل والتحول نحو المقاربة بالكفايات والمعايير” (ص. 32)، وعملت المؤسسات المالية الدولية، لاحقا وبالتدريج، على فرض هذه المقاربة البيداغوجية الجديدة على البلدان السائرة في طريق النمو بداية من أواخر القرن العشرين ومطلع الألفية الجديدة. يبدو جليا أن كل تغيير في النظام الاقتصادي يؤثر بالضرورة على المنظومات التربوية، ويطرح هذا الواقع أسئلة وجودية بالنسبة للمدرسة من قبيل: هل ينبغي على المنظومات التربوية أن تتكيف دائما مع التحولات الاقتصادية؟ أم عليها أن تحافظ على هويتها واستقلاليتها في نقل المعرفة وليس خدمة نظام اقتصادي محدد؟
ارتبط السياق التربوي المفضي إلى تبني المقاربة بالكفايات بمناقشة المشاكل التعليمية التي واجهها التربويون المنظِّرون والممارسون على حد سواء. فبالنسبة لمبدأ تكافؤ الفرص، انتقل الاهتمام من التكافؤ في الفرص إلى التركيز على التكافؤ في النتائج، إما لأن المبدأ صعب التحقق عمليا، وإما لأن تحقيق تكافؤ الفرص لا يجعل المتعلمين متكافئين في الأداء والنتائج، ومن رحم هذا النقاش خرجت البيداغوجيا الفارقية[3]. أما بخصوص مشكلة الفشل الدراسي، فقد شكلت هاجسا مقلقا للتربويين مما دفعهم إلى ابتكار بيداغوجيات جديدة لمواجهته مثل بيداغوجيا الدعم التربوي ونظرية الذكاءات المتعددة. مجمل القول إن السياق التربوي العلمي ارتبط بتحولات المدرسة المعاصرة، وتشعب مشاكلها، وتوالي البحوث لحل هذه المشاكل. ولهذا، فقد ولدت بيداغوجيا الكفايات من رحم هذه النقاشات والاجتهادات التربوية (مع تفاعل مستمر مع السياق الاقتصادي) الساعية إلى ضمان تعليم جيد لكل المتعلمين رغم تفاوت أصولهم الاقتصادية والاجتماعية، وتباين أنواع ذكاءاتهم، واختلاف استراتيجيات التعلم لديهم.
لقد وقع إذن تجاوز لبيداغوجيا الأهداف التي أُخذ عليها الإفراط في تجزيء وتفتيت الفعل التربوي الذي كان يقتضي صياغة الآلاف من الأهداف الصغيرة وتجزيء سلوك المتعلمين إلى آلاف السلوكات التي يمكن ملاحظتها وقياسها وتقويمها بشكل دقيق جدا، كما يزعم أنصارها والداعون إليها. وهكذا شكل الانتقال من بيداغوجيا الأهداف إلى المقاربة بالكفايات انتقالا من العمل التجزيئي إلى التصور الشمولي. ولهذا كان كثير من البيداغوجيين يعتبرون المقاربة بالكفايات براديغما جديدا أو ثورة براديغمية للمدرسة المعاصرة، لأنها تدفع المتعلم ليس إلى تلقي المعرفة جاهزة بل إلى بنائها في إطار وضعيات تعلمية يضعها المدرس لتحفيز المتعلم على بناء المعرفة وامتلاك مهارات التعلم الذاتي. وباختصار، فالمدرس موجِّه، والمتعلم منتِج للمعرفة، والمدرسة منفتحة على محيطها السوسيو-اقتصادي والثقافي.
يعتبر مفهوم الكفاية مفهوما عابرا للحقول المعرفية، فإذا كان علم الاقتصاد والتدبير هو منشأه الأصلي، فقد انتشر في كل العلوم الإنسانية الأخرى وصولا إلى حقل التربية. إن التطور في عالم الشغل والمقاولة مستمر ولا يكاد يتوقف، وبالتالي، فإنه يتطلب من الفرد جهدا مضاعفا وتركيزا متواصلا من أجل التجديد والابتكار عبر تعبئة كامل قدراته ومهاراته لحل المشكلات بالغة التعقيد التي تعترضه يوميا، وبشكل مفاجئ. ولهذا فإن الكفاية من منظور التدبير المقاولاتي، هي “حسن التصرف، بمعنى القدرة على تعبئة وإدماج وتحويل مجموعة من الموارد مثل التمثلات والمهارات والمعارف […] من أجل إنجاز مهام أو حل مشكلات” (ص. 67 نقلا عن لوبوطيرف). ويعرّف اللسانيون الكفاية بأنها القدرة الكامنة، الافتراضية والفطرية، لدى الإنسان لتوليد أكبر عدد ممكن من التراكيب اللغوية، وعندما يفعل ذلك في الواقع، فإنهم يتحدثون عن الإنجاز: الاستعمال الفعلي للغة في وضعيات ملموسة. أما سيكولوجيو النمو الذهني، فناقشوا خلاصات أبحاث اللسانيين وتوصلوا إلى أنه ليس ثمة تطابق بين الكفاية بصفتها تلك القدرة الافتراضية والفطرية، وبين الإنجاز، باعتباره تجليا واقعيا لهذه الكفاية، لأن “ثمة اختلاف في هذا الإنجاز، أولا من وضعية إلى وضعية حسب كل فرد، وثانيا من فرد لآخر. هكذا لا يمكن الحديث إلا عن كفاية افتراضية فقط، أي إمكانية الفعل …” (ص. 67).
الملاحظ أنه كلما انتقل مفهوم الكفاية إلى حقل معرفي جديد إلا وصعبت تبيِئته إلا بعد مجهود نظري كبير، ف”الحديث عن الكفايات في التدبير المقاولاتي أو الاقتصاد أو التكوين المهني يغلب عليه البعد التقني البراغماتي المرتبط بغايات المؤسسات الإنتاجية التي تتوخى البحث عن إنتاجية أكبر في ارتباط بسوق الشغل، على أن الانتقال إلى المقاربة بالكفايات فيما نسميه عادة بالإنسانيات (التاريخ، الجغرافيا، والفلسفة، وغيرها) يجعلنا أمام مواد دراسية لها خصوصيات بالنظر إلى غاياتها وأهدافها” (ص. 14). واجهت البيداغوجيين، أول الأمر، صعوبات كبيرة في تبيئة مفهوم الكفاية في حقل التربية. وهذا ما يفسر المجهود المضني الذي بذله محمد صهود من أجل التأصيل النظري لمفهوم الكفاية في حقل البيداغوجيا، حتى بعد أكثر من عقدين على تبني هذه المقاربة في المغرب. فقد حرص على تبسيط المفاهيم المرتبطة بها، مثل: القدرة، والمهارة، والخطاطة الذهنية، والهدف الإجرائي، والمعايير، …الخ، وكأني به يريد أن يجعل كل هذه المفاهيم في غاية الوضوح للقراء والفاعلين التربويين (المدرسين، والمفتشين، والباحثين على وجه الخصوص)، لأن استيعابها الجيد هو الكفيل بتنزيل المقاربة تنزيلا مثاليا في ممارساتنا الصفية.
ينطلق المؤلف في هذا من قناعة راسخة لديه بأن “مسألة تحديد المفهوم ليست ترفا فكريا أو إجراء منهجيا روتينيا نقوم به في بداية البحوث والدراسات، بل هي سلوك منهجي ذو آثار وانعكاسات إيجابية كثيرة، ومن هذه الانعكاسات ما يتعلق بكون التحديد المفاهيمي يسهم في إزالة اللبس الذي قد يكتنف المفهوم نظرا لكثرة التعريفات التي تعطى له، ومنها ما يسهم في خلق الانسجام بين التعريف المنتقى والمقاربة البيداغوجية المستهدفة، ومنها ما يجعل من المفهوم نفسه متضمِّنا للمقاربة كلها فيكون التعريف أو المفهوم موجها للمقاربة ومساعدا على توضيح الخطوات المنهجية والديداكتيكية” (ص. 101). من هذا المنطلق، استعرض المؤلف أزيد من ثلاثة عشر تعريفا للكفايات في كتابات البيداغوجيين الكبار، ومن هذا الجرد التفصيلي للتعاريف المتعددة صاغ تعريفا تركيبيا يغني الباحث التربوي عن استعراض كل التعاريف الموجودة[4]. فالكفاية، كما يُعرفها، هي “إمكانية تفعيل الموارد بشكل اندماجي ونسقي ضمن وضعية إشكالية تنتمي لفئة من الوضعيات بهدف القيام بإنجاز ناجع وفعال لمعالجة هذه الإشكالية” (ص. 83). تتجلى أهمية هذا التعريف التركيبي في كونه يحدد بوضوح المكونات الأساس للكفاية، وهي كالتالي:
– الموارد: كل المعارف والقدرات والمهارات والعواطف التي يمكن توظيفها لحل مشكلة ما، على أن يكون هذا التوظيف نسقيا ومندمجا.
– الوضعية: السياق الخاص الذي يتم فيه توظيف وتعبئة الموارد.
– الإنجاز: المؤشر الدال على تحقق الكفايات أو أداء مهمة أو تحقيق هدف معين، ومن خلاله تكون الكفاية قابلة للتقويم.
وعلى العموم، فقد توخى البيداغوجيون من خلال تبني المقاربة بالكفايات تحقيق ثلاثة أهداف: الأول، تركيز الاهتمام على ما يجب أن يتعلمه المتعلم، والثاني، جعل التعلمات أكثر وظيفية وذات معنى، والثالث، بناء التعلمات على أساس الوضعيات. وهي أهداف من شأنها، إذا تحققت، أن تقلب الممارسات الصفية والتقويمية قلبا إيجابيا وأن تضفي المعنى على المواد الدراسية.
II– تدريس التاريخ وفق المقاربة بالكفايات: كيف؟ ولماذا؟
عند الحديث عن التاريخ بصفته علما إنسانيا، ومادة دراسية، غالبا ما يتبادر إلى الذهن السؤال الأزلي: “لماذا ندرس التاريخ ونتعلمه؟”. لقد فرضت المتغيرات الدولية الراهنة إعادة النظر في غايات تدريس التاريخ، فهناك “سياق يتداخل فيه ما هو عالمي مع ما هو وطني، وهو سياق يستدعي التفكير في بلورة منهاج للتاريخ يستجيب للظروف الدولية والوطنية الحالية، نستند عليه في البرهنة على مشروعية تدريس التاريخ وعلى خصوصيته بل ضرورته في السياق الحالي” (ص. 132). وفي إطار البرهنة على مشروعية تدريس التاريخ ذكّر المؤلف بالوظائف التي يؤديها تدريس التاريخ للمجتمع، وهي أربع وظائف أساسية متداخلة لا يمكن الفصل بينها إلا لأهداف منهجية أو تعليمية. وبناء عليه، فإن التاريخ يؤدي:
– وظيفة غريزية: إذ يلبي حاجة نفسية واجتماعية لفهم الذات والعلاقة مع الآخر.
– وظيفة معرفية: إذ يبحث التاريخ في جذور قضايا العالم معاصر، ويتتبع وتيرة تطورها.
– وظيفة تأويلية: وترتبط بكون التاريخ لقاحا ضد الذاكرة وعقلنةً لها من أجل بناء الهوية. هذا ما يجعل الدارس في حيرة: فكيف ننقل قيم الجماعة وندافع عنها، وفي الوقت نفسه نسعى إلى اكتساب وإعمال الحس النقدي.
– وظيفة مرتبطة بتنمية قيم المواطنة حيث يسعى تدريس التاريخ إلى التنشئة على قيم المواطنة والديمقراطية والانخراط في العصر الحاضر.
رأى البيداغوجيون، في الغرب كما في بلادنا، أن المقاربة بالكفايات تتناسب وغايات تدريس التاريخ، إلا أن التاريخ ظل في حاجة إلى مجهود نظري تأصيلي لتبيِئة المقاربة بالكفايات مع الخصوصيات المنهجية والإبستيمولوجية لمادة التاريخ. ذلك أن هذه المادة لا يمكن تدريسها دون وثائق (بالمعنى الواسع للوثيقة)، كما يغلب عليها البعد الثقافي والاجتماعي أكثر من البعد التقني والبراغماتي، حيث تستهدف هذه المادة الدراسية بالأساس “الجانب التكويني القيمي الذي يركز على تربية فرد متشبع بهوية وقيم مستمدة من قيم المجتمع وثقافته من أجل ضمان الاستمرارية الثقافية والمجتمعية” (ص. 128).
يدافع محمد صهود انطلاقا من السؤال “هل يشكل اعتماد تدريس التاريخ على المقاربة بالكفايات رافعة لتطوير هذا التدريس؟” عن هذه المقاربة ويعتبرها مثالية لتدريس التاريخ، لأن “الفكر التاريخي لا تنفصل فيه سيرورة التعلم عن منتجه، إذ المعرفة الخاصة بالمادة ليست محتوى فقط بل هي طريقة في التفكير. من هذا المنطلق لا يمكن إلا أن يكون للمقاربة بالكفايات فائدة منهجية باعتبارها تحيل على التفكير المنهجي لا على التلقي السلبي” (ص. 95). ويدخل تبني المقاربة بالكفايات في التدريس في إطار ردود الفعل التربوية على المقاربات التقليدية المعتمدة في تدريس التاريخ والمسماة “بيداغوجيا المحتوى” التي تعتمد الطريقة الإلقائية. وبهذا صار تدريس التاريخ وفق المقاربة بالكفايات يعتمد على استنطاق الوثائق ونقدها، ووضعها في سياقها ومن ثمة تأويلها.
صارت المعرفة التاريخية تبنى بواسطة عملية الربط الإشكالي بين الماضي والحاضر لتهيئ الفرد لفهم مجتمعه في أفق العمل على تغييره، ذلك أن “برنامج المحتوى وبرنامج الكفايات يختلفان بالنظر للأولوية المعطاة للفكر أو الفعل وليس بالنظر لحضور أحدهما وغياب الآخر. إن برنامج المحتوى يعطي الأولوية للمفاهيم دون إغفال الفعل، وبرنامج الكفايات يعطي الأولوية للفعل الذي يستدعي بالضرورة المفهوم لكي يفهم معنى الفعل” (ص. 98). وقد صارت المنظومة التربوية المغربية في الاتجاه نفسه.
عرف المغرب، مع مطلع الألفية الثالثة، مجهودات كبيرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين بما يتوافق ومتطلبات الألفية الجديدة، وتأطر إصلاح المناهج بثلاث وثائق تربوية مركزية، هي: الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والوثيقة الإطار الصادرة عن لجنة الاختيارات والتوجهات واللجنة البيسلكية متعددة التخصصات، زيادة على التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بكل مادة دراسية على حدة.
في إطار هذا الإصلاح الجديد، وُضع تصور مبتكر لمادة التاريخ باعتبارها، إلى جانب مادة الجغرافيا، تلعب “دورا حاسما في التكوين الفكري والمدني للمتعلمين بجعلهم يطورون من خلال تمثلهم للزمن والمجال وإدراكهم للحقوق والمسؤوليات، ذكاء اجتماعيا يساعدهم في حياتهم اليومية، الشخصية، المهنية والاجتماعية”[5]. من هنا، شهد المنهاج التخصصي لمادة التاريخ في المغرب، بفضل دينامية إصلاح المناهج ومراجعة الكتب المدرسية منذ سنة 2002، عدة تحولات إيجابية يجب الاحتفاظ بها كمكسب، وإن كانت تعتريه بعض النقائص التي تحتاج للمراجعة. فمن باب التحولات الإيجابية، ذكر المؤلف، أولا، الاعتماد على مرجعية ديداكتيكية واضحة. ذلك أن بناء المعرفة التاريخية في الكتب المدرسية والممارسة الصفية “يتواصل […] من خلال عمليات فكرية تتمثل في التعريف والتفسير والتركيب. وكلها عمليات نختزلها في المفهمة التي هي عملية كبرى مرتبطة بالفكر التاريخي” (ص. 158)[6]، وهذا ما جعل الكتب المدرسية الجديدة لا تتضمن ملخصات، بل تتضمن أنشطة تعلمية اعتمادا على وثائق يتم الاشتغال عليها وفق أسئلة وتعليمات دقيقة. أما ثاني التحولات الإيجابية، فيتعلق بتحول الاهتمام من التركيز على المنتج إلى التركيز على السيرورة، لكن إذا كانت “هذه المقاربة البيداغوجية تهتم بالسيرورة فإنها لا تنفي أهمية المعرفة المنتجة، على أن وضع هذه المعرفة يختلف في السياق الجديد، فهذه ليست معرفة ملقنة وجاهزة للاستهلاك، بل معرفة مبنية يتوصل إليها المتعلم عبر وضعيات ديداكتيكية” (ص. 159). أما بخصوص الثغرات والنقائص في المنهاج التخصصي المغربي، فلخصها المؤلف في تعدد مستويات الكفايات دون تحديد الكفايات ذات الأولوية ليعمل المدرس على أجرأتها، وعدم وضوح الاشتقاق، وغياب التدرج من العام إلى الخاص أثناء صياغة الكفايات، وتكرار بعض الكفايات في مستويات مختلفة، ثم ضبابية مفهوم القدرة. تعزى هذه الثغرات، في نظرنا على الأقل، إلى غياب تأصيل نظري كاف للكفاية لحظة إصلاح المناهج بداية من سنة 2002، وإلى عدم التمفصل بين الوثائق الرسمية للمنهاج من الأعلى إلى الأسفل، بدءا بالوثيقة الإطار وصولا إلى التوجيهات التربوية ومنها إلى الممارسات الصفية.
ولأن الحس الديداكتيكي حاضر بقوة لدى محمد صهود، خاصة الجانب التطويري منه، فقد عمل على استعراض ثلاثة نماذج غربية لمنهاج التاريخ وفق المقاربة بالكفايات، وقابلها بالنموذج المغربي، ثم اقترح بناء على خلاصات المقارنة نموذجا جديدا لصياغة الكفايات لمنهاج مادة التاريخ. لقد كان الهدف من عرض النماذج الغربية الثلاثة هو استخلاص الدروس للعمل بها في تطوير المنهاج المغربي “من باب الاستئناس بمختلف التجارب، واستيحاء إيجابياتها مع استحضار خصوصيات المادة الدراسية المعنية (التاريخ) وخصوصيات المنظومة التربوية المغربية […] اعتبرناها أمثلة ولم نعتبرها نماذج اقتناعا منا أن الشأن التربوي لا مجال فيه للنمذجة بالنظر لاختلاف المجتمعات من الناحية التاريخية والثقافية” (ص. 144).
بني النموذج البلجيكي لتدريس التاريخ، بحسب المؤلف، وفق المقاربة بالكفايات على الوظائف الأربع للتاريخ باستثناء الوظيفة الغريزية. فكل الكفايات المسطرة لا تخرج عن إطار وظيفة من الوظائف الأساسية للتاريخ. أما النموذج الفرنسي، فسعى إلى الربط بين الأبعاد المعرفية والمنهجية والقيمية للتاريخ في علاقة بكل الوسائل والتقنيات، ومنها الرقمية. أما النموذج الكندي، فعمل على تكييف منهاج مادة التاريخ مع المهارات الحياتية (life skills) والكفايات التي يتطلبها مجتمع المعرفة والتحولات الاقتصادية والتقنية التي يشهدها القرن الواحد والعشرون، وهي كفايات “أو مهارات تفرضها الوضعية الدولية الراهنة المتسمة بتسارع التطور التكنولوجي والانفجار المعلوماتي، وما يفرضه من ضرورة اكتساب المهارات والقدرات والاتجاهات اللازمة للتكيف مع الوضعية الراهنة” (ص. 149). أما بخصوص المنهاج المغربي، فقد لاحظ محمد صهود أن الكفايات المنصوص عليها في منهاج التاريخ بالسلك الثانوي الإعدادي، وكذلك بالسلك الثانوي التأهيلي، مستوحاة من الفكر التاريخي، أي الخصائص الإبستيمولوجية والمنهجية لعلم التاريخ، ويمكن أن تستنتج بسهولة غياب أي ربط لهذه الكفايات مع متطلبات مجتمع القرن الواحد والعشرين. ولعل المؤلف نفسه مدرك لهذا، حيث نجده يقر بذلك قائلا: “علاوة على ذلك، يمكن التساؤل عن خلفيات الكفايات المقررة وما أسباب تبنيها، كما رأينا في الحالة الكندية مثلا، ويمكن التساؤل أيضا عن موقع العالم الرقمي أو دور التكنولوجيات الحديثة في تدريس المواد الاجتماعية، وهل تم استحضار الوظائف التي يخدمها التاريخ على المستوى المجتمعي” (ص. 162). ومن باب الاقتراح، قدم المؤلف مقترحا لكفاية منهجية، وهي كفاية التحقيب. ورغم أن المؤلف ظل وفيا لاستراتيجية النهل من الفكر التاريخي عند صياغة هذا المقترح، إلا أن كفاية التحقيب التاريخي لا تخلو من أهمية اجتماعية إذ ترسخ في أذهان المتعلمين الوعي بالتغير الذي يطرأ على المجتمعات البشرية في الزمن، وتُنَمي إلى جانب ذلك ملكة الحس النقدي.
III– تقويم الكفايات في درس التاريخ
ينطلق محمد صهود، في موضوع التقويم، من اقتناع راسخ لديه بأن التقويم “محطة تتوج سيرورة التعلم وتهدف إلى رصد مدى تحقق الأهداف والكفايات عبر تقويم المكتسبات والمعارف والمهارات عند المتعلم أو في إطار وضعيات ديداكتيكية. على أن هذا لا يمنع من اعتباره مكونا من مكونات التعلم لديه” (ص. 171). ولأن تقويم الكفايات لا يشذ عن قاعدة الأدبيات التي كتبت حول التقويم التربوي وأشكاله وطروحاته ووظائفه، فقد أولى عناية خاصة لتحديد المفاهيم مثل: التقويم، والقياس، والامتحان، والاختبار، والتقويم المعياري، والتقويم المحكي، والتقويم التكويني، والتقويم الإشهادي، …إلخ. ويختم هذه التحديدات المفاهيمية بالتأكيد على أن “تقويم الكفايات لا يمكن أن يقفز على هذه الترسانة المفاهيمية وغيرها، وهذا هو جانب الاستمرارية […] دون إغفال المفاهيم الدوسيمولوجية الجديدة المؤشرة على التغير” (ص. 175). أين يكمن التغيير إذن؟
يقر المؤلف أن تقويم الكفاية من الصعوبة بمكان لأن التربوي لا يجد نفسه أمام مفهوم مرتكز على وجود مادي، بل الكفاية مفهوم غير مرئي، ومرتكز على بناء ذهني أو حتى اجتماعي. لهذا فإن تقويم الكفاية لا يتم إلا في إطار وضعية مشكلة، مع التركيز على تقويم المنتَج وليس الكفاية نفسها. وهذا هو الجديد الذي جاءت به الأبحاث التربوية في مجال تقويم الكفايات. نجد المؤلف يتبنى موقف فيليب بيرنو وكزافيي روجرز بتأكيدهما على أن “شكل تقويم الكفاية يظل بالمقابل ثابتا لا يتغير، إذ أنه يقوم على وضع التلميذ أما وضعية مشتقة من الوضعيات المحددة للكفاية، وبملاحظة كيفية مواجهته لها بتحليل ما يقدمه من إنتاج في ظل الوضعية المشكلة” (ص. 179). وبناء عليه، يتم رصد تجليات الكفاية في الإنجاز الذي أنتجه المتعلم أثناء الوضعية التقويمية عبر مجموعة من المعايير والمؤشرات التي يجب على المدرس-المقوِّم أن يحددها بدقة. وتمر عملية أجرأة الوضعيات التقويمية من المراحل التالية[7]:
– تحديد الكفايات التي ينبغي تقويمها.
– بناء الوضعيات التقويمية.
– وضع الدعامات الديداكتيكية وإرفاقها بالتعليمات والأسئلة التقويمية.
– تحديد المعايير الخاصة بالتصحيح ومؤشراته.
توصل المؤلف على مستوى الممارسة، وبعد تحليل الوثائق التربوية الرسمية الخاصة بمادة التاريخ في السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي إلى أن تقويم الكفايات في المنهاج المغربي قد حقق بعض الخطوات إلى الأمام، مع استمرار بعض التعثرات التي تحتاج إلى التفكير فيها بجدية في أفق تجديد ممارساتنا التقويمية. فمن باب عقلنة عملية التقويم، خاصة في المستويات الإشهادية، صارت الأطر المرجعية بمثابة تعاقد يوضح الوضعيات الاختبارية، ومعايير التصحيح. كما صارت التوجيهات التربوية تحدد مبادئ التقويم، ومواصفاته، وضوابطه البيداغوجية، ونوعية الوضعيات الاختبارية. لكن رغم هذا التقدم الملموس، لا يساير التقويم التربوي كما يمارَس عندنا كل الأشكال التي تحدثت عنها الأدبيات التقويمية للكفاية. إذ لا تزال الممارسات التقويمية تقتصر على المقال، ووضعية الاشتغال على الوثائق. ثم إن الموضوع المقالي، بالشكل الذي يرد في امتحاناتنا، لا يزال يكرس تلك النظرة السلبية تجاه مادة التاريخ التي لا يحتاج التفوق فيها إلا لذاكرة قوية واستظهار حرفي للمعلومات. وزيادة على ذلك، لا تساهم وضعية الاشتغال على الوثائق في تقوية الحس النقدي بل تعطي نتيجة عكسية حين تؤدي إلى تقديس المتعلم لمضمون الوثائق عوض أن يُعمل فيها العقل ويسائلها بقراءة نقدية. وأخيرا، لا يتطرق التقويم في المنظومة التربوية المغربية إلى تقويم القيم والمواقف والاتجاهات، مع العلم أن التاريخ مادة حاملة للقيم. واضح إذن “أن التقويم في منهاج مادة التاريخ شكل تحولا نحو تبني الخطاب البيداغوجي والدوسيمولوجي للكفايات […] إلا أنه اتضحت محدودية مسايرة خطاب التوجيهات التربوية للخطاب النظري في مجال تقويم الكفاية. ولذا تنتظر خطاب التوجيهات التربوية في مجال تقويم الكفاية آفاق أرحب للانفتاح والتطوير والتطبيق” (ص. 198). وفي إطار الدعوة إلى تطوير التقويم في مادة التاريخ، حدد المؤلف ثلاث نقط يجب التركيز عليها؛ تنويع أدوات التقويم الخاصة بكفايات التاريخ. عدم فصل إصلاح التقويم عن إصلاح المناهج، واستحضار الأبعاد القيمية في تقويم مادة التاريخ.
قد تكون هذه دعوة إلى تحديد أشكال التقويم المختلفة والمنسجمة مع المقاربة بالكفايات، وترك الحرية البيداغوجية للمدرسين للتنويع بينها في ممارساتهم التقويمية. لكن ليس قبل مرحلة جديدة في إصلاح المناهج الدراسية، فتطوير التقويم لا ينفصل بشكل من الأشكال عن إصلاح المناهج.
لا يسائل الكتاب منهاج مادة التاريخ وحده، بل يسائل المنهاج الدراسي العام ويلح عليه، في نهاية المطاف، بالأسئلة التالية: ما هي الشروط الموضوعية لإنجاح تنزيل المقاربة بالكفايات؟ وكيف يمكن استقصاء الواقع التربوي حتى يكون هذا التنزيل مثاليا؟ وما هو واقع تدريس التاريخ، وحتى باقي المواد الدراسية، وفق المقاربة بالكفايات، في مؤسساتنا التعليمية؟[8] تبرر هذه الأسئلة المسلّمةُ القائلة بأن تنزيل أي نظرية أو مقاربة بيداغوجية لابد أن تسبقه دراسة مفصلة للواقع التربوي، ثم إن عملية مراجعة المنهاج عملية ممتدة في الزمن، وتغير المقاربات البيداغوجية لا يتوقف، ويرتبط جدلا بالتحولات الاقتصادية والسياسية والتربوية، المحلية والعالمية على حد سواء. ولعل ما يجعل عملية استقصاء الواقع التربوي ملحة هو انشغال المغرب، حاليا، بتطوير المناهج الدراسية وتنقيحها في كل الأسلاك، ومن المرجح الإبقاء على العمل بالمقاربة بالكفايات أو على أبعد تقدير الانتقال إلى الاشتغال بالمعايير التي هي استمرار للمقاربة بالكفايات، بشكل من الأشكال.
يدعو محمد صهود في ثنايا هذا الكتاب، بشكل ضمني في بعض المواضع وبشكل صريح في مواضع أخرى، إلى عدم الوقوع في الخطأ الذي لازم السياسات التربوية المغربية منذ عقود طويلة وهو التنافر بين الخطاب البيداغوجي والممارسة التعليمية الفعلية في الأقسام الدراسية. فعند حديثه عن تحولات الخطاب البيداغوجي وتقلبات السياسات الإصلاحية في بلادنا منذ التسعينيات إلى اليوم، وضع المؤلف أصبعه على الإشكالية الحقيقية في سياساتنا التربوية وهي تنافر الخطاب والواقع. لذا فالتساؤل المطروح، في نظره، هو: “هل هذه سيرورة خطاب أم سيرورة ممارسة تربوية وبيداغوجية فعلية” (ص. 15)، ويجيب مباشرة بالقول: “المؤكد أن القارئ لا يجد صعوبة في إيجاد تطابق هذه السيرورة مع الخطاب البيداغوجي الغربي […] لكنه قد يجد صعوبة في إيجاد تطابق هذا الخطاب مع واقع الممارسة التربوية والتعليمية المغربية” (ص. 15). قد يعزى الأمر، على سبيل الفرضيات، إلى عدم وجود خبراء المناهج ببلادنا يسهرون على تنزيل المناهج التخصصية وفق المقاربات البيداغوجية المعتمدة والموصى بها، وفي احترام تام مع التوجهات الاستراتيجية للدولة ووثائقها التربوية الرسمية المؤطِرة. وفي ظل هذا الغياب، توكل هذه المهمة لبعض الأساتذة الممارسين، والمفتشين التربويين، والمكوِّنين في مراكز التكوين. لكن يبقى أن هؤلاء، ورغم الكفاءات التي أبانوا عنها طيلة عقود في صناعة المناهج التخصصية، ليسوا خبراء في صناعة وتنزيل المناهج.
————————————–
الهوامش:
[1]– صدرت للمؤلف المنشورات التالية:
– التحقيب التاريخي، إسهام في التأصيل المنهجي والإبيستمولوجي (2016).
– البعد المنهجي والإبيستمولوجي في المعرفة التاريخية (2018).
– تعلم التحقيب التاريخي، استيعاب نموذج ديداكتيكي وأجرأته، 2020 (إشراف على عمل جماعي).
[2]- يعرف محمد الدريج الأهداف في التعليم كالتالي: “الهدف سلوك مرغوب فيه يتحقق لدى المتعلم نتيجة نشاط يزاوله كل من المدرس والمتمدرسين وهو سلوك قابل لأن يكون موضع ملاحظة وقياس وتقويم”. أنظر: محمد الدريج، الكفايات في التعليم، سلسلة المعرفة للجميع، العدد 16، أكتوبر 2000، ص. 12. ويذهب محمد الدريج إلى أن المقاربة بالكفايات ما هي إلا حركة تصحيحية لبيداغوجيا الأهداف حيث “لا يشكل مدخل الكفايات في التعليم منظورا مستقلا عن التدريس الهادف، بل هو نموذج من نماذجه ويندرج ضمن ما يعرف عامة ببيداغوجيا الأهداف. إنه مجرد حركة تصحيحية داخل هذه البيداغوجية ويعمل لتجاوز الانتقادات، على تصحيح ما أصابها من انحراف، جعلها تنغلق في النزعة الإجرائية-السلوكية وتنحرف بالتالي بالفعل التربوي، إلى فعل آلي تعودي وإلى رد فعل إشراطي يعدم الخصوصية والتميز ويستبعد التفكير الابتكاري”. المرجع نفسه، ص. 3.
[3]– البيداغوجيا الفارقية: “عبارة عن مجموعة من التمشيات التربوية، ومنهجيات التكوين، والتقنيات والأدوات الديداكتيكية التي تأخذ بعين الاعتبار التنوع واللاتجانس في الفصول الدراسية، والتي تسعى كذلك إلى مساعدة الجميع على بلوغ الأهداف المعرفية بشكل متساو ومتكافئ”. أنظر:
Christine Barrée-de-Miniac, « La pédagogie différenciée », Recherche & Formation n°5, 1998, p. 121.
[4] – إن من حسنات تعديل منهاج السلك الابتدائي، سنة 2021، هو إعطاء تعريف واضح ودقيق لمفهوم الكفاية لا يختلف كثيرا عن التعريف الذي يتبناه محمد صهود أعلاه. جاء في المنهاج دراسي المنقح للتعليم الابتدائي: “معرفة التصرف الملائم والناجع، الذي ينتج عن تعبئة وتنظيم قدرات ومعارف ومهارات وقيم ومواقف ملائمة لحل وضعيات مشكلة و/أو إنجاز مهمات مركبة في سياق معين ووفق شروط ومعايير محددة”. أنظر: مديرية المناهج، المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي. الصيغة النهائية الكاملة، يوليوز 2021، ص. 31.
[5]– مديرية المناهج، التوجيهات التربوية والبرامج الخاصة بتدريس مادتي التاريخ والجغرافيا بسلك التعليم الثانوي التأهيلي، نونبر 2007، ص. 3.
[6] – يضيف المؤلف في موضع آخر من كتابه: “وهكذا تنطلق الممارسة الديداكتيكية، وفق توجيه المنهاج الدراسي لمادة التاريخ، من أشكلة المعارف […] ويتواصل بناء المعرفة التاريخية من خلال عمليات فكرية تتمثل في التعريف والتفسير والتركيب، وكلها عمليات تختزلها في عملية كبرى مرتبطة بالفكر التاريخي عموما وهي المفهمة” (ص.99). انظر تفاصيل أكثر حول هذه العمليات الفكرية المرتبطة بالفكر التاريخي في: (مصطفى حسني إدريسي، الفكر التاريخي وتعلم التاريخ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2021، صص. 73-168)
[7] – تبين هذه المراحل أهمية جذاذة التقويم التي لا يوليها المدرسون الأهمية اللازمة في الممارسات التقويمية، عند إعداد المراقبات المستمرة.
[8]– مع اقتراب نهاية عشرية الإصلاح (1999-2009) توصلت وزارة التربية الوطنية، بناء على التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم سنة 2007، إلى أن “مراجعة المناهج والبرامج وفق المقاربة بالكفايات لم تتح بعد بلوغ الأهداف والغايات المتوخاة منها على الشكل المطلوب، وخصوصا تلك المتعلقة بتحديد الكفايات والمعارف التي من المفروض أن يتحكم فيها التلاميذ والتلميذات في نهاية المسار التعليمي الإلزامي، أو تلك المرتبطة بتجديد أساليب وطرائق التعليم والتقويم”. أنظر: دليل المقاربة بالكفايات، ص. 3.
 رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه
رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه