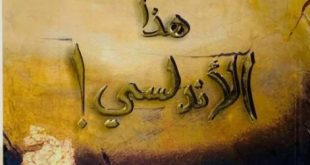قراءة في ملحمتي الإلياذة والأوديسة لهوميروس
“أظن أن الملحمة هي من الأشياء التي يحتاج البشر إليها” ل.ب. بورخيس
مقدمة
 كيف يمكن الاعتقاد في أمور متناقضة، في الربط بين الحقيقة والخيال، بين زمن الأسطورة وزمن التاريخ. يُقِرُّ “بول فايين” أنه لا بد من الكلام على حقائق بدلًا من معتقدات. وأن الحقائق كانت نفسها تخيلات. وقديما كان الشعراء والمؤرخون ينسجون روايات خيالية حول السلالات المَلكية.كانوا يعتمدون النهج المتعارف عليه لبلوغ الحقائق. وبهذا هل يمكن اعتبار حقيقيًا ما نسميه أوهاماً تخييلية، وأن عوالم الإلياذة والأوديسة عوالم حقيقية؟
كيف يمكن الاعتقاد في أمور متناقضة، في الربط بين الحقيقة والخيال، بين زمن الأسطورة وزمن التاريخ. يُقِرُّ “بول فايين” أنه لا بد من الكلام على حقائق بدلًا من معتقدات. وأن الحقائق كانت نفسها تخيلات. وقديما كان الشعراء والمؤرخون ينسجون روايات خيالية حول السلالات المَلكية.كانوا يعتمدون النهج المتعارف عليه لبلوغ الحقائق. وبهذا هل يمكن اعتبار حقيقيًا ما نسميه أوهاماً تخييلية، وأن عوالم الإلياذة والأوديسة عوالم حقيقية؟
كيف تقدم ملحمة هوميروس تفكيرًا تاريخيًا يؤسس لممارسات اجتماعية يغلب عليها الطابع الديني والأسطوري،وإرساء جميع أشكال التفكير التي يفهم بها الإنسان نفسه في عالمه؟ وهل نستطيع أن نتبين الحدود الفاصلة بين زمن الواقع وزمن الأسطورة في رواية هوميروس؟
وهل استطاع العقل التاريخي،كما يشتغل عليه المؤرخ، كممارسة نقدية، “فعالية سردية” تجمع بين العرض الحدثي في الزمن وبين نشاط المفهمة المرتبط به، تطهير الأسطورة من الواقع ومن التاريخ في إطار برنامج الحقيقة الإغريقي؟ وهذا يجعلنا نتساءل دور الرواية الأسطورية في ملحمة هوميروس في بناء هوية سردية تصالح بين الذاكرة والتخييل والتاريخ؟
وكيف يمكن أن نصل بين السرد التخييلي والسرد التاريخي في تفسير وفهم مجموعة من القضايا التي تتضمنها وتطرحها ملحمة الإلياذة والأوديسة، كعمل إبداعي وكممارسة اجتماعية وتاريخية يطغى عليها البعد العجائبي والأسطوري والديني؟
يقول بول فاين في مقدمة كتابه كيف يكتب التاريخ:”إذاً، ما هو التاريخ؟ وماذا يفعل المؤرخون في الواقع، منذ “تيوسيديد” حتى “ماكس فيبر” أو “مارك بلوخ”، بعد أن يخرجوا من وثائقهم ويباشروا التوليف؟ هل يقدمون دراسات علمية للنشاطات والإبداعات المختلفة التي أتى بها الإنسان وكأنهم يبدعون من جديد، أو يقومون بأقل من ذلك بكثير؟الإجابة عن سؤال كهذا لم تتغير منذ ألفين ومئتين عام، تلك التي فهمها أرسطو ومن جاءوا بعده، فقالوا: يروي المؤرخون أحداثًا فعلية قام بها الإنسان. فالتاريخ قصة حقيقية. هذه الإجابة، تبدو أول وهلة لا شيء”1.
انطلاقًا من هذا التفكير، في فرضية معنى التاريخ وفي كيفيات كتابته وقصته الكبرى في التفكير البشري، واقترابًا من زاوية علاقته بالتخييل المكون للتاريخ، يتجه نظرنا إلى محاولة اقتحام سؤال معرفي، يلامس قارة التاريخ وقارة التخييل، في بنيتهما السفلى، حيث السطح تحركه الأعماق، من خلال الاشتغال على أحد الأعمال الإبداعية الكونية الكبرى، الإلياذة والآوديسة لهوميروس. توجهنا في هذه المحاولة البحثية، عدة أسئلة وفرضيات، تشكل نسغ فكرتنا في الموضوع، وهي كالآتي:
أولًا، هل يمكن أن نتخيل نصوصًا، تكون تاريخًا وأدبًا في نفس الوقت؟ هذا التحدي لن يكون له معنى إذا لم يخلق لنا أشكالًا جديدة. ويمكن أن يكون التاريخ والأدب شيئاً آخر، الواحد للآخر، كحصان طروادة2.
ثانيًا، هل هناك تعارض بين التاريخ والتخييل؟ قد يكون التاريخ في هذه الحالة، أحداثًا ووقائع، وقعت في زمن أو أزمنة ما. تتم روايتها أو كتابتها بشكل ما، يغلب عليه السرد، وينحو نحو رواية الحقيقة، كما وقعت، أو كما يتمثلها مؤرخ يستند لأي رواية على رؤية ما، وقد يمارس عليها نوعًا من النقد التاريخي، على الواقعة أو الحدث المدروس، بما يضفي عليها جانبًا من الموضوعية. وهنا قد يمارس نقضًا لكل الروايات التي قد تضفي عليها جانبًا من التدخل الذاتي، والتخيل العاطفي، انطلاقًا من محموله الإديولوجي، في توليف أو كتابة الرواية/ الحدث. بمعنى محاولة لإزالة كل ما يدخل في خانة اللاوعي التاريخي، التي قد تشوش على الهندسة الموضوعية للحدث المدروس. وهذا قد يتجلى بشكل كبير في النصوص ذات العلاقة بالتاريخ الديني، مثل المناقب والتراجم والكرامات والخرافات والمعجزات والأساطير وغيرها.
ثالثًا، هل يمكن إقصاء التخييل أو الخيال من التاريخ، نظرًا لانتسابه إلى عالم الأدب، ولأنه قد يبعدنا عن الحقيقة التاريخية، كما يشتغل عليها المؤرخ المحترف، أو الأكاديمي، الذي أصبح منهجسًا بالمنهج أكثر من الموضوع، وبالتأليف التاريخي أكثر من اهتمامه بالفكرة، والدلالة والمعنى. ولربما الاهتمام بالعلاقة بين الخيال والتاريخ اليوم، هي عودة إلى مصادر أخرى، ونحو أفق آخر لكتابة التاريخ، التاريخ المنسي، أو الغميس، فرضتها أسئلة التاريخ الراهن، الذي لا يكتفي بالوثيقة، أو بالخيار الوضعاني في التاريخ، بقدر ما يشتغل بأدوات الأنثربولوجيا والسيميولوجيا والنقد الثقافي وتحليل الخطاب، وفق استبيان تاريخي واجتماعي، يستحضر كل العناصر والعلامات والمؤشرات لكتابة الواقع المدروس في الزمن.
رابعًا، يركب سؤال الشعري والأسطوري والتاريخي، في علاقة الذات بالوجود، من خلال سؤال تجربة الزمن شعريًا، كما يقدمها هوميروس في الملحمة، وفيما استعرضه في قصص وأساطير الإلياذة والآوديسة، من خلال كتابة المتعالي والعجائبي، في علاقة الآلهة بالحدث الأسطوري، وفي كتابة تاريخ البحر، وتاريخ الإغريق القديم. وذلك عبر عنصر الكتابة في التأليف التاريخي. وهو ما يتشكل بواسطة السرد التخييلي والسرد التاريخي معًا، ليس فقط على مستوى رصد تحولات البنى في الزمن، ولكن بالأساس على مستوى البناء اللغوي والحبك التاريخي، كما يقول بول ريكور.
خامسًا، هل يمكن اعتبار علمية التاريخ، بسعيه نحو الموضوعية، ونهجه نحو عقلنة الحدث التاريخي، وتنويع مصادره ووثائقه، وتعدد إحالاته، دليلًا على تحول الحقيقة التاريخية من الأسطورة إلى التاريخ، من التخييل إلى التفسير؛ وهو كسب رهان الإقناع المتبادل وتطور في برنامج الحقيقة، من السماء إلى الأرض، من الطبيعة الإلهية إلى الفعل البشري؛ وهو ما يجعل تجربة الزمن تتحول في وعاء الصيرورة وليس في الثبات، من وهم الخوارق إلى إرادة الحقيقة التاريخية.
أولا: التاريخ والتخييل نحو تبادل وظيفي بين الذات والتاريخ
يؤكد “بول ريكور” ويصر على أن للخيال القدرة على نقل وتمثيل الممارسة الواقعية، إلى حد أن النص الخيالي يستهدف واقعًا نسميه عالَماً. هكذا، تنقل الأخيلة الواقع الإنساني باختراعها عالمًا ممكنًا يتقاطع مع القارئ.فالخيال الذي يفرق السرد عن التاريخ على مستوى المرجع، يعود فيجمعهما على مستوى الأسلوب. وكون مرجعية التاريخ واقعية لا تعني استغناء المؤرخ عن الخيال، بل هو في حاجة أكثر من غيره إلى آلة الخيال لإثبات واقعية الحدث التاريخي. فبفضل صيغته السردية يشبه الخطاب التاريخي تلك الخيالات الأدبية، مثل الملاحم والروايات، ولرولان بارت ومدرسة الحوليات الحق في التأكيد على هذه المتشابهات. وهو ما يؤكده ريكور الذي يرى بأن مشكلة التقاطع بين التاريخ والخيال ما كانت لتناقش، لو لم يكن بين رواية التاريخ ورواية الخيال تبادل وظيفي3.
وما يشكل قيمة معرفية كبرى في عمل هوميروس، هو كيف تبني الذات نفسها قصتها، انطلاقًا من محكي الذاكرة الشفوية ومن خلال وقائع تاريخية يمتزج فيها التاريخي بالأسطوري، في زمن يغلب عليه الطالع البطولي، كما تبلوره ملحمة الإلياذة والأوديسة. وحيث يمكن الفصل بين محكي التاريخ الذي يبحث عن “الحقيقة” في الحدث، وبين المحكي السيرذاتي لأوديسيوس، وذلك من أجل تأويل ما وقع في الماضي من أجل فهم الذات في الحاضر4.
وإذا كانت الأسطورة تشكل متخيلًا سرديًا يشكل هويتها كعمل تخييلي، فإن المتتبع لمحكي الأسطورة، يستخلص توق هوميروس في بناء هوية أمة الإغريق، كأمة قوية لها تاريخ وعقائدها وطقوسها، تشكل عبقريتها بها تنحاز إلى اختيارات فكرية واجتماعية وفلسفية. كما أن تبلور وتميز هويتها الملحمية السردية، تشكل استعادة بعدية لتاريخ منسي، وبحث دؤوب عن المعنى، لأحداث أصبحت معلومة في الزمن5. وبهذا تصبح الملحمة كعمل إبداعي يمثل هوية سردية للتاريخ الاغريقي، بمكون خيالي يضفي على الفاعل التاريخي، في الملحمة، في مختلف حكاياتها وسرودها، دفئا إنسانيًا وحضورًا معرفيًا لتاريخ ومجال بلاد الإغريق.وبذلك يصبح الزمن إنسانيًا عندما يمتزج التاريخ بالتخييل6.
إن نص الملحمة، كما يقدم كنص إبداعي وفكري، وإن يصعب إثباته بالوثيقة والمستند كعمل تاريخي، لا يمكن أن يتنكر للمحكي، وهو السبيل إلى بلورة “الحقيقة” التاريخية في وقائع النص الملحمي، لأن مرجعيته لا تحيل على موضوعية مطلقة، بل تساعد على بناء الحدث، من قلب أحداث متخيلة بحبكة تعبيرية ترقى إلى استعادة المعنى الذي قد يغيب عن المعنى التاريخي المجرد.
فالحديث حول الحروب، والمغامرات والعلاقات الإنسانية، قد لا يقبل بها المؤرخ، ولكنها قد تكشف لنا عادات الناس ومعتقداتهم ومعيشهم اليومي، ومخيلهم من العقائد والأساطير والحكايات، والتي تتخذ شكل محكيات كما صاغها هوميروس، قد تختلط بوقائع التاريخ. لذلك، وكما قال بول ريكور، لا يمكن للتاريخ أن يكون مفصولًا عما يسميه “التقاطع المرجعي” بين ادعاء الحقيقة في التاريخ وبين ادعاء الحقيقة في التخييل. لذلك لا وجود لحدث مطلق يشهد عليه خطاب تاريخي.
ثانيا: ملحمة الإلياذة والأوديسة، مصادر المعرفة وعلامات الكتابة
إن السجالات التي تدور حول هوميروس والكلام المكتوب، تروي كيف يبدو تملك علامات الكتابة ملحقًا طبيعيًا لهجمة العقلانية التي يشهد عليها-بكثير من البداهة أو بقاياها-تأليف الإلياذة والأوديسة. هنا يقع التأويل التاريخي للذاكرة الملحمية في فخ افتتانه بالتناغم، ذلك المفهوم المزيف الذي يكتفي بتسجيل غياب التنافر بين أجزاء مقولة أو كتاب، دون أن يلقى احتجاجًا إلا من نقيضه الهزيل، أي من غياب الترابط المنطقي الذي يكاد يكون مرادفًا للجنون7.
وكل ما قاله هوميروس والشعراء الآخرون وجه من أوجه الفكر الإغريقي يتعين التوقف عنده. لقد كان في وسع المفكر، إذا أراد أن يبرهن على شيء أو يقنع بحقيقة معينة، أن يسلك طرقًا ثلاثًا على أقل تقدير: الأولى، أن ينشئ استدلالًا يشهد له بالدقة والإحكام، الثانية أن يؤثر في مشاعر السامع بالبلاغة، والثالثة أن يستند إلى مرجعية هوميروس أو أي شاعر آخر قديم8.
الملحمة مصدر للمعرفة الإنسانية
تشكل الإلياذة والأوديسة أحد أهم الأعمال الإبداعية الكبرى التي عرفها التاريخ البشري، إذ تعتبر مصدرًا معرفيًا ينهل منها كُتّاب المسرح وعلماء التاريخ والاجتماع واللغة. ولا تكمن أهميتها فقط في اعتبارها مصدرًا للمعرفة الإنسانية، ولكن لأهميتها في رصد مختلف تمثلات الفكر الإغريقي، حول علاقة الإنسان بالطبيعة، وبالعلاقة المفارقة بينه وبين الآلهة في الصراع حول إثبات الوجود، وفي تجسيد إرادة الحقيقة البشرية، من خلال علاقات القوة، التي يجسدها أسلوب السرد في الكتابة، من خلال كفاية الحبكة للربط بين حقيقة الأنسان ووجوده بالمزج بين التخييلي والسردي في صوغ الملحمة وأبعادها الدرامية. هذه العلاقة التي تجسدها أهمية المكان في صنع أحداث تاريخية لها رمزيتها الحضارية والثقافية، داخل المجال الإغريقي المتوسطي، الذي يشكل فضاءها الجغرافي ومتخيلها الأسطوري.
وإذا كان الواقع يثبت اختلاف الباحثين والمؤرخين حول شخصية مؤلفها، وحول زمن تأليفها، فإن ما يتم الاتفاق عليه هو ارتباطها بشخصية فريدة، وهو تأليفها من طرف الشاعر هوميروس في القرن التاسع قبل الميلاد. شاعر يصير بالنفس البشرية وبعلاقات الأنسان المتشابكة وأعماقه، إلى الدرجة التي جعلت أبطاله تمهيدا قويا لظهور أبطال المأساة والتراجيديا العظيمة الكبار.
الإلياذة والآوديسة: غضب أخيل وفكرة العودة
فالإلياذة، كما تُقدَّم في نص هوميروس، تحكي قصة حرب طروادة التي دمرتها القبائل الأيونية والأيولية والدورية، في حروب امتدت قرنا بكامله 900 ق.م. تعود حسب ثنايا الملحمة، إلى المنافسة على التجارة والسيطرة البحرية على جزر بحر إيجة وعلى سواحل الأناضول وشمال اليونان. كما تعود في بعض أسبابها إلى اختطاف الملكة الإغريقية هيلين على يد الأمير الطروادي “باريس”. كما أنها تحكي قصة “غضب أخيل” في العام الأخير من الحرب.
وما يميز نص الإلياذة عند قراءته بناؤه الفني الذي يتلاءم والتسلسل الطبيعي للزمن، إذ يحاول إبراز تسلسل أحداث الملحمة، بحيث لا يخل بحبكتها الرئيسة، وبأسلوبها وشعريتها الملحمية، مما يجعلها أقرب ما يكون الى أسلوب الشعر الكلاسيكي، الذي كتبت به في الأصل وترجمت الى اللغات الأخرى.
والملحمة (الإلياذة) مثلها مثل السير الشعبية العربية، كسيرة بني هلال أو عنترة، أو سيرة الظاهر بيبرس، تقوم على حكاية رئيسة من حكايات الحرب ترتبط بأحداث الحرب كلها بالحياة الواقعية التي يعيشها الشعب أو الشعبان المشتبكان في الحرب.
هكذا يربط هوميروس بين حرب طروادة وحكايته الرئيسة، حكاية غضب أخيل من أكبر ملوك الإغريق وقائد حملتهم على طروادة الملك أجاممنون9.
كما أن الملحمة لا تقف عند حكاية قصة الحرب، كتمثيل تاريخي لواقع الإغريق آنذاك (9 ق.م)، ولكنها في تأليفها تربط بين أحداث الحرب وحياة الإغريق والطرواديين، من حيث صور الحضارة الإغريقية، وأساليب ممارسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية(الحب -النزال-الحوار) طقوس الزواج والعبادة ودفن الموتى وممارسة الألعاب الرياضية (الألعاب الأولمبية) وإقامة المآدب، وغيرها10.
أما الأوديسة فتعتبر واحدة من أهم الآثار الإنسانية العظيمة في التراث الأدبي العالمي، وهي -بإجماع النقاد- أكثر عمقًا ونبلًا ورقة من سابقتها (الإلياذة) لما تشتمل عليه من فضائل حضارية وقيم إنسانية مثل النبل والوفاء والخير والشجاعة.وإذا كانت الإلياذة تعالج حادثة تاريخية حقيقية مثل حصار طروادة، فإن الأوديسة تعالج حادثة يغلب عليها الطالع الحربي11.
وموضوع الأوديسة عودة (عوليس/أوديسوس) من حرب طروادة بعد انتهائها بعشر سنين، وفي غيبة (أوديسيوس) تنافس أمراء جزيرة إيثاكا للظفر بزوجته (بنلوب)، والتي كانت تتعلل بضرورة عمل كفن ا(اوديسيوس)، ولكنها كانت تنقض ليلًا ما تنسجه بالنهار. وفي طريق عودة (أوديسيوس) تصادفه مخاطر وعقبات كثيرة، يستطيع بدهائه أن يتغلب عليها ويتعرف على ابنه (تيلماكوس) ويتعاهدان على التخلص من أمراء الجزيرة. ويفترض بورخيس أن الرجل أو المرأة، مثلما كان يرى صمويل بتلر، الذي كتبها بالإنجليزية، لم يكن يجهل أنها تتضمن في الواقع قصتين: عودة أوليسيس إلى بيته وعجائب البحر ومخاطره. فالمعنى الأول يتضمن أو يحيل على فكرة العودة. فكرة أننا نعيش في الصحراء، وأن بيتنا الحقيقي هو في الماضي أو في السماء أو في أي مكان آخر، وأننا لسنا في بيتنا مطلقا12. والفكرة الثانية هي أننا عندما نقرأ الأوديسة نشعر بالافتتان بالبحر، سحر البحر. وبذلك تكون لنا قصتان في قصة واحدة، تعني عودة إلى البيت وقصة مغامرات. قصة ملاح يبحث في أعالي التيارات المالحة13.
الشاعر راوية حكايات
كان القدماء عندما يتكلمون عن شاعر-خالق- لا يعتبرونه مجرد شاعر فقط، وإنما يرون فيه كذلك راوية حكايات، حكايات يمكن أن نجد فيها كل أصوات البشرية، ليس أصوات الغنائية والتأمل والكآبة فقط، وإنما كذلك أصوات الشجاعة والأمل. وهو ما تمثله الملحمة كأقدم أشكال الشعر. وهو ما صاغه هوميروس في قصة طروادة بطريقة سردية قديمة. قصة رجل غاضب يروي فيها قصة رجل بطل يهاجم مدينة يعرف أنه لن يقتحمها ابدًا. رجل يعرف أنه سيموت قبل أن تسقط المدينة ولكن القصة الأكثر تأثيرًا-حسب بورخيس- هي قصة الرجال المدافعين عن مدينة يعرفون مصيرها مسبقًا، مدينة آخذة في الاحتراق. أنا أظن هذا هو موضوع الإلياذة الحقيقي14.
ثالثا: الخطاب السردي والتمثيل التاريخي
إن حقيقة أن السرد هو شكل الخطاب الشائع للثقافات “التاريخية” و”غير التاريخية”، وأنه هو المهيمن في الخطاب الأسطوري والتخييلي على حد سواء، يجعله موضع اتهام كطريقة للتحدث حول الأحداث “الواقعية”15.
التاريخي والتخييلي في ملحمة هوميروس
في صميم المعرفة التراثية تشكل الملحمة الهوميروسية موسوعة المعارف المشتركة، ولم يعبر هوميروس فقط عن المواضيع الأهم وهي الحرب وقيادة الجيوش وإدارة الدول وتربية الإنسان، لكنه يبدو متعمقًا أيضًا في جميع الفنون، هناك الشعائر بتفاصيلها والإجراءات القضائية وسلوك وممارسات القربان وأنماط الحياة العائلية والعلاقات مع الآلهة، وحتى المعلومات الكاملة عن طريقة بناء السفن.إن آلاف الأبيات التي تشكل الإلياذة والأوديسة مليئة بالمعلومات وأن هوميروس يتولى مهمة تعليمية لا مثيل لها16.
وعلى عكس فينلي الذي يسعى إلى العثور على الواقع التاريخي عبر إقفال الذاكرة الهوميروسية على عقلانية واعية، فإن هافلوك لم يشأ قط في مشروعه مدخل إلى أفلاطون(1969) أن يستخدم التاريخ في دراسة الملحمة، أو أن يحاول إقناع نفسه بأن الأوديسة تروي حكاية تقع تحت السيطرة التامة لدرجة أنها تجعل مجتمعًا شفافًا ينبثق من تحت زبد أسفار عوليس التائهة.
لأن هوميروس في نظره بطل يحمل الاسم نفسه ويمثل نظامًا ثقافيًا فسيحًا، وهو بطل نسي الماضي وتخلص منه، لكنه انغمس في أعماق الحاضر. إنه شبيه نهر عظيم تتسرب مياهه بين أسوار ميسينيا وأوائل جادات الحاضرة، لكنه انبثق جوابًا عن شتات افتتحه انهيار حضارة حكائية، وولد من إرادة الشعوب ذوي اللغة اليونانية، في اكتساب هوية عبر اللجوء إلى تكرار حكاية تقاليدهم وتراثهم المشترك بطريقة يستحيل نسيانها17.هل يعقل أن يكون الشعراء قد اختلقوا الميثولوجيا إرضاء لهوى عابر؟ أيعقل أن تكون المخيلة عبثية وتافهة؟ لا يكفي أن نقول مع أفلاطون إن الأساطير يمكن أن تكون تهذيبية إذا أحسنا انتقاءها.لقد اعتبر سترابون أن لكل أسطورة هدفًا تثقيفيًا، وأن الشاعر لم يكتب الأوديسة بهدف التسلية، ولكن ليعلم الجغرافيا. وهكذا جاء المرء على الإدانة العقلانية للخيالي والحكم عليه بالبطلان بالدفاع عن الخيالي بحجة تطابقه مع عقل خفي، لأن الكذب مستبعد18.
وإن أسفار عوليس درسٌ في الجغرافيا كل ما فيه حقيقي، والرواية الأسطورية التي تقول إن مينرفا وُلدت من رأس جوبيتر تؤكد بحسب كريزيس أن التقنية تنتقل بالكلام الذي مركزه الرأس. إن الأسطورة حقيقية ولكن بالمعنى المجازي19.
هل فعلًا يختلف سرد أحداث الماضي الذي خضع في ثقافة الغرب منذ أيام الإغريق لضوابط العلم التاريخي المرتبطة بمعيار “الواقعي” الكامن فيها والمبررة بمبادئ العرض “العقلاني” في خاصية محددة أو سمة مميزة لا يرقى إليها الشك عن السرد الخيالي كما نجده في الملحمة والرواية والمسرحية؟20.
رواية المؤرخ والحبكة التاريخية
عند رواية المؤرخ قصة، فإنه يكشف بالضرورة عن حبكة، هذه الحبكة “تحول الأحداث إلى رموز”. وذلك بالتوسط بين مكانتها على أنها موجودة “داخل الزمان” ومكانتها بصفتها مؤشرات على “التاريخية” التي تشارك فيها هذه الأحداث. وبما أنه يمكن التاريخية أن يشار إليها وحسب، وألا تمثل بشكل مباشر،فإن السرد التاريخي تجميع البنى الرمزية”يقول شيئًا آخر غير ما يقوله وبالتالي يشدني لأن من صلب معناه هو قد خلق معنى جديد”21.
وبذلك فالسرد التاريخي عبارة عن تحويل التجربة “داخل الزمان” الذي تشكل البنية الرمزية معناه التصويري. أي يعبر السرد عن معنى “غير المعنى” المعبر عنه في الإخباريات، وهو تمثيل عادي للزمان الذي تحدث فيه الأحداث22.
إن حبك المؤرخ الأحداث التاريخية من منظور الحاضر لا يمكن أن يكون نتاجًا للحركة التخييلية التي يتمتع بها كاتب الأعمال التخييلية. يجادل ريكور بأن الحبك التاريخي نشاط شعري، لكنه ينتمي إلى الخيال “المنتج” (الكانطي) وليس إلى الخيال الذي يعيد الإنتاج، أو ببساطة الخيال “الربطي” لكاتب الأعمال التخييلية، لأن الخيال المنتج هو الذي يعمل على صنع أحداث تاريخية بشكل لا يقل عن عمله في حبكها أو إعادة صياغتها، وهو واجب المؤرخ الذي يقوم به23.
ويعتقد ريكور أن السردية في التاريخ تؤدي للتوصل إلى فهم الأحداث التي تتحدث عنها أكثر مما تؤدي إلى تفسير لا يعدو كونه نسخة مخففة لذلك النوع الموجود في العلوم الإنسانية والاجتماعية.إنه لا يقيم معارضة بين الفهم والتفسير، حيث إن هذين الشكلين من المعرفة يرتبطان “ديالكتيكيا” على ما يعتقد، بوصفهما الوجهين “غير المنهجي” و “المنهجي” للمعرفة التي تتعامل مع الأفعال (البشرية) لا مع الأحداث الطبيعية24.
ومهما قال وايت حول التفسير بواسطة الحبكة التاريخية، التي تربط إبيستمولوجيا التاريخ بالقصص، وتقوم عليها إشكالية الموضوعية والبرهان، ومهما قيل عن الافتراض المسبق لـ”شعرية خطاب تاريخي” هو أن القصص والتاريخ ينتميان إلى الفئة نفسها، بقدر ما تعلق الأمر ببنائها السردي.هذا الجمع بين التاريخ والقصص يترتب عليه جمع آخر بين التاريخ والأدب معًا. ويميز وايت شعرية كتابة التاريخ هذه “ما وراء التاريخ” عن إبيستيمولجيا متجهة إلى خواص البحث في التاريخ، وبالتالي مثبتة على شروط الموضوعية والحقيقة، التي تمثل الأرضية للقطيعة الإبستيمولوجية، بين التاريخ بوصفه علمًا والسرد التقليدي أو الأسطوري25.
رابعا: الملحمة بين زمن الأسطورة وزمن التاريخ
من المؤكد أن ما يميز الملحمة هو عدم ضبط تاريخها، بالرغم من الاحتفاظ عند كتابتها، أو عند إعادة صياغتها، وبخاصة باللغة العربية، على تسلسل أحداثها، مما يحافظ على حبكتها السردية. لكن يجمع أكثر النقاد ومؤرخي الأدب أن أحداث الإلياذة وقعت حوالي منتصف القرن الثاني عشر قبل الميلاد، ولكنهم يختلفون حول شخصية هوميروس نفسه. بعضهم يقول إنه لم يكن هناك شاعر بهذا الاسم أصلًا. وبعضهم يقول إن هوميروس عاش في القرن التاسع قبل الميلاد.أما هيرودوت فيقول: إن هوميروس كان من مدينة خيوس القديمة في ولاية يونانية على ساحل الأناضول اسمها أيونيا ويقول: إن هوميروس عاش في القرن السابع قبل الميلاد26.
واختلاف الروايات في تحديد زمن الملحمة وفي شخصية كاتبها هوميروس، هو ما يميزها كنص ملحمي، يتقاطع فيه الأسطوري بالوهم التخيلي، والبعد التاريخي. ما يشكل مفارقتها في عدم تحديد الحدود بين الواقع والخيال، بين خطاب الملحمة، وصعوبة تمثل حقيقتها التاريخية، من حيث أحداثها التاريخية، وزمن وقوعها. فالزمن الملحمي، هنا زمن لا تعرف بدايته، لأن يبدأ بالحكاية، وبمضامينها الغرائبية والأسطورية.
فهل يمكن أن نعتبر الأسطورة نصًا “تاريخيًا”، أقصد مرجعًا في التاريخ لفترة زمنية، ولواقع تاريخي، له منطقه وله حوامله الثقافية، قد يكون تاريخ وواقع الإغريق في أزمنة ما قبل الميلاد.
قد نعتبر الأسطورة، نصًا للمؤرخ، وليس تاريخًا يمارس فيه المؤرخ نقده ونقضه المنهجي، ويقوض ما به من آراء وأحكام. كما يمارس عمله المؤرخ في تعامله مع مختلف النصوص والروايات والوثائق والمصادر والآثار.
قد يجد في الأسطورة، الباحث في التاريخ، ما يبني به فرضياته في قراءة الفكر والواقع. قد يستعمل فيها العقل وقواعد العلم التاريخي، وقد يحدد فيها إحدى سلاسل صيرورته الفكرية والمنهجية. ليس التاريخ بحثًا في المجتمع فقط، كما أرسته الحوليات، لاندراجه في برنامج الحقيقة الثقافية لمدرستها، ولأسئلتها في علاقة الدولة بالمجتمع، الوعي بالتاريخ، من خلال التتبع والتحول والاتجاه؛ ولكنه أيضًا بحثًا فيما تضمره الطبيعة من بنيات وتصورات، وما تفرزه الثقافة من تمثلات ثقافية وأخلاقية، تحتفظ بالماضي والموروث والخيالي والعقلي. وتكشف عن المتحول في تمثل الزمن والتاريخ. ولعل اعتماد الأسطورة كبنية ثقافية، تكشف الأساس العقلي والثقافي للمجتمع الحالي، ولعلاقة الذات بالآخر وبالعلم.
زمن الأسطورة وزمن التاريخ، ليس تمييزًا بين زمن يبحث في الأصل وفي البداية. في أصل التاريخ الأوربي، أو الفكر الغربي وفي بعده الفلسفي والسياسي. في العودة إلى الميتافزيقا كما يفهمها البحث الفلسفي، وفي كرونولوجيا الفكر الغربي، ارتباطًا بالتحقيب الكلاسيكي الأوربي العام.وما استتبعه من تحقيب جديد يرتبط، حسب “ميشليه”، بمفاهيم النهضة والحداثة. كما أنه لا ينتصر إلى مرجعية التاريخ، في التوقيت والاستمرارية والتحول. والارتباط بين الفكر والواقع، باعتبار أن اعتماد الفكر واستخدام العقل، هو تحول نوعي في علاقة الإنسان بالطبيعة وبالله، وبنفسه. كما ما يميزه كإنسان هو دوره في التفكير وفي التغيير، وفي السيطرة على الطبيعة. وأن زمن التاريخ، وإن تطور في تعريفه للحدث التاريخي، في مصادره وفي مناهجه وفي فهمه للإنسان، ولعلاقة الإنسان بالعالم.
الزمن هنا ليس وعاء لرصد الحدث في زمنيته الفيزيائية، وفي تطوراته، ارتباطًا بتحولات الحدث السياسي والاجتماعي. ولكن في كيفيات التمثيل التاريخي للحدث، ليس كوقائع، ولكن كعلامات ورموز ومؤشرات للحقيقة، ليس بمفهومها الفلسفي والتأملي النظري. ولكن في تحققاته في برنامج الحقيقة المعرفي، كيف يتبلور ويتجسد في النص والخطاب، من خلال علامات الكتابة وفي مستواها الأسلوبي والمجازي. بين البعد التخييلي في إضفاء العجائبي على الحدث. في المتعالي بين الإلاهي والفردي فيما تقدمة الملحمة من أساطير، من خلال علاقة السلطة الفوقية التي تمارسها الآلهة في توجيه الأحداث وشخوص الملحمة ومصائرها في حياة الحكايات. وفي كيفيات تصريفها من خلال حبكة يميزها الانتظام في الزمن والتمثيل التاريخي، وفي تحقق منطق القوة في الحرب وفي البحر. في الحب وفي مغامراته. بخلاف منطق التاريخ الذي يسوده اللانتظام والاضطراب والحروب. وتتحكم فيه منهجيًا النسبية وعلاقات القوى بين الأفراد والجماعات البشرية.
وأن كل معرفة بشرية هي معرفة الزمان ضمن شروط ظاهرة الوجود ولذلك لها علاقة مباشرة بين فكرة الزمان وفكرة الموت. وأن الهم الزماني هو مبرر الوجود حسب هايدغر وهو مفهوم تتلاحم فيه الانات الثلاث، الماضي والمستقبل قبل الحاضر من حيث الأهمية حيث يشكل نقطة التقاء بينهما. وهو ما يمكن أن تمثله صورة الإله جانوس في الميثولوجيا اليونانية.فقد جاء في الأسطورة أن جانوس يحمل وجهين أحدهما ينظر إلى الخلف والآخر إلى الأمام. أي إنه يحمل وجهي الماضي والمستقبل، الماضي الذي يتجدد في لحظة الولادة ويستمر في المستقبل ليلتقي به وراءه، وقد أصبح ماضيًا حتى يكف المستقبل عن الوجود في لحظة الموت. والمرآة التي تتلاقى فيها الرؤيتان تؤلف الحاضر أو الآن27.ألا تحمل ملحمة هوميروس هذا البعد في اعتبار الزمن كتلة واحدة تعبر عن انشغال الكائن بوجوده في العالم؟ ألا تمثل هذه الصورة رؤية هوميروس في الإلياذة والآوديسة، في غضبة أخيل، وفي حلم العودة لدى أوديسيوس؟
حين يلعب التاريخ دور الأسطورة
في مقالة سجالية موجهة ضد نقد العقل الديالكتيكي لسارتر، أنكر ليفي ستروس صحة التمييز بين المجتمعات “التاريخية” أو “المتحضرة” و “ما قبل التاريخية” أو “البدائية”. وبالتالي شرعية فكرة وجود منهج دراسي محدد وشكل تمثيل بنى وسيرورات المجموعة الأولى من وجهة نظر ليفي شتروس يصعب التمييز بين “المعرفة التاريخية” و”المعرفة الأسطورية” للمجتمعات “المتوحشة”. في الواقع فإن التاريخ الذي فهمه ليفي ستروس على أنه التاريخ التقليدي “السردي” لم يكن سوى أسطورة المجتمعات الغربية. وتكون محتوى هذا هذه الأسطورة من اعتبار طريقة التمثيل، أي السرد خطأ على أنها محتوى، أي فكرة عن الإنسانية متماهية على نحو فريد مع تلك المجتمعات القادرة على تصديق أنها كانت عاشت تلك الأشكال من القصص التي رواها المؤرخون الغربيون عنها28.
بل إن الكثير من أشكال السلوك الإنساني والكثير من الطقوس الاجتماعية تستعصي على الفهم إن لم نردها إلى أبعاد أسطورية لم يستطع الإنسان التخلص منها. فهي وحدها تمكننا من تفسير ميلنا إلى تسلق الجبال أو العبث بالماء في الأنهار الكبيرة أو الاستحمام في البحر، وهي التي تجعلنا نقبل كل ما يقال في عوالم التخييل29.
الشعر والأسطورة: الشعر مرآة لا إرادية وحقيقية
لعل قول الإغريق إن الشاعر هو تحديدًا من يروي الأساطير، يجد تبريره العميق في هذه المرجعية الذاتية لكل من الأسطورة والشعر الذين لا يستمدان سلطتهما من أي مؤلف، بقدر ما يستمدانها من تواتر الإشارات الميثولوجية في الأعمال الشعرية. بمعنى أن الشعراء كانوا يعكسون الأشياء في ذاتها، معبرين عن الحقيقة في مثل عفوية الينابيع التي لا يمكنها إلا أن تتدفق وتسيل30.
إن زمن الكاتب ليس زمنًا تعاصريًا، لكنه زمن ملحمي، فهو دون حاضر ولا ماض. قد يبدو غير حقيقي بنظر العالم، كما كانت روايات الفروسية بنظر “دون كيشوت”. لذلك ينمو هذا الزمن النشط للكتابة حتى يتجاوز ما يدعى دليلًا. والواقع أن الإنسان الملحمي، وحده إنسان الرحلات، الحب والمغامرات العاطفية31.
يأتي هوميروس ليروي في الإلياذة والأوديسة تاريخًا، لا نكاد نتوصل فيه إلى تبين الحدود الفاصلة ما بين الواقع والأسطورة. ويأتي سقراط وبعده أفلاطون ليخصصا مكانة للأسطورة في أعمالهما الفلسفية، لكن علينا أن نلاحظ هنا مع “مارسيل ديتيان” أن السياسة الوحيدة للأسطورة في حاضرة الفلاسفة هي “الإقناع والسحر والفتنة”32.
– وهو ما يتمثل في استعارة العمى في عمل هوميروس، في تبرير فهم طقوس الإلياذة والأوديسة، كاستعارتين للحياة أي الحياة كمعركة والحياة كرحلة، عملية دائرية تحدد علاقتنا بالفعل الشعري نفسه، فعل موجود وسط متتالية من التآويل، كما تحدد علاقتنا بعبقرية خلاقة جامعة من أقاصي الزمان. رجل لا يعبأ بكل المظاهر الدنيوية الخداعة، رجل قادر بسبب عماه على أن يرى الحقيقة وراء هذه المظاهر، حيث يتماهى مفهوم العمى مع نفسه. فأن تكون أعمى هو ألا ترى الواقع الخارجي. وأن الواقع الداخلي يدرك بصفاء أشد ما لم يعقه أي واقع آخر. فالشاعر عندئذ طليق في إدراك الكون بكليته: الماضي عبر ماضي قصته والمستقبل من خلال مستقبل شخصياته. بمستطاعه أن يصبح رائيًا ومحاسبًا معًا، عندما يقول هكتور لأندروماك في الإلياذة: “سيأتي يوم تفنى فيه طروادة المقدسة، ويفنى بريام، وأهل بريام ذوو رماح الدردار33.
علاقة الأسطورة بالدين
تكشف الأسطورة حسب بنكراد، عن بُعد في المعيش الإنساني من طبيعة قيمية منفصلة عن الواقع، فالإلهام الأسطوري، الواهب للمعاني، يكشف عن ممارسات في الكون توجد خارج توسط العقل، فالاستعانة بالأسطورة لا يحيل على حقيقة الأشياء، بل على حقيقة الإنسان وعلى روابطه مع العالم ومع الله. وهذا معناه أن الأوديسا والشاه نامة والكثير من المرويات لم تكن محكيات تصف خوارق أبطال لا يقهرون، بل كانت محاولة لتشخيص حكمة الحياة34.
ولأن عالم الإلياذة الذي تطابق زمنيته الحكايات وتختلط فيه الآلهة بالبشر، هو عالم الوهم التخييلي. فالفرق بين الواقع والوهم التخييلي ليس موضوعيًا قائمًا في الشيء ذاته، وإنما فينًا نحن الذي نراه من منطلقنا الذاتي وهمًا تخيليًا 35. وقلما يتعارض الوهم التخيلي مع الحقيقة التي ليست الا منتجًا فرعيًا، كما يتم تمثلها، حينما نفتح كتاب الإلياذة التي تنخرط في عالم الوهم التخيلي كما يقال.
وقد أثبتت الميثولوجيا الإغريقية أن صلتها بالدين هي من أكثر الصلات وهنا. لم تكن في جوهرها إلا نوعًا من أدب في منتهى الشعبية، بل رقعة أدل واسعة، أخص ما فيها الشفهية، لو أن كلمة أدب تصح في المرحلة التي تسبق التمييز بين الواقع والوهم التخييلي، يوم كان العنصر الأسطوري مقبولًا من دون ضجيج36.
الموقف النقدي من الأسطورة
إن الموقف النقدي، حسب “فاين”، لدى كل من بوسينياس وأرسطو وهيرودوت، يكمن في اعتبار الأسطورة تقليدًا شفهيًا ومصدرًا تاريخيًا يتعين إخضاعه للنقد37.ونرى في الأسطورة تضخيمًا ملحميًا لحدث عظيم، على غرار الغزو الدوري، لأن الأسطورة نفسها تمثل بالنسبة للإغريقي حقيقة حرّفتها السذاجة الشعبية، وما يشكل نواتها الأصيلة هو تلك التفاصيل الصغيرة والحقيقية، كأسماء الأبطال وأنسابهم، لأنها تخلو من كل عنصر غرائبي38.
وإذا ما اعترفنا أن القصص الأسطوري غالبًا ما ينقل ذكريات جمعية، وهي أن نعتقد بتاريخية حرب طروادة، أما إذا اعتبرنا الروايات الأسطورية أوهامًا تخيلية، فلن نعتقد بصحة وقوع هذه الحرب، وسنفسر بطريقة مغايرة ما يطالعنا في الحفريات الأثرية من معطيات شديدة الالتباس. فالحقيقة هي من الرحابة بحيث يحضن الأسطورة بارتياح، لكن الحقيقة تعني أشياء كثيرة، إلى درجة أنها تمثل الأدب التخيلي أيضًا 39.
إن الأسطورة يمكن اعتبارها أدبًا قبل الأدب، له خاصية أخرى هي كونها رواية، رواية مُغْفَلة، يمكن جمعها وتردادها من دون أن تصح نسبتها لأي مؤلف بعينه، وهو ما سيعلله المفكرون والعقلانيون ومنهم “تيوسيديد”، بكونها تقليدًا تاريخيًا. لقد كانت الأسطورة شيئًا آخر قبل أن تتنكر في زيّ حكاية تاريخية40. وهو ما يبرز في موقف العروي من الأسطورة، وفي اختلافها عن التاريخ. ذلك أن أساس صناعة المؤرخ في نظر العروي، هو أن يربط التاريخ-الوقائع- بالوعي الذي هو إنساني بالتعريف. نسمي ما قبل التاريخ الواعي أساطير لإنها تاريخ بلا وعي، رواية بلا نظر ولا تحقيق41.
خلاصات:
زمن الملحمة ليس هو زمن التاريخ، الملحمة نص إبداعي لا بداية لها أو نهاية، ولكنها تكثف الزمن في توتر الأحداث في الخارق والعجائبي والأسطوري، وزمن التاريخ هو زمن الحدث المستخرج من الوثيقة في الزمن، كتابة تقنية تستند إلى منهج المؤرخ ورؤيته إلى التاريخ، أي زمن الوعي بالتاريخ. أما الملحمة فعمل أدبي يرتبط بعالم الحروب والمغامرات حيث ينفتح السرد على مهمات مستقبلية، تاركًا القارئ متلهفًا في خِضم معارك تعترضها الآلهة. ولذلك يعتبر “مانغويل” الأوديسة قصيدة زائفة البدايات وزائفة النهايات، فعلى الرغم من التضرع الافتتاحي إلى ربّة الإلهام، وفيه يرجوها الشاعر لتغني له عن “البطل الداهية، الجوّاب دروب المنفى، مَنْ ضَلَّ الطريق مرة تلو الأخرى بعد أن نهب قمم طروادة المُكللة بأقدس الهالات42؛
إذا كان ثمة عنصر من التاريخ في كل الشعر، فثمة عنصر من الشعر في كل مسرد تاريخي للعلم؛ ولكن الاهتمام بالطبيعة الأدبية للسرديات التاريخية، حسب وايت، يذكرنا بأن هذه التمثيلات تتأثر بالقيود المفروضة على اللغة والتقنيات التي يستخدمها الكاتب لجعل الماضي ذي معنى؛
لا يبدو هناك أي فارق بين الخيال والحقيقة الواقعة، بل إن التمييز بينهما ليس واضحًا كما يبدو لأول وهلة؛ وعمل المؤرخ هو مزيج من التخيل الروائي والحقيقة، لأنه يضع الأحداث في “سردية” ما تتطلب استعمال التقنيات الأدبية؛ وفي هذا الإطار لم يتردد ريكور في النظر إلى كل المحكيات، والأساطير التي خلفها الإنسان وراءه باعتبارها وقائع يجب أن تصنف ضمن التاريخ. فهوية الإنسانية من طبيعة سردية، إنها لا تستمد وجودها من وقائع فعلية فقط، بل هي أيضًا حاصل ما ينتجه الناس في التخييل43؛
إن القصص والحكايات، التي ترد في ملحمة الإلياذة والآوديسة، وكما يصفها هوميروس، ويستبصرها، هو الأعمى، كما يرد في أغلب الروايات، هي محايثة كتابة واقع الشاعر في كتابة المفارقة التي يعيشها شعريًا. فكل الشعر في الحقيقة يتحرك في عنصر المفارقة التاريخية، بين حدث الماضي والروح الحديث. هل يعني الصدق للماضي تصويرًا طبيعيًا طبق الأصل للغة وأسلوب التفكير والاحساس بالماضي وأشبه بعرض للأحداث حسب تسلسلها الزمني؟ حيث الحروب والمغامرات والصراعات. ليست حربًا بين الخير والشر، أو بين الاستثناء والقاعدة، ولكنها تحدي الاستحالة، وعودة إلى حضارة أعلى للمدينة في التاريخ السياسي والفكري الإغريقي القديم؛
هل يمكن اعتبار الأسطورة مثلها مثل الإيديولوجيا في الدور الذي تقوم به، بالنسبة للجماعة البشرية؟ ذلك أن لها دورًا اجتماعيًا وتاريخيًا، كما يمكن استنتاجه من ملحمة هوميروس، وغيرها من الأساطير، في تفسير نشأة الكون، وفي المساهمة في تأسيس كيان اجتماعي ملتحم ومتكامل. وفي الكشف عن الأصول والنماذج التي تجمع شمل مجموعة ما. إذ إن كل مجموعة تاريخية لها أسطورة أو مجموعة أساطير تأسست بناء عليها. قد تكون في الماضي كإرث وعراقة، وقد تكون في المستقبل كأمل وطموح44.
الهوامش
[1]بول فاين، كيف يكتب التاريخ، ترجمة: سعود المولى ويوسف عاصمي، بيروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2020، ص. 10.
2 Ivan Jablonka, L’histoire est une littérature contemporaine, Paris, Ed. Du seuil, 2014, p. 7.
3جنات بلخن، السرد التاريخي عند بول ريكور، منشورات ضفاف، الرباط، 2015، ص. 86.
4سعيد بنكراد، الهوية السردية، المحكي بين التخييل والتاريخ، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، 2023، ص. 47.
بنكراد، الهوية، ص. 49.5
6بنكراد، الهوية، ص. 50.
7مارسيل ديتيان، اختلاق الميثولوجيا، ترجمة مصباح الصمد المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2008، ص. 93.
8ديتيان، اختلاق، ص. 137.
9هوميروس، الإلياذة، ترجمة: دريني خشبة، دار التنوير للطباعة والنشر، مصر، 2014، ص. 8.
10هوميروس، الإلياذة، ص. 9.
11هوميروس، الإلياذة، ص. 11.
12خورخي لويس بورخيس، صنعة الشعر… ست محاضرات، ترجمة صالح علماني، منشورات الجمل، لبنان، 2019، ص. 73.
13بورخيس، صنعة، ص. 74.
14 بورخيس، صنعة، ص. 71-73.
15هايدن وايت، محتوى الشكل، الخطاب السردي والتمثيل التاريخي، ترجمة د. نايف الياسين، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة، 2017، ص. 142.
16ديتيان، اختلاق، ص. 96.
17ديتيان، اختلاق، ص. 94.
18ديتيان، اختلاق، ص. 136.
19ديتيان، اختلاق، ص. 93.
20وايت، محتوى، ص. 10.
21وايت، محتوى، ص. 134.
22وايت، محتوى، ص. 135.
23وايت، محتوى، ص. 371.
24بلخن، السرد، ص. 129.
25 بولريكور، الزمان والسرد، الحبكة والسرد التاريخي، ترجمة سعيد الغانمي، فلاح رحيم، مراجعة جورج زيناني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2022، ج. 1، ص. 282-283.
26هوميروس، الإلياذة، ص. 5.
27سركون بولص، الهاجس الأقوى عن الشعر والحياة، منشورات الجمل، بيروت، 2018، ص. 221.
28ايت، محتوى، ص. 96.
سعيد بنكراد، التأويل وتجربة المعنى، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، 2023، ص. 24.29
30ول فاين، هل اعتقد الإغريق بأساطيرهم؟ بحث في الخيال المكوِّن، ترجمة جورج سليمان، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة، 2016، ص. 143.
31رولان بارت، النقد البنيوي للحكاية، ترجمة أنطوان أبوزيد، كتاب الدوحة، الدوحة، 2019، ص. 12.
32ديتيان، اختلاق، ص. 14.
33ألبرتو مانغويل، فن القراءة، ترجمة جولان حاجي، دار الساقي، بيروت، 2016، ص. 124.
34نكراد، التأويل، ص. 25.
35فاين، هل اعتقد، ص. 57.
36 فاين، هل اعتقد، ص. 46.
37فاين، هل اعتقد، ص. 42.
38فاين، هل اعتقد، ص. 43.
39فاين، هل اعتقد، ص. 44.
40فاين، هل اعتقد، ص. 59.
41عبد اللهالعروي، مفهوم التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1992، ج.1، ص. 62.
42هوميروس، الإلياذة، ص. 221؛ مانغويل، فن، ص. 194.
43بنكراد، التأويل، ص. 27.
[1] بلخن، السرد، ص. 146.
المراجع
بارت، رولان،النقد البنيوي للحكاية، ترجمة: أنطوان أبوزيد. كتاب الدوحة، الدوحة، 2019.
بلخن، جنات،السرد التاريخي عند بول ريكور. منشورات ضفاف، الرباط، 2015.
بنكراد، سعيد،التأويل وتجربة المعنى، المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، 2023.
بنكراد، سعيد،الهوية السردية، المحكي بين التخييل والتاريخ. المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، 2023.
بورخيس، خورخي لويس،صنعة الشعر… ست محاضرات، ترجمة صالح علماني. منشورات الجمل، لبنان،2019.
بولص، سركون،الهاجس الأقوى عن الشعر والحياة. منشورات الجمل، بيروت، 2018.
ديتيان، مارسيل،اختلاق الميثولوجيا، ترجمةمصباح الصمد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2008.
ريكور، بول،الزمان والسرد، الحبكة والسرد التاريخي، ترجمة سعيد الغانمي، فلاح رحيم، مراجعةجورج زيناني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،ج. 1، 2022.
العروي، عبد الله،مفهوم التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،ج.، 1،1992.
فاين، بول،كيف يكتب التاريخ، ترجمة سعود المولى ويوسف عاصمي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2020.
فاين، بول،هل اعتقد الإغريق بأساطيرهم؟ بحث في الخيال المكوِّن، ترجمةسجورج سليمان. هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة،2016.
مانغويل، ألبرتو،فن القراءة، ترجمة جولان حاجي. دار الساقي،بيروت،2016.
هوميروس،الأوديسة، ترجمة دريني خشبة. دار التنوير للطباعة والنشر، مصر، 2013.
هوميروس،الإلياذة، ترجمة دريني خشبة. دار التنوير للطباعة والنشر، مصر، 2014.
وايت، هايدن،محتوى الشكل، الخطاب السردي والتمثيل التاريخي، ترجمة نايف الياسين. هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة،2017.
Jablonka, Ivan. L’histoire est une littérature contemporaine. Paris : Ed. Du Seuil, 2014.
 رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه
رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه