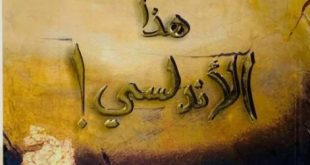قراءة في رواية الحواميم لعبد الإله بن عرفة
 تعتبر الرواية العرفانية نموذجا للنصوص الروائية التي تستلهم مادتها المصدرية من التاريخ وتعيد استثمارها وتشكيلها عبر آلية التخييل من أجل إنجاز بنائها الروائي. أفرز هذا التفاعل الحاصل بين الوقائع التاريخية والخيال الروائي مادة تاريخية تخلت عن وظيفتها التوثيقية والوصفية لصالح الوظيفة الجمالية، وتشكلت نتيجته هوية سردية جديدة، لا تبحث عن مدى مطابقة النص الروائي للمرجعيات التاريخية بقدر ما تبحث في طياتها عن العبر المتناظرة بين الماضي والحاضر وعن التمثلات الرمزية فيما بينهما[1].
تعتبر الرواية العرفانية نموذجا للنصوص الروائية التي تستلهم مادتها المصدرية من التاريخ وتعيد استثمارها وتشكيلها عبر آلية التخييل من أجل إنجاز بنائها الروائي. أفرز هذا التفاعل الحاصل بين الوقائع التاريخية والخيال الروائي مادة تاريخية تخلت عن وظيفتها التوثيقية والوصفية لصالح الوظيفة الجمالية، وتشكلت نتيجته هوية سردية جديدة، لا تبحث عن مدى مطابقة النص الروائي للمرجعيات التاريخية بقدر ما تبحث في طياتها عن العبر المتناظرة بين الماضي والحاضر وعن التمثلات الرمزية فيما بينهما[1].
تروم هذه الورقة تقديم بعض الإضاءات حول مشروع الرواية العرفانية، ومدى حضور البعد التاريخي في بناء النص العرفاني، والدلالات العرفانية التي توخى مبدع المشروع العرفاني الإشارة إليها من خلال توظيفه للقضايا التاريخية عبر آلية التخييل، وحدود التوثيق التاريخي والسرد الخيالي في هذا الجنس الروائي، وذلك من خلال تقديم قراءة في رواية “الحواميم”.
إفادات حول مشروع الرواية العرفانية -I
ارتبط مصطلح “الرواية العرفانية” بالأديب المغربي عبد الإله بن عرفة، الذي عرف بتأسيسه لمشروع أدبي جديد في الرواية العربية، يتبنى مفهوما خاصا في الكتابة، وهو مفهوم “الكتابة بأحرف من نور”[2]، يروم من خلاله تحيين وإعادة بناء الموروث الإسلامي، في شقه الروحي، انطلاقا من مداخل معرفية وجمالية ذات مرجعية قرآنية وصوفية، كما يسعى إلى ملء فراغاته وترميم ثقوبه عن طريق تعزيزه بالتوثيق التاريخي[3].
يستلهم بن عرفة لغة كتابته من معجم صوفي ينهله من قواميس شيوخ المتصوفة ومؤلفاتهم ودواوينهم الشعرية، لكن حجر الزاوية في لغته العرفانية يتمثل في مرجعيته القرآنية خاصة الحروف النورانية [4] المقطعة التي تمثل أسرار البناء الجمالي والقيمي لرواياته. فمشروعه الروائي قائم على الأبجدية الفواتحية القرآنية التي يبلغ عددها أربع عشرة فاتحة قرآنية، بإزالة المكرر منها، في مختلف أوضاعها، من مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، فهو يبتدئ الكتابة بأصغر جزء من اللغة، وهو الحرف، ليشيد انطلاقا منه مشروعه الروائي المتكون من أربع عشرة رواية تغطي الأربعة عشر قرنا التي مرت على ظهور الإسلام[5]، تمكن إلى حدود تاريخ كتابة هذه السطور من تأليف ثلاث عشرة منها.
قسم بن عرفة مشروعه العرفاني الفواتحي إلى مجموعة من السلسلات الفواتحية، بدأ السلسلة الأولى منه بالحروف المفردة، وهي القاف والنون والصاد، وألف انطلاقا منها كلا من رواية “جبل قاف” 2002، ورواية “بحر نون”2007، ورواية “بلاد صاد”2009. ثم انتقل إلى السلسلة الفواتحية الثانية والتي تفتتح بالحروف الثنائية: حم ويس وطس وطه، وألف من وحيها كلا من رواية “الحواميم” 2010، ورواية “طواسين الغزالي” 2011، ورواية “ابن الخطيب في روضة طه” 2012، ثم رواية “ياسين قلب الخلافة” 2013 ، أما السلسلة الثالثة والمتعلقة بالحروف الثلاثية ألم وطسم وألر فقد ألف باعتمادها كلا من رواية “طوق سر المحبة: سيرة العشق عند ابن حزم” 2015، ورواية “الجنيد ألم المعرفة” 2017 ورواية “خناثة ألر الرحمة” 2018، واعتمد الحروف الرباعية ألمص وألمر في كل من روايتي “ادريس ألمص الولاية” 2019، ورواية “ألمر أختام المدينة الفاضلة”2022، أما آخر رواياته، والتي تحمل عنوان” لا فتى إلا علي حم عسق” 2024 ، فقد ألفها انطلاقا من الحروف الخماسية حم عسق.
يعتبر بن عرفة الحروف القرآنية المقطعة الشخصيات الحقيقية في أعماله، لكونها تعكس حقائق معرفية وجدانية يهيمن عليها التخييل العرفاني، بينما لا تشكل الأعلام التاريخية التي تعيش في رواياته تجربة روحية ووجدانية في علاقتها بالله والعالم إلا تجليا لتلك الفواتح النورانية ومظهرا من مظاهر هذه الشخصية الكلية وترجمة لها في عوالم الإنسان[6]. ترتب عن ذلك وجود سيرتين في الرواية العرفانية سيرة تاريخية للبطل أو الشخصية الإنسانية، وسيرة عرفانية عليا للفاتحة النورانية يحققها الحديث عن تجلياتها في مختلف مراتب الوجود[7].
II– الرواية العرفانية بين التوثيق التاريخي والتخييل
يعرف عبد الإله بن عرفة مشروعه الروائي بأنه تغطية روائية شاملة لمجمل التاريخ الإسلامي، وفي الآن ذاته يؤكد أن رواياته ليست روايات تاريخية بل روايات عرفانية وجودية، لا تسعى إلى التركيز على الأحداث التاريخية بقدر سعيها إلى تمثيل المشاعر الكامنة والعلاقات التي تربط الناس والعوالم في جدلية السيرورة التاريخية[8]، فهو لا يكتب بحثا تاريخا بل يقتصر على توظيف بعض الأحداث التاريخية التي يعتبرها عناصر فاعلة في بناء نصه الروائي، ويعتمد آلية التخييل التاريخي التي تمكنه من ترميم الثغرات والفجوات وإبراز الهوامش المنسية وإضاءة الزوايا المعتمة التي تتجاهلها في الغالب الأعم الكتابات التاريخية التقليدية، ويهملها التاريخ الرسمي. فحينما تقوم الرواية العرفانية بتوظيف خطاب التاريخ إنما تجعله تكأة جمالية وفنية ليصبح بمثابة المعبر الذي تقدم من خلاله سردها الروائي، فلا يكون التاريخ مقصودا لذاته وإنما يوظف باعتباره تقنية فنية تقوم بوظيفة جمالية[9].
وهكذا فإن توسل بن عرفة بالتاريخ لا يتم بمنطق المؤرخ الذي يتناول أحداثا مضت، وينفي أية مسؤولية له عن الماضي وعن التفسيرات التي يدلي بها، بل بمنطق الروائي والأديب الذي يكتب عن الأحداث على أساس أنها حية وتعيش في وجدانه[10]. مما يجعله منخرطا في عملية التخييل الذي يؤدي إلى تسريد الحدث التاريخي وتحويله إلى بناء روائي، حاضرا فيه وشاهدا عليه، الأمر الذي يجعل ذلك الماضي مستمرا في الحاضر منفتحا على الآتي داخل ما ينتجه الفضاء العرفاني للرواية من إمكانيات معرفية وتقنيات كتابية ولغوية تستشير أسئلة الحاضر وهمومه[11]. وهذا ما جعل بن عرفة يتبنى “الشهادة بالحضور” مفهوما مركزيا يشكل عماد الرواية العرفانية ويحدد علاقتها بالتاريخ، فهو مفهوم لا يستحضر الحكاية التاريخية ويشيد مادتها البيوغرافية في صلة بشخصيات الرواية بغرض استعادة الماضي واستهلاكه نفسيا وجماليا من طرف القارئ، وإنما بهدف تحيينه باعتباره قضية ماثلة أمامه تخاطب وجدانه ومعرفته وخياله، أي أنه حين يكتب عن أحداث الماضي فإنه يكتب عنها وهو حاضر فيها، منخرط في نتائجها المستقبلية شاهد على ما جرى وما قد يجري. وهذا التصور الجديد للكتابة الروائية يمكن من تذويب وإقصاء الهوة الزمنية الفاصلة بين زمن الحكاية والزمن الراهن، ويفتح إمكانية المستقبل الكامنة فيها حينما يربطها بمآلاتها وسياقاتها الحالية وراهنيتها في القضايا المعاصرة[12]. فقضية من قبيل القضية التي تعالجها رواية “الحواميم”، والمتعلقة بمأساة الموريسكيين بعد سقوط مدينة غرناطة بين أيدي الإسبان، تحيل على فترة من أشد الفترات مأساوية في تاريخ الحضور الإسلامي في الأندلس، فهي مرتبطة باكتمال تطهير أوروبا الغربية من بقايا حضارة عمرت قرابة ثمانية قرون. وعلى الرغم من أن الحدث انقضى على مروره أكثر من خمسمائة سنة، إلا أنه لا يزال يمثل قضية حضارية عالقة لحد الآن، والمؤلف، حينما قام باستحضارها بمناسبة مئويتها الخامسة، يوجه صك اتهام حاضر ودائم، يطالب من خلاله إسبانيا بضرورة تقديم اعتذار للمسلمين عن الاضطهاد والظلم والتعذيب الذي تعرضوا له بعد سقوط آخر معاقلهم بالأندلس[13].
III – رواية الحواميم ضمن المشروع العرفاني
رواية الحواميم هي الرواية الأولى ضمن المجموعة الثانية من سلسلة الفواتح القرآنية المكونة من الحروف الثنائية، اشتق العنوان من “الحواميم السبعة” أو ذوات “حم”، وهي مسمى لسبع سور من القرآن الكريم، تبتدئ بحرفي الحاء والميم “حم”[14]. صدرت رواية الحواميم سنة 2010 بمناسبة الذكرى المئوية الرابعة على صدور آخر قرار لطرد الموريسكيين من إسبانيا بتاريخ 22 شتنبر 1609. يرمز المؤلف من خلال اختياره لحرفي الحاء والميم عنوانا لروايته لصراع الحياة والموت، فمدار المادة الحكائية السردية وشخوص الرواية وأسمائها وحواراتها يتمحور حول موضوع الصراع الدائم بين الحياة والموت الذي تشير اليه ثنائية الحاء والميم، يرمز بهما بن عرفة إلى دائرة متواصلة تمثل البداية عن النهاية في مبحث صوفي فلسفي عن معنى الوجود[15].
1- واية الحواميم بين التاريخ والتخييل
- البعد التاريخي في رواية الحواميم
بالرغم من كون البعد التاريخي يتموقع في مرتبة متأخرة عن البعد العرفاني في البناء السردي العرفاني، إلا أن ذلك لم يحل دون انفتاح بن عرفة على مناهج الكتابة التاريخية خاصة الحديثة منها، عبر توظيفه شبكة مفاهيمية مرتبطة بمناهج هذه الكتابة التاريخية، من قبيل التاريخ العالمي، والتاريخ الاجتماعي، وتاريخ المهمشين، والتاريخ المجهري.
– التاريخ العالمي: شكل حدث سقوط غرناطة سنة 1492، النقطة التي انطلق منها عبد الإله بن عرفة في بناء سرده الروائي، فسنة وقوعه تمثل “محددا زمنيا حاسما في التاريخ العالمي، وإعلانا مدويا وخالصا لانتصار أوروبا اقتصاديا وعسكريا وتقنيا، من وجهة نظر المؤرخين الأوروبيين، فقد آذنت هذه السنة بأفول مراكز الحضارات التقليدية القديمة بما في ذلك الحضارة العربية الإسلامية، وصعود الغرب الأوروبي وبداية سيطرته المطلقة على مجموع العالم في اتساعه الجديد بعد وصول المستكشف الإيطالي كريستوف كولومبوس لسواحل هذا العالم. شكلت هذه السنة أيضا منعطفا يقاس به التغيير الذي طرأ على الذهنيات، نتيجة التحولات الفكرية والاجتماعية التي عرفتها هذه القارة خلال عصر النهضة”[16]، هذه التحولات التي تطرق لها المؤلف في روايته عبر استعراضه لمجموعة من أفكار رواد الحركة الإنسية وعلى رأسهم الفيلسوف الهولندي إيراسموس، واستحضاره شخصية الأديب الإسباني ميكيل دي ثربانتس الذي يعتبر أول من كتب باللغة الإسبانية، وما يعبر عنه هذا الحدث من تحول على المستوى الثقافي والمتمثل في التخلي عن الكتابة باللغة اللاتينية لصالح اللغات الأوروبية المحلية. كما أفرد حيزا في الرواية للحديث عن أهم ظاهرة تمحورت حولها كل التحولات الفكرية لعصر النهضة الأوروبية، ويتعلق الأمر بحركة الإصلاح الديني وظهور المذهب البروتستانتي، وما أسفرت عنه من مخاض فكري أحدث شرخا داخل الكنيسة الكاثوليكية وأوروبا الغربية.
فعلى الرغم من كون بن عرفة تناول مواضيع تكرس هيمنة المركزية الأوروبية في مقاربة تاريخ العالم، إلا أنه تناولها من وجهة نظر أديب ينتمي إلى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط التي همشتها الكتابات التاريخية الأوروبية، ويقدم من خلال روايته تصورا لتاريخ ضفتي المتوسط من زاوية نظر تحاول تقديم مقاربة تاريخية منصفة وعادلة تعطي الكلمة للجزء الجنوبي لهذا البحر الذي يعتبر مجالا ينتمي إلى أطراف العالم، وتبرز مساهمته في تشكيل وتفسير المتغيرات والتحولات التي يعرفها العالم الراهن، وتساهم في تحقيق نوع من العدالة والإنصاف في تسجيل وتخليد منجزات المجتمعات مهما تواضعت مساهمتها في المنجز البشري[17].
-التاريخ الاجتماعي، على الرغم من كون الإطار العام لهذه الرواية هو عبارة عن تاريخ موثق للأحداث المفصلية الكبرى التي وقعت بين سنتي 1492 و1609، أي انطلاقا من تاريخ توقيع معاهدة تسليم مملكة غرناطة، مرورا بالأحداث المرتبطة بهذا المنعطف التاريخي من قبيل حدث إحراق الكتب، وثورتي البيازين الأولى والثانية، وصدور قرارات التنصير، والتشتيت الجماعي لأهالي غرناطة، ثم الترحيل النهائي لهم بعد صدور قرار الطرد الأخير. لكن بن عرفة، في مقاربته التاريخية الأدبية، أضاف، إلى هذا التاريخ الموثق، معالم تاريخ اجتماعي وثقافي يضم ملامح الملبس والمأكل والسكن والحمام والاحتفالات واللغة والأغاني والفتاوى الشرعية وعقود الزواج والأنشطة الاقتصادية والطقوس الدينية الإسلامية والمسيحية…، مشكلا بذلك نسيجا لحياة متخيلة لفئة اجتماعية شكلت أقلية دينية وعرقية عربية إسلامية داخل بيئة مسيحية كاثوليكية متطرفة هيمنت عليها قرارات وممارسات محاكم التفتيش.
-تاريخ المهمشين Subaltern Studies، إذا كانت معظم روايات بن عرفة تهدف إلى إحياء تراث شيوخ المتصوفة والفلاسفة المسلمين، لكونهم شخصيات ساهمت في البناء الحضاري للعالم الإسلامي، وتحيل على لحظات مشرقة من هذا التاريخ، فإن رواية الحواميم شذت عن تلك القاعدة، إذ قرر المؤلف الاشتغال من خلالها على فترة من فترات التاريخ المنسي والمغيب، وإحياء قضية إنسانية ومأساوية عاشتها أقلية مسلمة بإسبانيا لمدة استمرت أكثر من قرن. لم يكن هاجس المؤلف في هذه الرواية الاهتمام بالبارز من الأعلام الذين سجل التاريخ سيرهم، بل شغل اهتمامه الأناس العاديون من العامة والبسطاء، رجال ونساء وأطفال، فلاحون وثوار وقراصنة وأسرى وسجناء. انخرط بذلك الأديب في تيار تاريخي يهتم بالمهمشين ويتبنى منظور “التاريخ من الأسفل”، وهو منظور يتغيا الوقوف في وجه نخبوية التيارات الإسطوغرافية، ويحاول رد الاعتبار وإرجاع الصوت للمغيبين باعتبارهم عنصرا فاعلا في التاريخ[18]، ويعتبر أن قراءة التاريخ من المركز يفرز تاريخا مبتورا يقصي تاريخ الفئات الصامتة[19]. من هذا المنطلق كتب بن عرفة مسارات رجال ونساء من العالم الإسلامي عاشوا المنعطف التاريخي الذي يوافق نهاية القرن الخامس عشر، أشخاص على الرغم من تموضعهم في قاع الهرم الاجتماعي الإسباني، أبانوا عن الجرأة على رفض النظام السائد والقدرة على العصيان، والرغبة في تغيير الوضع القائم، فبرزوا وأثروا في مجرى الأمور[20]. ليشكل أمام أعين القارئ ملامح تاريخ مقموع ومهمش، ويفتح مساحات غائبة مغلقة من حياة عرب مهزومين صاروا أقلية عرقية وثقافية بعد أن دفع بهم إلى قاع السلم الاقتصادي والاجتماعي[21].
-التاريخ المجهري Microstoria La: إذا كانت الكتابات التاريخية تهتم بالموريسكيين باعتبارهم مجموعة بشرية تعرضت لمأساة، انطلاقا من تنبهها للبعد الجمعي في التجربة التاريخية، فإن بن عرفة، في دراسته لهذه الكتلة البشرية، عمل على تغيير سلم الملاحظة، حيث عمل على التفكير في الأقدار الفردية لهذه الفئة الاجتماعية، عن طريق اقتراحه الفرد موضوعا رئيسيا للبحث في التاريخ الاجتماعي، باعتبار أن التجارب الفردية هي التي تمكن في النهاية من تشكيل الأنماط الاجتماعية التي يمكن للمؤرخ ملاحظتها ودراستها[22]. وقد قام بن عرفة بذلك من خلال تركيزه على أقدار ومسارات فردية لشخصيات موريسكية متخيلة، عاصرت الفترة الممتدة ما بين تاريخ سقوط غرناطة وتاريخ صدور قرار الترحيل الأخير، وعبرت عن مسار أجيال من الموريسكيين، فقد جعل بن عرفة، انطلاقا من كل من شخصية الشيخ ابن معن وشخصية حفيده محمد معنينو، المؤشر الفردي خيطا ناظما لإعادة بناء العلائق والمسارات في تعقدها الهائل، وتمكن من إبراز مساهمة الفرد الواحد في التاريخ العام وفي تشكيل وتغيير البنيات الحاملة للواقع الاجتماعي[23].
- التخييل التاريخي في رواية الحواميم
إذا كان المؤرخ يبحث عن الوقائع ويصل إليها عن طريق الملاحظة الدقيقة وتحليل النصوص التاريخية، فإن الكتابة الأدبية تقوم على التخييل باعتباره مفتاحا لدخول عالم الوقائع، فالتخييل التاريخي في رواية الحواميم، يعيد بناء وصياغة الحدث التاريخي المتمثل في سقوط غرناطة ومأساة الموريسكيين، ويقوم بتسريده ضمن نص تعاقبي تحكمه حبكة روائية متصلة تدخل في نسيج حياة متخيلة لشخصيات الرواية (الشيخ ابن معن، الحفيد محمد معنينو، الراهب الكالفيني كاسيودورو دولارينا، الأديب ميكيل دي ثيربانتس، الزوجان مصطفى وحليمة، والطفلة حياة…)، عن طريق القيام بضفر خيط متخيل بخيوط تاريخية أو على العكس إدخال خيط تاريخي دقيق في نسيج متخيل يذوب فيه تماما، أو التقاط معلومة وردت في دراسة تاريخية ليتم تحويلها إلى مشهد مفصل. فأحيانا تكون الواقعة التاريخية هي النواة التي ينسج من حولها تفاصيل المشهد، وفي أحيان أخرى على غير ذلك ينشئ مشهدا متخيلا يستمد تفاصيله من التاريخ الموثق[24]، فيكون المتخيل بابا يفتحه الروائي على الواقعة التاريخية، بحيث يشكل الدلالة ويفي بحاجة وضرورات النص العرفاني، ليس باعتباره تجربة ماضية تمت وانقطعت، بل دائمة التدفق وفق مقولة الشهادة بالحضور سالفة الذكر[25].
وهكذا يتنزل التخيل التاريخي في منطقة التخوم الواقعة بين التاريخي والخيالي، فينشأ في منطقة حرة انصهرت مكوناتها بعضها ببعض، وكونت تشكيلا جديدا متنوع العناصر نقل الكتابة السردية من موقع جرى تقييد حدوده النوعية إلى تخوم رحبة للكتابة المفتوحة على الماضي والحاضر[26].
- صراع الحياة والموت في رواية الحواميم
تتكون رواية “الحواميم” من سبعة فصول، افتتحت جميعها بحرفي الحاء والميم سواء في صيغة حرفين مقطعين حم أو بصيغة فعل حم، وختمت بالآية الأخيرة أو بجزء من الآية الأخيرة في السورة القرآنية المقابلة لكل فصل حسب ترتيبها في المصحف[27].
تدور أحداث هذه الرواية في مجال جغرافي يشمل مدينة غرناطة وعددا من المدن المغربية التي كانت وجهة للهجرات الموريسكية مثل سلا وفاس ومراكش، كما يدور جزء مهم من الأحداث في عرض البحر الأبيض المتوسط والسواحل المغربية من المحيط الأطلسي. مثلت مدينة غرناطة الفضاء الأساس في الرواية، فهي المدينة الأندلسية التي استطاعت الصمود في وجه حروب الاسترداد ما يربو عن قرنين ونصف من الزمن، وتحيل قدرتها على المقاومة على صراع الحاء مع الميم. هذا الصراع الذي انتقل إلى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وبالضبط مدينة سلا، المدينة التي لجأ إليها المهاجرون والمهجرون الموريسكيون، والمرسى التي تنطلق منها السفن الجهادية لإنقاذ بقايا الموريسكيين العالقين بإسبانيا، أو في محاولة استعادة المدينة أو الهجوم على السواحل الإسبانية أو التعرض لسفنها المحملة بثروات العالم الجديد.
تجسد شخصيات الرواية أيضا ثنائية الحياة والموت، وذلك انطلاقا من أسمائها التي تبتدئ بحرفي الحاء والميم، الشيخ ابن معن، الشخصية المحورية في الجزء المتعلق بمدينة غرناطة من الرواية، ثم حفيده محمد أو مرينو، وهو الاسم الذي أطلقه عليه المعمدون بإسبانيا، والذي حرف إلى معنينو بعد أن انتقل للعيش بمدينة سلا، ثم مصطفى وزوجته حليمة، المورسكيان والدا الطفلة التي حملت اسم حنا عندما تكفلت بها أسرة قشتالية، والتي لم تلبث أن استعادت اسمها العربي حياة بعد أن تمكنت من الوصول إلى مدينة سلا أيضا.
تطرق المؤلف في روايته إلى مجموع مراحل الصراع بين الموريسكيين والإسبان الذي دام أكثر من قرن، وهو صراع الحياة والموت الحاضر في كل جزء من أجزاء الرواية، ناقش من خلاله المؤلف مجموعة من القضايا الراهنة التي تمثل أسئلة وهواجس الحاضر انطلاقا من قراءة الماضي[28]، سؤال الانكسارات والنهايات سؤال الهوية والعلاقة بالآخر، سؤال التهميش وقمع الحريات والحق في الاختلاف.
يمكن تقسيم هذا الصراع إلى ثلاثة أقسام أو مراحل كبرى مرتبطة بالمكان الذي وقعت فيه الأحداث وهي مرحلة غرناطة، ومرحلة عرض البحر الأبيض المتوسط، ثم مرحلة المغرب.
– المرحلة الأولى، مرحلة غرناطة، تمثل الصدمة الأولى التي تعرض لها الغرناطيون، وبداية مأساتهم، وأولى مظاهر شتاتهم وتشردهم عقب تسليم مفاتيح مدينتهم للملكين إيزابيللا القشتالية وفرناندو الأركوني، كما تعكس بداية الصراع بين الحياة والموت وكيفية تمثل الموريسكيين لهذا الصراع بعد أن تم تجميعهم في ربض البيازين، وذلك انطلاقا من الاختيارات التي تبنوها، فمنهم من تمثل الحياة في اختيار الرحيل عن مدينة غرناطة واللجوء إلى بلد من بلدان العالم الإسلامي، خاصة الحواضر المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. ومنهم من تمثل الحياة في البقاء في غرناطة ومواصلة المواجهة مع الإسبان.
يصور بن عرفة وقع الحدث على حياة هذه الفئة الاجتماعية انطلاقا من نموذج أسرة الشيخ ابن معن، فالشيخ ابن معن فقيه من عائلة غرناطية مرموقة، تشردت وانهار تماسكها الموروث بتسليم المدينة للإسبان. فهذه الأسرة في إطار صراعها مع الموت وتمسكها بالحياة انقسمت إلى قسمين، قسم قرر الرحيل إلى مدينة فاس في محاولة للحفاظ على دينه وماله. وقسم قرر البقاء ومواصلة الجهاد في سبيل إحياء الدين الإسلامي في غرناطة. مثل القسم الذي اختار البقاء من العائلة أحد أبناء الشيخ ابن معن الذي انضم إلى الثوار في الجبال إلى أن استشهد في إحدى ثورات الموريسكيين، والشيخ ابن معن نفسه الذي عمل على مواصلة الجهاد عن طريق تعبئة الموريسكيين، والمشاركة في المناظرات الدينية التي تدافع عن الدين الإسلامي وتدعو إلى التشبت به. صور بن عرفة هذا الدور عندما أشرك الشيخ ابن معن في مناظرات متخيلة مع شخصية تاريخية حقيقية وهي شخصية الكاهن الكاردينال خمينس دي ثيسنيروس الذي عهدت له الملكة ايزابيللا بمهمة اقناع الغرناطيين بالتنصر[29]. مثلت هذه المناظرات صراعا بين الحياة والموت، هذا الصراع الذي أسفر عن فشل الكاهن في إقناع مسلمي غرناطة باعتناق الدين المسيحي طواعية، لكن ردة فعل الكاردينال كانت قاسية حين أقدم على إحراق الكتب العربية. حادث إحراق الكتب في ساحة المدينة الذي استمر أياما، والذي شكل آخر مشهد من الفصل الأول من الرواية، يعكس عزم الإسبان على طمس الثقافة والحضارة العربية الإسلامية بالأندلس، ويمثل موتا رمزيا تعرض له مسلمو إسبانيا عن طريق القضاء على إرثهم الثقافي العربي الأندلسي.
يصور المؤلف في هذه المرحلة أيضا مظاهر متعددة للصراع بين الحياة والموت، خاصة بعد أن تنكر الملكان الإسبانيان للعهود والمواثيق التي ضمنوها للموريسكيين، وتحول التضييق الذي نهجاه إلى سياسة مستمرة تهدف التطهير الديني، الأمر الذي أسفر عن أزمة هوية دينية وثقافية تعرض لها سكان غرناطة، خاصة بعد إصدار مرسوم يقضي بتنصيرهم، ومنع تداول اللغة العربية وإقامة الشعائر الدينية الإسلامية. تمثلت مظاهر هذه الأزمة في الازدواجية الدينية التي أصبح الموريسكيون يعيشونها. هذه الازدواجية حولت الدين الإسلامي إلى دين سري تختلط فيه الشعائر الدينية بالتقاليد والخرافة مما هدد بموت الإسلام في إسبانيا. يبدو الشيخ بن معن في خضم هذه الأحداث متمسكا بإحياء الدين الإسلامي بغرناطة، فقد جعل بن عرفة منه عضوا في مجلس أهل الحل والعقد، وهو مجلس يضم فقهاء الموريسكيين وعلماءهم الذين أسندت لهم مهمة التفاوض مع القشتاليين من أجل ضمان حقوق الموريسكيين من جهة، والعمل على مساعدتهم على الحفاظ على دينهم عن طريق عقد اجتماعات سرية لأعضاء هذا المجلس، تتخللها جلسات وعظ تحثهم على التمسك والمواظبة على إقامة شعائر الدين الإسلامي وتلاوة القرآن، وتلقين الأطفال اللغة العربية وأصول الدين الإسلامي، والتشديد على الالتزام بأداء الشعائر الإسلامية في الخفاء موازاة مع أداء الشعائر المسيحية في العلن.
إلى جانب قيام الشيخ ابن معن بواجبه الديني تجاه أبناء أمته، كان منشغلا بتكوين من يخلفه في مهمته الجهادية، فكان يسهر على الاهتمام بتربية حفيده محمد الذي أطلق عليه المعمدون اسم مرينو، فكان حريصا على تلقينه اللغة العربية ومبادئ الدين الإسلامي وتحفيظه القران. إلا أن رغبته اصطدمت بقرار نزع أطفال الموريسكيين من أسرهم وتسليمهم إلى أسر إسبانية لتسهر على تربيتهم تربية مسيحية، وكان حظ الطفل أن يرسل للخدمة في الكنيسة. أمام هذا القرار، أدرك الشيخ أن الحل النهائي لحفاظ هذا الطفل على دينه هو تدبير عملية فرار واللحاق بابنه الذي سبقه إلى مدينة فاس، لكن قوة الشيخ لم تسعفه، فاكتفى بإرسال الطفل إلى مدينة سلا، بعد ان أوصى القرصان الذي قام بتهريبه بالسهر على تربيته وتعليمه. بينما تم القبض على الشيخ ليمثل بين أيدي محققي ديوان التفتيش.
شكل حدث ترحيل الطفل محمد مرينو، وفشل الشيخ ابن معن في الفرار، إلى تحول في طبيعة الصراع بين الحياة والموت في مدينة غرناطة، فقد مثل نجاح عملية فرار الطفل استمرارا للحياة، فبوصوله إلى مدينة سلا يكون قد تخلص من مراقبة محاكم التفتيش وإجبارية العمل في الكنيسة وضمن حرية ممارسة شعائره الدينية التي يكفلها له استقراره في بلد إسلامي. كما شكل فشل محاولة فرار الشيخ ابن معن، بالرغم مما يوحي به الحدث من إمكانية موته، بداية لمرحلة جديدة من مراحل الصراع بين الحياة والموت والتي خاضها الشيخ هذه المرة من داخل غياهب السجن.
تعج أرشيفات محاكم التفتيش بملفات محاكمات الموريسكيين، لكن مهما كانت دقة المعلومات الواردة في هذه الوثائق، فهي تبقى غير قادرة على تصوير البعد النفسي للمتهم، الأمر الذي تمكن بن عرفة من نقله، عندما صور شخصية ابن معن السجين، المتقدم في السن، الثابت على مبادئه ومواقفه، الذي قرر أن لا ينكر دينه أمام المحققين، ورفض ترديد الصلوات المسيحية كي يحظى بالعفو أو ينفي التهم الموجهة إليه، بل بالعكس واظب طيلة مدة سجنه على أداء صلواته، وممارسة شعائره الدينية الإسلامية دون خوف من حراس السجن ولا من السجناء، ودارت بينه وبين المحققين سجالات دينية دافع فيها باستماتة عن الدين الإسلامي، وتمكن عن طريق ربط علاقات مع مجموعة من السجناء إلى تحويل السجن من فضاء مغلق إلى فضاء منفتح على الحوار وتقبل الاختلاف بين سجناء مسلمين ويهود ومسيحيين بروتستانتيين. مثل الانسجام بين مختلف العناصر المكونة للسجناء انتصارا للحياة. في المقابل، مثلت ممارسات ديوان التفتيش أقصى درجات التطرف ضد كل من يخالف المعتقد الكاثوليكي، خاصة موقفها من المناخ الثقافي والديني السائد بأوروبا خلال عصر النهضة والذي مثلت حركة الإصلاح الديني أبرز مظاهره، وما كان يتعرض له متبعو المذهب البروتستانتي من تعذيب، والذي أبرزه المؤلف انطلاقا من شخصية الراهب الكالفيني السجين الذي تعرض لأبشع أنواع التعذيب. كما مثلت مرافقة الشيخ ابن معن المسلم لراهب بروتستانتي في الزنزانة تجربة ذات أبعاد كونية، مكنت ابن معن من الانفتاح على تعاليم الدين المسيحي وفهمها على حقيقتها، وتجاوز ضيق أفق تأويلات رجال الدين، وفهم كنه أفكار الإنسيين التي تصهر الديانات كلها في بوتقة التسامح.
كانت نهاية الشيخ ابن معن مؤلمة، فبعد إخضاعه لحصص تعذيب تفننت محاكم التفتيش في ابتداع أدواتها، أعدم شنقا، ثم أحرقت جثته، كانت هذه هي النهاية التي ارتضاها لنفسه ورأى فيها استمرارا لحياته. لكن حدث إعدامه لم يشكل نهاية الصراع بين الحياة والموت، بل تواصل هذا الصراع واستمر علي يد حفيده محمد معنينو.
-المرحلة الثانية، مرحلة عرض البحر، تدور أحداث هذه المرحلة من الرواية في عرض البحر الأبيض المتوسط، باعتبار أن هذا المجال الجغرافي يشكل المعبر بين إسبانيا بلد الموت والمغرب بلد الحياة وفضاء للصراع بينهما. يمثل محمد معنينو، حفيد الشيخ ابن معن، الشخصية الرئيسية في هذا الجزء من الرواية، هو الطفل الذي أصبح شابا متعلما ومتنورا، والذي اختار الاشتغال في نشاط القرصنة. يشير المؤلف من خلال مزاولة الشاب محمد معنينو لنشاط القرصنة إلى استمرار الصراع بين الحياة والموت انطلاقا من البحر، فقد عرف هذا النشاط دفعة قوية بعد توقف المواجهات العسكرية الضخمة بين البلدان المطلة على ضفتيه، خاصة بعد هزيمة العثمانيين في معركة ليبانطو سنة 1571، وهزيمة الحلف المسيحي في معركة حلق الوادي سنة 1574، وانتصار المغرب على البرتغال في معركة وادي المخازن سنة 1578[30]، وما رافق ذلك من تحول الصراع الإسلامي المسيحي بالبحر الأبيض المتوسط إلى حرب قرصنية هدفها استنزاف القوة الاقتصادية والبشرية للكيانات المتصارعة، تزعمها من الجانب الإسلامي كل من القراصنة الجزائريين في الولايات العثمانية بشمال إفريقيا[31]، وقادها في المغرب الأندلسيون والموريسكيون بعد استقرارهم في المدن الساحلية المغربية خاصة تطوان وسلا[32]. نقل الأديب بن عرفة أطوار هذا الصراع في الرواية عندما وضع الشاب محمد معنينو في صلبه، بحيث جعل منه قرصانا مجاهدا دخل في مواجهات حربية مع الإسبان، وواجه مختلف الأخطار المترتبة عن نشاط القرصنة بما في ذلك خطر الوقوع في الأسر، فقد تعرض هذا الشاب لمحنة الأسر أثناء قيامه بإحدى الحملات القرصنية على السواحل الإسبانية لإنقاذ الموريسكيين، وتم اقتياده للعمل في سفن التجديف الإسبانية، ولم يتمكن من استعادة حريته إلا في إطار صفقة مبادلة ببعض الأسرى الإسبان الموجودين في سلا. لكنه، وبالرغم من الأخطار المحدقة بالنشاط الذي يزاوله، واصل مهمته الجهادية بتعاون مع القراصنة الجزائريين من أجل إنقاذ الموريسكيين ومساعدتهم على الوصول إلى الأراضي الإسلامية. كتب بن عرفة هذه الصفحة من تاريخ البحر الأبيض المتوسط عندما أعاد صياغة أحداث حملة قرصنية جزائرية وقع ضحيتها الأديب الإسباني ميكيل دي ثربانتس، وسبق لهذا الأديب أن سجلها في روايته “الدون كيخوته دي لامانشا”[33]، أقدم من خلالها القرصان الجزائري أرنؤوط مامي على الاستيلاء على سفينة إل صول الإيطالية التي كانت تقل الأديب على متنها، وقضى على إثرها ثيربانتس خمس سنوات أسيرا في الجزائر[34]. أعاد بن عرفة صياغة أطوار المعركة بين السفن القرصانية الجزائرية، وطعمها بمبارزة متخيلة دارت بين محمد معنينو وثرباتس، كان النصر فيها حليف معنينو، منطلقا من معطى تاريخي متمثل في تعاون القراصنة السلاويين مع نظرائهم الجزائريين[35]، مما أسفر على الاستيلاء على المركب الإيطالي وأسر ركابه وطاقمه وتحرير الأسرى المسلمين الذين كانوا على متنه. كان من بين الأسرى الموجودين على ظهر تلك السفينة صبية موريسكية تدعى حياة، تم أسرها أثناء محاولتها الوصول إلى المغرب للبحث عن ذويها بعد أن علمت أن الاسبان انتزعوها، وهي لا تزال طفلة، من حضن عائلتها وسلموها لأسرة قشتالية كي تسهر على تربيتها، كانت هذه الصبية غنيمة من نصيب ثربانتس الذي قام بتقييدها مخافة هربها. لكن بعد وقوع سفينة إل صول بين أيدي القراصنة المغاربيين، أهداها رايس السفينة لمعنينو الذي منحها حريتها وخيرها بين مواصلة البحث عن أهلها أو مرافقته.
كان لقاء هذه الشخصيات في البحر، لقاء لأشخاص يطوفون العالم بحثا عن فكرة ودفاعا عن قضية. فمغامرة الفتاة حياة، التي أصبحت زوجة محمد معنينو فيما بعد، واللقاء الذي تم بينهما في عرض البحر بعد أن تم طردهما من الأرض، يمثل استمرارا للصراع مع الموت، ومواصلة للبحث عن حياة في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وإعتاق معنينو لها يحيل على قيمة وجودية هي قيمة الحرية. كما أن الأحاديث التي دارت بين معنينو وثربانتس والمواضيع التي تمت مناقشتها، كانت تعبيرا عن ثقافة كل طرف وانعكاسا لموقفه من الصراع الإسلامي المسيحي خلال القرن السادس عشر. فعلى الرغم من كون اللقاء بينهما تم في إطار الصراع الإسلامي المسيحي، إلا أن كل شخصية من الشخصيتين عبرت عن القيم التي تدافع عنها باعتبارها قيما إنسانية تتجاوز حدود الفهم الضيق للإنسان العادي. فخلال هذه الأحاديث أفصح ثربانتس عن أبعاد التجربة العسكرية التي خاضها ضمن قوات الحلف المسيحي، والدوافع النفسية لانخراطه في هذه الحروب التي اعتبرها حربا عادلة من وجهة نظر شخص حالم بعالم البطولات، شارك في الحرب من أجل إحياء القيم الأخلاقية التي فقدتها إسبانيا وأوروبا، وعبر صراحة عن موقفه من دور إسبانيا في تأجيج الصراع الإسلامي المسيحي النابع من تخوف المسيحية الكاثوليكية، التي لم يتعد مجال انتشارها أوروبا، من الإسلام المنتشر في ثلاث قارات. كانت هذه الدوافع هي نفس دوافع الجهاد بالنسبة لمعنينو، الذي يعتبر نشاط القرصنة جهادا في سبيل الله، واسترجاعا لحقوق مهضومة، وتعبيرا عن مقاومة من أجل الذاكرة الإنسانية التي جعلت التعايش بين مختلف الناس ممكنا بل ضروريا.
-المرحلة الثالثة، مرحلة المغرب.تدور أحداث هذه المرحلة من الرواية في المغرب، أرض اللجوء، الأرض التي منحت فرص حياة جديدة لأشخاص آمنوا بالحق في الاختلاف وحرية المعتقد، أرض احتضنت محمد معنينو وحياة، الشابان الموريسكيان الطريدان، كما احتضنت عبد الله الجنوي العلج، الإيطالي الذي استفزه قصور فكر وتأويلات رجال الدين المسيحيين، فاختار إعمال عقله واعتناق الدين الإسلامي، احتضنت اليهودية الأندلسية التي تعرضت لاضطهاد الكاثوليك الإسبان، فرحلت إلى هذا البلد وتزوجت من العلج عبد الله الجنوي وأنجبت الفقيه رضوان الجنوي…
ترتبط هذه المرحلة باستقرار كل من محمد معنينو وحياة في مدينة سلا. تسير حياة هذين الزوجين سيرا هادئا بعد أن احتضنهما بلد إسلامي وتمكنا من تكوين أسرة، لكن الصراع بين الحياة والموت يظل قائما، فمحمد معنينو كان قد سطر هدفه في الحياة منذ وصوله إلى هذه المدينة وهو لا يزال في سن مبكرة، والذي تمثل في إنقاذ الموريسكيين والبحث عن فرع عائلته الذي سبقه إلى مدينة فاس. أما حياة فكان هاجس البحث عن والديها يلازمها دائما، وفي رحلة بحثهما هاته تنتصر الحياة.
ففي إطار البحث عن فرع عائلة ابن معن المستقر بفاس، كان محمد معنينو يزور باستمرار تلك المدينة، خاصة خلال الفصول التي يتوقف فيها نشاط القرصنة، وكان دائم التردد على جامع القرويين، ومواظبا على حضور مجالس العلم التي تعقد بها، وأثناء إحدى زياراته لهذه المدينة التقى بأحد طلبة الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي وتوطدت العلاقة بينهما، وأثناء تجاذبها أطراف الحديث، علم منه أنه ينتمي إلى عائلة أندلسية، وأن جده ظل بغرناطة إلى أن أعدم على يد محكمة التفتيش، وبالتدقيق في الحديث أدرك أنه ابن عمه الذي هاجر إلى مدينة فاس. وبذلك اجتمع شمل أسرة آل معن.
أما فيما يتعلق برحلة البحث عن والدي حياة، فقد كان محمد معنينو بحكم مزاولته لنشاط القرصنة، على علم بكل العائلات الأندلسية التي تفد إلى المغرب، وكان يرسل لوائح بأسماء كل من حضر إلى المغرب منهم إلى مختلف المدن المغربية، وساهم عن طريق هذه العملية في جمع شمل عدد من العائلات الأندلسية التي توافدت على المغرب على مراحل، دون أن يتمكن من الوصول إلى عائلة زوجته، إلى أن صدر آخر قرار لطرد الموريسكيين سنة 1609، بعد اعتلاء فيليبو الثالث عرش إسبانيا، وبدأت عملية الترحيل النهائي لأهالي غرناطة. كان على المهجرين أداء رسوم التغريب التي حددت في مبلغ قدره عشر ريالات ذهبية لكل فرد، كي يتسنى نقله على ظهر سفن إسبانية وإيطالية استؤجرت لهذا الغرض. إلا أن عددا من الموريسكيين لم يكن بإمكانهم أداء ذلك المبلغ، فظلوا عالقين عند الشواطئ الإسبانية في انتظار قدوم القراصنة المغاربيين لإنقاذهم. كان من بين أولئك العالقين شيخ أخرس وزوجته العجوز، توقفا عند ساحل مدينة فلنسية ينتظران قدوم القراصنة المغاربيين، في تلك الأثناء كان أسطول محمد معنينو المكون من ستة سفن قد توجه نحو تلك السواحل لإنقاذ الموريسكيين، استعطفته المرأة العجوز لينقلها، هي وزوجها، إلى المغرب على متن أحد مراكبه. وعندما وصل الجميع استضافت مجموعة من العائلات السلاوية القادمين الجدد، توسلت المرأة معنينو للمرة الثانية ليستضيفها في منزله، حيث استقبلتها زوجته ومنحتها دارا مجاورة لمنزلها لتقيم فيها رفقة زوجها، كما رافقتها إلى الحمام، وهو المكان الذي يتوجه إليه الموريسكيون بمجرد وصولهم إلى بلد إسلامي، بما أنه كان مكانا محظورا في إسبانيا. أثار انتباه المرأة العجوز وشم على ذراع حياة، فسألتها عن بعض العلامات في جسدها، فلما أكدت لها وجود تلك العلامات، أدركت أن تلك المرأة التي تستضيفها في منزلها هي ابنتها التي انتزعت منها وهي لا تزال طفلة. كان لقاء بحجم الحلم، استعاد على إثره مصطفى، الشيخ الأخرس، القدرة على النطق، بعد أن كان انتزاع ابنته منه هو سبب إصابته بالخرس.
خاتمة
تمثل رواية الحواميم تجربة أدبية خصبة، متعددة المداخل، تمزج بين التأمل العرفاني والتوثيق التاريخي، عالج من خلالها المؤلف موضوع سقوط الأندلس بشكل مختلف عن الأسلوب التي تعودت العديد من الأدبيات، التي تناولت هذه المرحلة التاريخية بالدراسة، أن تقدمها على شكل مرثيات ترثي حقبة من التاريخ العربي المجيد وتتباكى على الفردوس المفقود، بل عمل على إعادة كتابة مرحلة من مراحل التاريخ العربي، بصرامة المؤرخ الذي لا يستسيغ العبث بتاريخ أمة، ومكن من التعرف على حدودها ومفاصلها الزمنية والمكانية، وملامح وإيقاعات الحياة اليومية للجماعة الموريسكية، وصور، من خلال حضور كامل، ملامح من التاريخ الثقافي والحضاري العربي والإسلامي، وأنتج مادة سردية تخييلية مطابقة للمصادر التاريخية التي وظفها من أجل إنجاز نصه الأدبي، إلى حد التماهي.
—————————————————–
[1] عبد الله إبراهيم، التخييل التاريخي، السرد والإمبراطورية، والتجربة الاستعمارية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة 1، بيروت، 2011، ص. 5.
[2] عبد الإله بن عرفة، الحواميم، المركز الثقافي العربي، الطبعة 1، الدار البيضاء/ بيروت، 2010، ص. 8.
[3] عبد اللطيف الوراري، “حوار مع رائد الرواية العرفانية للكاتب المغربي عبد الإله بن عرفة”، مجلة ذوات، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، المغرب، العدد 10، 2015، ص. 56.
[4] عبد الإله بن عرفة، م.س، ص. 4.
[5] عبد اللطيف الوراري، م. س، ص 56.
[6] سعيد الفلاق، التاريخ رواية ما كان، بينما الرواية هي تاريخ ما يمكن أن يكون، حوار مع الروائي عبد الإله بن عرفة، قيد النشر.
[7] أحمد بابانا العلوي، “الكتابة النورانية في الأدب العرفاني: قراءة في فلسفة الرواية العرفانية”، جريدة عالم الثقافة https://www.woldofculture2020.com 27/08/2020.
[8] إبراهيم الحجري، “الرواية العرفانية : مدخل لمعرفة قضايا النوع”، مجلة ذوات، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، المغرب، العدد 10، 2015، ص 17.
[9] رشا أحمد، “الرواية العربية من أقنعة التراث إلى شرفات التاريخ، دراسة تطبيقية للباحثة د. هويدا صالح”، مجلة الشرق الأوسط، 13/9/2023.
[10] عبد اللطيف الوراري، م. س، ص. 59.
[11] دباح جمال، فاتح علاق، ” الرواية العرفانية عند عبد الإله بن عرفة، مشروعية الوجود”، مجلة إشكالات في اللغة والأدب، الجزائر، 2020، عدد 3، ص. 70.
[12] عبد اللطيف الوراري، م. س، ص. 59.
[13] بن عرفة، م. س، ص. 14.
[14] محمد التهامي الحراق، ” الحواميم لعبد الإله بن عرفة بين الإبداعي والتاريخي”، جريدة المساء، 13/11/2013، ص. 18.
[15] دباح جمال، فاتح علاق، م. س، ص. 65.
[16] باتريك بوشرون (إشراف)، بيير موني، جوليان لوازو، يان بوتان ( تنسيق)، تاريخ العالم في القرن الخامس عشر، مراجعة وتنسيق الترجمة لطفي بوشنتوف، مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود، الدار البيضاء، 2022، ص. 11.
[17] باتريك بوشرون، م. س، ص. 19.
[18] محمد حبيدة، المدارس التاريخية برلين -السربون- استراسبورغ، من المنهج إلى التناهج، دار الأمان، الرباط، 2018، ص 195.
[19] إبراهيم القادري بوتشيش، “من التاريخ السلطاني إلى تاريخ المهمشين: نظرات في تجديد الأدوات المنهجية للمؤرخ”، ضمن، دراسات الجالات الاجتماعية المهمشة وتاريخ المغرب، تنسيق عبد الرحمان المودن، محمد ياسر الهلالي، خليل السعداني، محمد جادور، منشورات مختبر المغرب والعوالم الغربية، كلية الآداب بنمسيك، 2011، ص 51.
[20] محمد حبيدة، كتابة التاريخ، قراءات وتأويلات، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، 2022، ص 181.
[21] رضوى عاشور، ثلاثية غرناطة، دار الشروق، القاهرة، 2014، ص 510.
[22] Sabina Loriga, “La biographie comme problème”, in, jeux d’echelles : la micro -analyse à l’expérience, Jacques Revel, (Dir), Gallimard/ Seuil, 1996, p.210.
[23] محمد حبيدة، المدارس…، م. س، ص 194.
[24] رضوى عاشور، م. س، ص. 511.
[25] دباح جمال، فاتح علاق، م. س، ص. 70.
[26] عبد الله إبراهيم، م. س، ص. 5.
[27] محمد التهامي الحراق، م. س، ص. 18.
[28] رضوى عاشور، م. س، ص. 510.
[29] Guy Testas et Jean Testas, L’inquisition, « Que sais-je ? », Presses Universitaires de France, Paris, 1966, P. 83.
[30] محمد القبلي، (إشراف وتقديم)، تاريخ المغرب تحيين وتركيب، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، منشورات عكاظ، الرباط، 2012، ص. 380.
[31] محمد أمين، ” القرصنة وشروط افتداء الأسرى الإسبان بالجزائر في القرن الثامن عشر” ضمن، دراسات في تاريخ الجزائر الحديث، أنفو برانت، فاس، 2011، ص. 68.
[32] Leila Maziane, Salé et ses corsaires (1666- 1727) Un port de course marocain au XVIIe siècle, publications des universités de Rouen et du Havre, presses universitaires de Caen, 2007, p 69-70.
[33] Ahmed Abi Ayyad, « Captifs et captivité dans les œuvres de M. de Cervantès, Alger au XVIème siècle », in, Sources documentaires étrangères, l’Algérie: Histoire et société-un autre regard- Etudes des archives et témoignages en Algérie à l’étranger, Ed. CRASC , 2005, p.19.
[34] Mika Ben Miled, Cervantès, soldat à Tunis, captif à Alger, avec la relation du siège de la Goulette par les espagnols, Ed. Cartaginoiseries, 2006, p. 16.
[35] حسن أميلي، الجهاد البحري بمصب أبي رقراق خلال القرن السابع عشر الميلادي، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، 2006، ص 62.
 رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه
رباط الكتب مجلة إلكترونية متخصصة في الكتاب وقضاياه